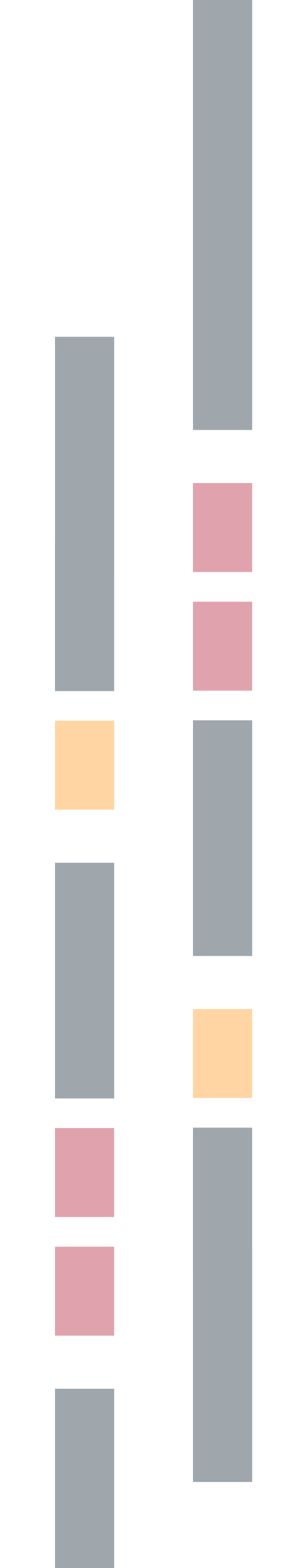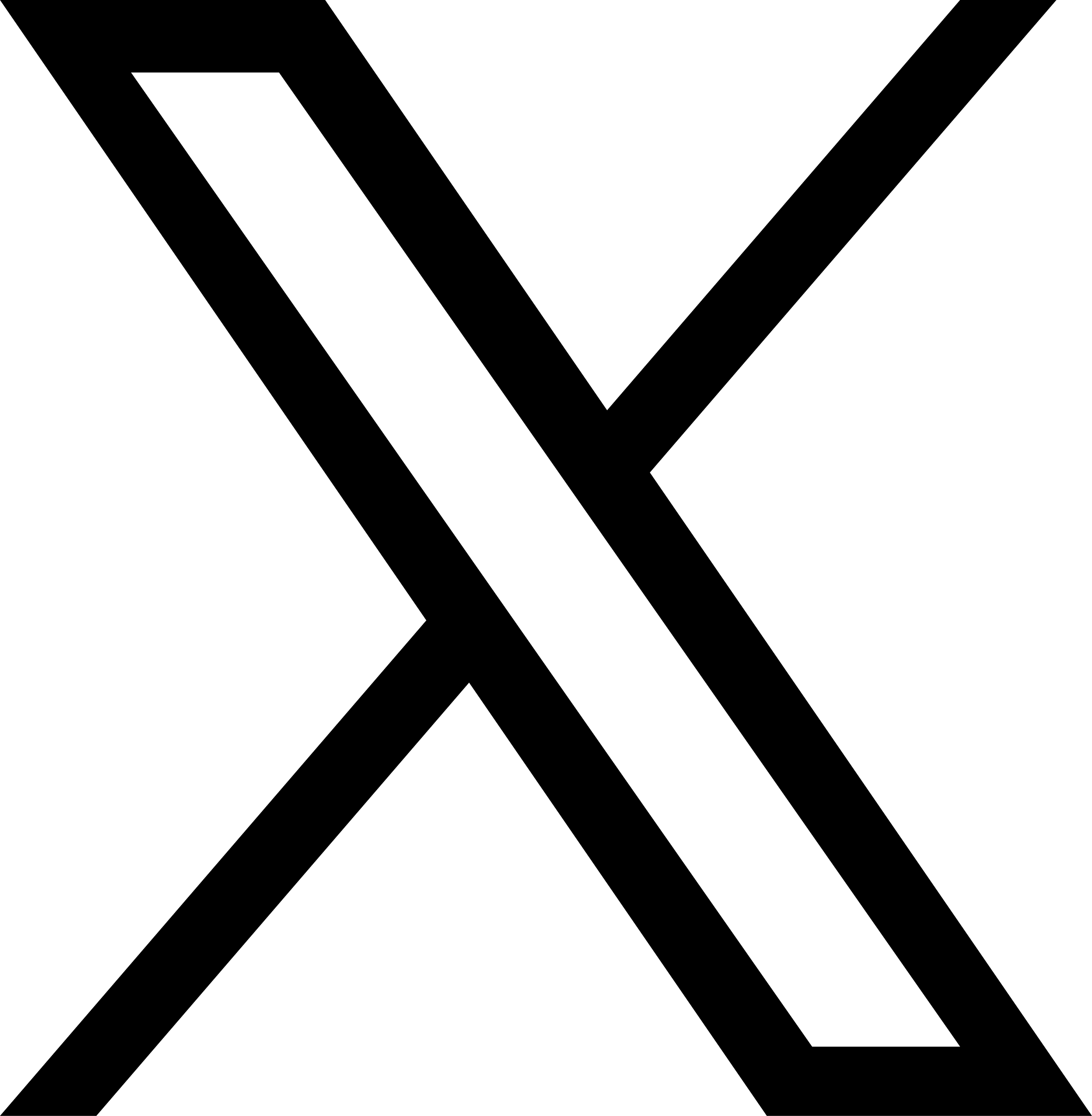شارك
يمثّل فيلم «العميل السري (2025)» للمخرج البرازيلي )كليبر مندونسا فيلهو( تجربة سينمائية تتجاوز إطار التجسس التقليدي، لتقدّم قراءة عميقة لفعل المحو، ليس فقط بوصفه تقنية سردية، بل ممارسة اجتماعية وسياسية وطريقة لفهم العلاقة بين الإنسان والتاريخ. فالتجسس هنا ليس في شخصيةٍ مختبئةٍ، بل في دولةٍ بأكملها تعيد تشكيل ذاكرتها عبر الإخفاء، ومجتمع يتعلّم النجاة من خلال الصمت. بهذا المعنى، يتحوّل الفيلم إلى مساحة بحث حول قدرة السينما على استعادة ما حاول التاريخ أن يمحوه، أو ما أرادت السلطة أن تخفيه.
تبدأ الحكاية بمشهد افتتاحي في مدينة ريسيفي عام (1977)، زمن سيطرة النظام العسكري في البرازيل. يظهر مارسيلو، الذي يجسّد دوره الممثل (فاغنر مورا(، كرجل تطارده ظروف غامضة، يسعى إلى إخفاء ماضيه، لكنه في الوقت نفسه يبحث عن الوثائق التي تثبّت وجود والدته الراحلة. هذه المفارقة بين الرغبة في الاختفاء والرغبة في إثبات الوجود تمثّل العمود الفقري للفيلم. فالناس هنا لا يخشون فقط الاعتقال أو الملاحقة، بل يخشون أيضًا أن يختفوا من الذاكرة، وأن يتحوّلوا إلى صفحات غير مكتوبة في تاريخ لم يُسمح لهم بكتابته.

وفي رسمه لمدينة ريسيفي، لا يتعامل الفيلم مع المكان كخلفية صامتة للأحداث، فالمكان يظهر كوثيقة سينمائية. الشوارع، والمباني القديمة، ودور السينما، تتحوّل جميعها إلى مادة تاريخية لا تقل أهمية عن الشخصيات. والمدينة نفسها تبدو وكأنها تحاول الاحتفاظ بذاكرتها المهددة بالاختفاء؛ بعض الأماكن ما تزال تقاوم الزمن، وأخرى لم يبق منها سوى الاسم أو الحكاية. هنا تصبح كاميرا مندونسا عينًا أرشيفية، تنظر إلى المدينة لا كفضاءٍ جغرافي، وإنما كذاكرة حيّة.
ومع أنّ الفيلم يُبنى على عنصري الإثارة والتشويق، إلا أنه يحافظ على مسافة نقدية واضحة تجاه موضوعه. ففي هذا العالم السياسي بامتياز، وشديد الاضطراب أيضًا، لا يعمل التجسس بوصفه لعبة مخابرات، بل باعتباره ممارسة يومية؛ فالسلطة تمارس الإخفاء في حق الكثيرين، والناس يسعون إلى النجاة من أفاعيل السلطة. لكن القوة تكون قادرة دائمًا على إلغاء الوثائق أو خلقها عند الحاجة، وكأن الحقيقة لم تعد مرتبطة بالواقع، بقدر ما أصبحت مرتبطة بما يمكن إثباته أو نفيه.
ولعلّ أكثر ما ينجح فيه مندونسا هو تحويل هذه القضايا إلى بناء سينمائي يحافظ على توازنه بين النقد والتأمل. فبدلاً من أن يقول إن استعادة الماضي صعبة للغاية، يصنع فيلمًا يحاول استعادة هذا الماضي بالفعل، ويضع المشاهد أمام سؤال: هل يمكن إعادة كتابة ما مُحي تمامًا؟ وهل تستطيع السينما أن تكون بديلًا عن التاريخ الرسمي؟
وهنا يظهر مسار سردي آخر يعتمد على ما يشبه التقرير التاريخي؛ فالأحداث لا تتقدّم عبر الحبكة وحدها، إلى جانب أنها ترتبط بسياق يذكّر باستعادة أرشيفية. وكأن الفيلم يقول إن الحقيقة لا تروى في جملة واحدة، بل تحتاج إلى قراءة طويلة، مثل تقرير يحاول فهم ما حدث، أو يحاول ـــ على الأقل ـــ أن يستعيد ما تبقى من أثره.
وفي قلب هذا البناء السردي تظهر شخصيات جانبية ذات طابع إنساني وفكاهي لطيف، تضيف إلى الفيلم بعدًا واقعيًا يُذكِّر بأن الحياة يجب أن تستمر حتى في أشد لحظات التاريخ قتامة. وهذه الشخصيات ليست تزيينًا للحكاية، على العكس، بل هي جزء أصيل من الذاكرة نفسها؛ فالجسد الاجتماعي لا يُعرَفُ من خلال السياسي فقط، بل يتشكَّل أيضًا من خلال التفاصيل اليومية والاجتماعية الصغيرة.

وحين يصل الفيلم إلى مرحلة أكثر عمقًا في طرح سؤال الهوية، تظهر الموسيقى كعنصر جوهري في بنائه؛ فمندونسا لا يكتفي بإعادة تمثيل التاريخ بالصورة، في المقابل يستدعيه بالصوت عبر موسيقى شعبية من الشمال الشرقي البرازيلي، تمتزج مع طليعية موسيقية تعود إلى السبعينيات. وهنا تأتي محاولة لطمس الحدود بين المحلي والعالمي؛ فالفيلم، رغم جذوره البرازيلية، يحمل روحًا متصلة بالحركة السينمائية العالمية في تلك الحقبة، من خلال تلميحات لأسلوب بريان دي بالما، وفرانسيس فورد كوبولا، لا كاقتباس مباشر، إنما كتجاور بين الأسلوب والتجربة الفنية.
هذا الامتزاج الموسيقي لا يأتي كخيار جمالي فقط، بل يظهر كجزءٍ من فكرة الذاكرة المتعددة، التي يعتمد عليها الفيلم. فالصوت هنا ليس مجرد خلفية للفيلم، بقدر ما يتحوّل إلى سجل تاريخي. بعض هذه المقطوعات - بحسب قول المخرج - لم يكن مخططًا لها منذ البداية ومع ذلك أصبحت جزءًا لا ينفصل عن روح الفيلم. ثم يضيف: «إن وجود هذه الموسيقى كان أشبه بالمصادفة الضرورية». المصادفة التي تكشف أن بعض الاختيارات الفنية تأتي أحيانًا من التاريخ نفسه، لا من صانع الفيلم وحده.
وفي سياق أوسع، يمكن قراءة «العميل السري» ضمن سلسلة تجارب تعاملت مع الذاكرة بوصفها سؤالًا جوهريًا؛ فهو يلتقي مع سينما أندري تاركوفسكي من ناحية تحويل الذاكرة إلى كائن حي يتجاوز الماضي، ومع أعمال بيلا تار التي يُمحى فيها الزمن ببطء، ومع سينما عباس كيارستمي التي تجعل المكان وثيقة بصرية تقاوم النسيان. وفوق ذلك يندرج ضمن تقاليد سينما أمريكا اللاتينية التي واجهت الديكتاتوريات عبر الكاميرا نفسها؛ كما فعل فرناندو سولاناس، حين تتحوَّل أفلامه إلى مقاومة للأرشفة الرسمية، وإحياء لما حُجِبَ من التاريخ. وبذلك يصبح «العميل السري» جزءًا من عائلة سينمائية تبحث عمّا لم يُكتب من حكايات، وتحاول استعادة ما سقط من الذاكرة العامة.
وبين كل هذا، تتضح نقطة محورية: هي أن الفيلم ليس مجرد رواية سياسية، بل هو في جوهره بحث إنساني في معنى الوجود داخل بلد يتعامل مع تاريخه عبر المحو. مارسيلو لا يريد أن يهرب من السلطة فقط، وإنما يسعى إلى أن يترك خلفه أثرًا يثبت أنه كان موجودًا بالفعل، فكل خطوة في الفيلم، هي محاولة للنجاة من التحوّل إلى رقم أو إلى اسم غير مُسجَّل في أي وثيقة. تزداد المفارقة قوة حين نكتشف أن مارسيلو كان معلِّمًا قبل أن يصبح هدفًا للسلطة؛ وكأن الفيلم يحاول أن يذكِّرنا بأن المعرفة دائمًا ما تكون هي الخصم الأول للسلطة، وأن التفكير شكلٌ من أشكال المقاومة.

ومع أن الفيلم يمتد طويلًا من الناحية الزمنية، إلا أن طوله ليس ترفًا سرديًا، بل جزءًا من تجربة أراد لها المخرج أن تكون شبيهة بعملية بحث تاريخي؛ فالزمن يحتاج إلى إعادة بناء، والصور تحتاج إلى تثبيت، والمشاهد تبدو وكأنها تريد أن تبقى أطول قليلًا حتى لا تختفي. هناك لحظات تبدو فيها أحداث الفيلم متشظية، لكنها تتجمع لاحقًا في صيغة سؤال واحد: كيف نتذكر؟
السينما كتوثيق.. والمهرجان كمنصة
يعرض «العميل السري» عالمًا سياسيًا خاصًا بالبرازيل، لكنه يتجاوز المحلية من خلال قدرته على قراءة علاقة الإنسان بسلطة الماضي. وهنا ـــ تحديدًا ـــ يبرز البعد الثقافي الذي حمله عرضه ضمن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في المملكة العربية السعودية. فاختيار هذا العمل ليكون جزءًا من برنامج المهرجان في دورته الخامسة (2025) يشير إلى انفتاح ثقافي متصاعد على سينما عالمية ذات طابع تاريخي وسياسي، ويكشف أيضًا عن تحوّل تشهده المملكة في الصناعة السينمائية. لم يعد المهرجان مجرد منصة عرض للأفلام، بل تحوّل إلى فضاء حقيقي للحوار، حيث تلتقي فيه الأعمال العالمية مع الجمهور المحلي، وتفتح أبواب النقاش حول الذاكرة والهوية والتحولات الاجتماعية.
ومع توسع البنية التحتية للسينما في السعودية، ونمو حضور المهرجانات، أصبحت العروض التي كانت قبل سنوات بعيدة ومستحيلة عن الجمهور المحلي، جزءًا من المشهد الثقافي العالمي اليوم، فتجربة عرض فيلم «العميل السري» هنا ليست مجرد تجربة عرض فيلم في مهرجان سينمائي، إنما تمثِّل مؤشرًا على مرحلة جديدة من علاقة الجمهور السعودي بالسينما العالمية، مرحلة تتسع فيها الرؤية، وتتعمق فيها أسئلة الفن. إن تطوّر الحركة السينمائية في المملكة العربية السعودية خلال الأعوام الأخيرة يعكس روحًا ثقافية جديدة، لم تعد تكتفي بالمشاهدة من بعيد، وإنما أصبحت جزءًا من صناعة السؤال السينمائي العالمي. وفي هذا السياق، يمكن قراءة تجربة عرض الفيلم بوصفها خطوة في هذا التحوّل: من المتفرِّج السلبي إلى المشارك في صناعة المعنى، والتفاعل معه، ومن المستهلك إلى الشريك في إنتاج المعرفة السينمائية.
سينما تحاول إنقاذ ما لم يُكتب
في النهاية، لا يسعى فيلم «العميل السري» إلى الإجابة عن أسئلة الهوية الكبرى بقدر سعيه إلى إعادة طرحها من جديد: من يُقرر ما يجب أن نتذكره؟ ومن يُدير ذاكرة الشُعوب؟ وكيف يتحوّل الماضي إلى مساحة صراع بين السلطة والناس؟
ومن زاوية أخرى، يمكن النظر إلى الفيلم بوصفه محاولة لطرح سؤال مضاد، حول مفهوم الأثر نفسه: ماذا لو كان ما نحاول الاحتفاظ به بعيدًا عن الحقيقة الكاملة، وأحيانًا أشبه بشذرات متناثرة لا تكتمل إلا من خلال ذاكرة المتلقي؟ هنا لا تصبح الذاكرة ملكًا لصانع الفيلم وحده، بل تتحوّل إلى عملية تشاركية تحتاج إلى الاستعانة بالخيال، وإلى القدرة على ملء الفراغات التي تركها التاريخ. هذا الأسلوب يجعل «العميل السري» أشبه بتجربة قراءة طويلة تعتمد على التقاط المعنى من الهامش، وكأن الفيلم يذكِّر بأن ما يبقى في الذاكرة ليس الحدث المكتمل والحقيقي، إنما التفاصيل الصغيرة التي تفلتت من السردية الرسمية، وتلك التي يصرّ الإنسان على حملها رغم تعاقب الأزمنة. ولعل هذا ما يجعل تجربة المشاهدة ممتدة حتى بعد انتهاء الفيلم، لأن كل مشاهد يجد في النص ما يتقاطع مع ذاكرته الشخصية، أو ربما يجد ما كان يخشى أنه نسيه بالفعل.
لذلك يخرج المشاهد على الأغلب من الفيلم بأسئلة أكثر من تلك التي دخل بها، وذلك هو جوهر التجربة؛ لأن ما يتم محوه بالقوة لا يعود بسهولة، وما يختفي أثره يحتاج إلى الفن والخيال، وإلى سينما جادة، قادرة على إعادة كتابته. إن كليبر مندونسا لم يصنع فيلم تجسسٍ فحسب، وإنما بنى أرشيفًا بصريًا حاول من خلاله أن يضيف إلى ذاكرة بلاده ما لم يسمح التاريخ بكتابته. وهكذا، يصبح «العميل السري» شهادة سينمائية عن زمن كاد أن يختفي تمامًا، وفعل مقاومة ضد المحو، وتذكيرًا بأن السينما ليست ترفيهًا فحسب، بل طريقةً لفهم العالم، والبحث عن أثر الإنسان في زمن يصرّ على جعله مختفيًا.