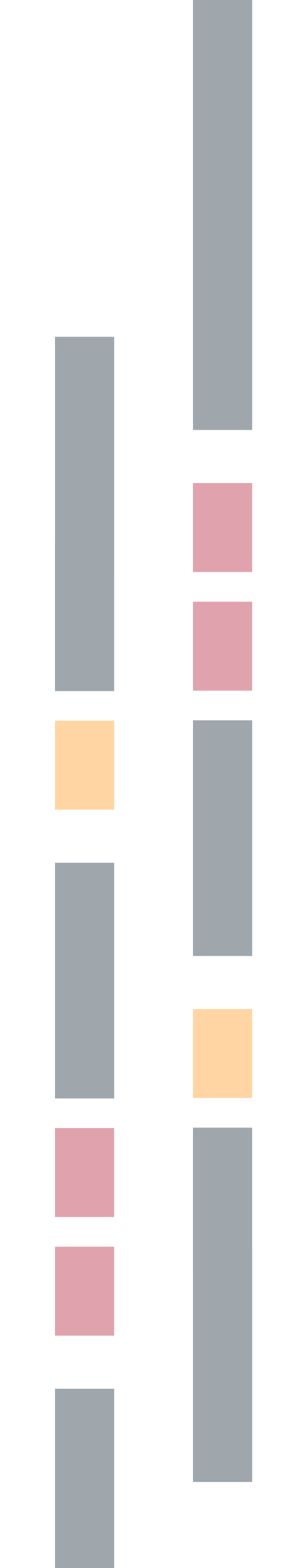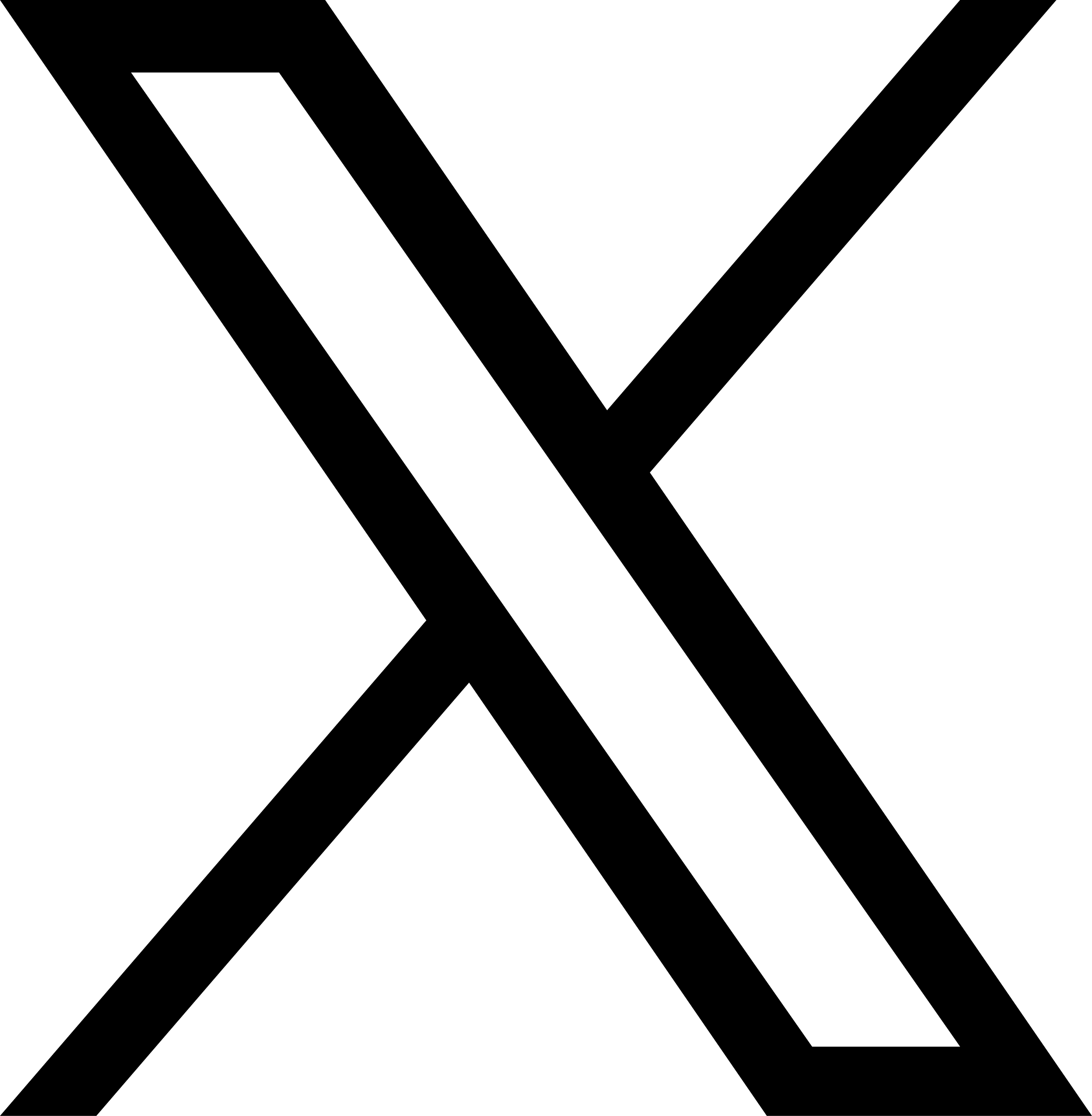شارك
«كنتُ أُفكِّرُ في الفيلم وأكتبه منذ عشرين عامًا، لكننا كتبنا أفضل تَسلسل له في يومٍ وليلة على مائدة العَشاء» (بول توماس أندرسون).
في كوخٍ صغير في الغابة مع ليوناردو وتشيس، في موقعٍ لا يُمكن أن يتسِع إلا لأربعة أشخاص، بدأ السينمائي التجريدي بول توماس أندرسون PTA، يُطوِّر محاوِر فيلمه الملحمي الجديد، الذي ظلَّ على مكتبه لفترةٍ من الزمن، والذي اعتبره قصة شخصية يُمكنه الارتباط بها. بالنسبة إليه كانت تلك طريقة رائعة للبدء في التعرُّف على ملامح شخصيات الفيلم الرئيسية.
وقد قال أندرسون في المؤتمر الصحفي الدوليِّ الخاص والمُباشر (الهجين) لفيلم «معركة واحدة تلو الأخرى One Battle After Another ( 2025)» -(إدارة: إريك ديفيس، الضيوف: بول توماس أندرسون، ليوناردو دي كابريو، تشيس إنفينيتي، ريجينا هول، شون بن، تيانا تايلور، وبينيسيو ديل تورو)، المُقام في 11 سبتمبر 2025، في لوس أنجلوس: «كنتُ أُفكِّرُ في الفيلم وأكتبه منذ عشرين عامًا، لكن بينيسيو جاء ليُنجز تسلسله؛ فكتبنا أفضل تسلسل للفيلم في يومٍ وليلة على مائدة العشَاء. في أثناء التطوير كانت لدينا فكرتنا ومحاوِر قصتنا وشخصياتنا. كان لا بد من وجود مساحة للاكتشاف ضمن حدود المعقول؛ إذ لا يُمكننا الخروج والأمل في العثور على شيءٍ ما، ولكن كان لدينا ما يَكفي من العاطفة في الحبكة؛ لذا غامرنا وبدأنا اللعب».
قبل ذلك، ولأكثر من 25 عامًا، أدرك اثنان من أعمدة هوليوود الأكثر جُرأة وأصالة، بول توماس أندرسون وليوناردو دي كابريو، أن تعاونهما معًا سيحين في الوقت المناسب؛ منذ أن رفض ليو دور البطولة في فيلم أندرسون «الليالي الراقصة (1998)» لصالح دور البطولة في فيلم جيمس كاميرون «تايتنك (1997)»؛ ما شكَّل ندمًا قديمًا وجُرحًا مفتوحًا لـ«ذئب وول ستريت». بدَت رغبة ليو في القيام بدور البطولة في أحدثِ أفلام أندرسون نوستالجيَّة للغاية؛ إذ أشار إلى أنه ظلَّ لسنواتٍ طويلة يحلُم بالتعاون في أيّ فيلم يقترحه بول. لكن في الأساس كان آدم سومنر، المنتج المحبوب في هوليوود، هو مَن دفعهما إلى البدء في إنتاجه؛ إذ كان يقول لهما دومًا: «ابدأوا يا رفاق، ستُحِبونه. الآن، هو الوقت المناسب».
 الملصق الرسمي لفيلم «معركة واحدة تلو الأخرى (2025)» من وارنر برذرز – بول توماس أندرسون
الملصق الرسمي لفيلم «معركة واحدة تلو الأخرى (2025)» من وارنر برذرز – بول توماس أندرسون
في قالبٍ من الكوميديا السوداء الساخرة المَشحونة سياسيًا يَستعيد الأميركي أندرسون «ديستوبيا» الماضي في القرن الحادي والعشرين؛ إذ استوحى فيلم «معركة واحدة تلو الأخرى» من رواية توماس بينشون «فينلاند» الصادرة عام (1990)، التي تجري أحداثها في ستينيات القرن العشرين. من خلال المَزج بين الحركة والكوميديا والاستعارة السياسية: في الولايات المتحدة المُعاصرة وعلى الحدود مع المكسيك، تَجري العديد من الأحداث والمعارك المُرهِقة. الخلفية البانورامية للفيلم تُسلِّط الضوء على الظاهرة المُتنامية في الولايات المتحدة؛ إذ ركز أندرسون على عنف المُتطرفين؛ بنقده اللاذع للضرَر الذي سيُلحقه صعود أفكار تفوق العِرق الأبيض على أميركا. لكن جوهر الفيلم يدور حول الأب بوب فيرغسون (ليوناردو دي كابريو) الذي يعيش في عُزلته التامَّة حالة من جنون العظمَة مع ابنته المراهقة المُستقلة ذاتيًا التي لا يفهمها. وحين تختفي ابنته بعد ظهور عدوه ستيفن جاي لوكجو (شون بن)؛ يندفع الراديكالي السابق -كعضو في مجموعة «فرنش 75» - للعثور عليها فيما يقاتل عواقب ماضيه، رفقة مُدرِّب فنون القتال سيرجيو سانت كارلوس (بينيسيو ديل تورو)، الذي يقول عن دوره: «أودُّ أن أشكر بول على الدور؛ لمَنحي فرصة أن أكون في فيلمٍ مع اثنين من أقدَم أبطالي في هوليوود: شون بن، وليو». فيما يقول ليو عن انضمام ديل تورو الذي ساهم في تطور شخصيته: «أعتقد أن إنسانية شخصية بوب غريبة. بمجرد أن قرأتُ سيناريو بول للمرة الأولى اعتقدتُ أن الشخصية تقليدية للغاية، لكننا اتخذنا قرارات حاسمة على الفور، منها: وصول بينيسيو، حيث شكَّلت شخصيتي وشخصيته مُنعطفًا مختلفًا انتقل معنا إلى النهاية. أحببتُ فكرة وجود شخصٍ تعتقد أنه سيكون هذا البطل القادر على العودة إلى الحياة من خلال استخدام أدوات ماضيه ليصبح البطل الأسمى». تكمن بطولة الأب الحقيقية في المُضيِّ قُدُمًا بلا هوادة لحماية ابنته، حيث تتطور الشخصية مع تطور الفيلم، ما منحه نوعًا من التحول الدراماتيكيِّ الذي انتقل مع بوب تدريجيًا نحو النهاية، يقول ليو: «أحبُّ هذا النوع من المشاهد التي تتناول الحياة اليومية، حيث بوب وويلا في بداية الفيلم. القصة التي لا تتحدث عن أبٍ قرويِّ سعيد ومثالي، بل أبٌ ينفصلُ عن ابنته: إنها من جيلٍ مختلف، وهو مُنفصلٌ عنها تمامًا. الأب الذي يَضطرُ لإنقاذ ابنته في هذه الظروف القاسية».
بالنسبة للأوسكاريِّ ليوناردو دي كابريو، هذا الفيلم لا يُظهر فتى هوليوود الذهبيَّ والممثل الأكثر شُهرة على الإطلاق كبطل رومانسي خيَّمت الفتيات لساعاتٍ طويلة في لندن كي يلمَحنه فحسب، ولا النجم الذي شبَّهه اليابانيون بـ«غودزيلا»، ولا الممثل الذي يختار ألمَع المخرجين الذين سيعمل معهم، بل أبًا مُضطربًا كارثيًا مُحطَّمًا مَليئًا بالعيوب والخيارَات غير المُتوقعة مع مزيج من الانتماءات الحزبيَّة والمُعتقدات، بجانب مُطاردته لأشباح الماضي الذي لا يتذكَّره، فيما يعيش صراعات خارجية مع مَن هُم حوله وداخلية مع نفسه. بوب ليس «والد العام» بالتأكيد، لكن الفيلم يَسرد من خلال الشخصية أنه لا يمكن لأحدٍ أن يتفوَّق على ما لا مفرَّ منه، بالنسبة إليه كان غاضبًا من صدمة الواقع له بأنه لا مفرَّ من نزوله إلى مُعتركِ الحياة اليوميِّ كأبٍ لابنة من جيلٍ مختلف، ولا مفرَّ له حتى من الماضي الذي حطَّمه إلى مليون قطعة. يقول ليو: «كانت هناك الكثير من التوقُّعات التي كنتُ قد كوّنتها في ذهني مُسبقًا، والتي بدأت تتلاشى تدريجيًا مع تصوير الفيلم. أعتقد أننا لم نُدرك بطولة بوب وصموده وعدم استسلامه إلا في الأسابيع القليلة الماضية. أنا معجبٌ جدًا بهذه الفكرة. والآن، أدركتُ قوته التي تجلَّت في وقوفه إلى جانب ابنته وتأثُّرها بخيارَاته. ليس فقط ما فعله من منظورٍ شخصيِّ بل حقيقة أن ماضيه الذي عاد ليُطارده ينتقل الآن إلى الجيل التالي. وأعتقد أنه بذلك جسَّد نهاية مثالية لما سيواجهه الجيل القادم». كان دور بوب أكثر أدوار ليو نُضجًا؛ وهو ما سعى إليه منذ عام 2000 في محاولةٍ منه للتخلص من الوجه السينمائي الرومانسي الذي ظلَّ يُلاحقه منذ فيلم «تايتنك (1997)» رغم إدراكه أنه لن يصل إلى تلك الشعبية مرَّة أخرى في أيّ فيلمٍ آخر ولن يسعى للحصول عليها أيضًا. الأمر الذي لم ينجح إلى الآن، لكن لا أحد يعلم إلى أيّ مدى في المستقبل ستتغلب صورة جنون «بوب» على صورة رومانسية «جاك» كصورة نمطيَّة لليو في العقل الجَمعي للجمهور.
 لقطة من فيلم «معركة واحدة تلو الأخرى (2025)» - بول توماس أندرسون
لقطة من فيلم «معركة واحدة تلو الأخرى (2025)» - بول توماس أندرسون
أمَّا الابنة ويلا (تشيس إنفينيتي) -في أوَّل أدوارها الروائيَّة- فقد قدَّمت أداءً رائعًا اعتمد الفيلم بشكلٍ كبير على نجاحه أو فشله. وبالرغم من أن بول لم يُجرِ تجارب الأداء معها؛ إذ منحها ابتداءً دروسًا في الكاراتيه، إلا أن تدرُّبها على فنون القتال لمدة 4 أشهر ساهم في تقمُّصها للشخصية واندماجها اللافت إلى حدٍ ما مع الطاقم، وتقول تشيس عن ذلك: «ما أردتُ فعله أكثر من أيّ شيء آخر هو التركيز على مشاعر ويلا وجهلها التَّام بقصتها. أعتقد أن ذلك ساعدني حقًا في تقمُّص الشخصية، بدلًا من الاعتماد على تدريب فنون القتال فحسب. هذا الجانب الجسدي ساعدني كثيرًا؛ إذ كنتُ أرغب بشدة في أن أكون شريكة رائعة في المشهد مع ليوناردو دي كابريو وريجينا هول وشون بن وتيانا تايلور وبينيسيو ديل تورو. أردتُ أن أضمن تواجدي معهم في المشهد أكثر من أيّ شيء آخر؛ لذا كنتُ أستغل تلك الطاقة بدلًا من أن أدع أعصابي تَستغلني». فيما يقول ليو عن اندماج تشيس وبول: «بدا الأمر أشبه بمُدرِّب ومُلاكم؛ كان لديهما أسلوب مُختصر؛ كانت بينهما ثقة غير مُعلنة؛ لذا كان من الرائع مُشاهدتها من خلف الكاميرا».
أمَّا الأم بيرفيديا بيفرلي هيلز (تيانا تايلور) فقد بدَت في حالة صراع للبقاء على قيد الحياة فيما تتنقل ما بين العُمق العاطفي الخام والجسدي الطاغي. بدَت تايلور قوية جدًّا ومُستعدة للغاية للشخصية منذ تجارب الأداء؛ إذ جاءت بظفرٍ مَكسور وضمَّادة، قال أندرسون: «النقطة المُهمة هي أن تيانا بدَت مُحترفة على الفور»، عَزَت تيانا ذلك بقولها: «كان من السهل استغلال حقيقة أن بول كان يُسلِّط الضوء على اكتئاب ما بعد الولادة، وهو أمرٌ حقيقي جدًا لا يُناقش كثيرًا؛ لذا كنتُ مُتحمسةً جدًا للتعمق في هذا الموضوع لتسليط الضوء عليه كأم أيضًا. حيث نرى امرأة تحاول النجاة، امرأة تُدافع عن نفسها، وهو أمرٌ نادر؛ لأننا مُجبرات على أن نكون قويَّات». والمفارقة أن الشخصية التي قدَّمت واحدة من أقوى صور الفيلم استُلهم اسمها من أغنية، كان الأمر ارتجاليًّا كأغلب محاوِر الفيلم التي جاءت مباشرة من ورشة الكتابة؛ فعندما كان بول يُغنِّي أغنية إسبانية بعنوان: «بيرفيديا»، تحدَّثوا عن مدى روعة الأغنية والفكرة التي تقول فيها امرأة: «سأصمدُ مهما كلَّف الأمر»، على الفور بدَت الأغنية مُناسبة للشخصية: أنانية ومُتلاعبة للغاية لكنها في الوقت نفسه قوية جدًا. أشارت تيانا أيضًا إلى أن شخصيات بيرفيديا المتعددة بدَت كطبقاتٍ من ألوان مختلفة ساهمت في وصولها إلى تلك الشخصيات والتبديل فيما بينها بكل يُسر مع ركضها المَحموم الذي تقول عنه: «لم أكن مُستعدة للركض لكنه أذهلني؛ ما أحببته فيه هو أنه غرَس فيَّ روحًا جديدة». تمامًا كما أشار شون بن إلى أن ركض بيرفيديا بدا كحدث رياضيّ؛ إذ لا يوجد ما لا تستطيع فعله. وهذا ينطبق على ويلا أيضًا؛ إذ لم يخطر ببال لوكجو أنها ستفلت من قبضته عندما كان يركض خلفها.
ومِن بين شخصيات الفيلم بدا شون بن في دوره الانتقاليِّ الذي قد يحصد عليه الأوسكار، الأكثر إبرازًا للجانب الجسدي الكاريكاتوريِّ المُستلهم من أفلام الغرب الأميركي التقليدية. يقول عن اكتشافه لشخصية لوكجو التي ضحك منها كثيرًا عندما قرأ النصّ للمرة الأولى: «الأمر أشبه بحفلةٍ حضرتها قبل عشرة أشهر، عندما عَزَف أحدهم مقطوعة موسيقية، فرقصتُ عليها. فسألني: "كيف رقصتَ عليها؟". فأجبته: "لا أعرفُ تحديدًا". هذه المرة، بدا الأمر كما لو أن هناك موسيقى سمعتها في النصّ عندما قرأته للمرَّة الأولى، فرقصتُ عليها، وظهرت النتيجة كما ترون».
فيما بدَت شخصية دياندرا (ريجينا هول) التي توجَّب عليها أن تأخذ الفتاة الصغيرة وتبذل قصارى جُهدها للحفاظ عليها آمنة، الأكثر مُساهمة في خدمة الهدف النهائي للفيلم وهو «إنقاذ ويلا». تقول عن تعاونها مع تشيس التي جاءت من شيكاغو بموهبتها وشجاعتها: «أعتقد أنها كانت مُميزة للغاية. في أول يومٍ قرأنا فيه النصّ معًا حافظت على براءتها. كان ذلك مُهمًا جدًا لويلا التي تريد إنقاذ الفتاة التي يريد الجميع إنقاذها». تقول ريجينا عن أهدأ أدوارها، وعن تعاونها الأول مع أندرسون: «كان العمل معه حُلمًا. لكنه أصبح أكثر من مجرد مخرج؛ إذ رأيته كإنسان، كصديق، وكنتُ سعيدة جدًا لأنه كان طبيعيًا: إنه حيٌّ ومرحٌ وذكيٌّ. عندما بدأنا العمل معًا كنتُ في الواقع متوترة، والآن، أكثر توترًا لأننا أصبحنا أصدقاء بالفعل». هذه الصور بورتريه لسينما PTA المُؤثِّرة والمُبهجة في الآن ذاته. وفي نهاية المطاف، كان هناك الالتزام الأبديِّ تجاه الأسرة وسط هَوس العالَم المُعاصر.
 لقطة من فيلم «معركة واحدة تلو الأخرى (2025)» - بول توماس أندرسون
لقطة من فيلم «معركة واحدة تلو الأخرى (2025)» - بول توماس أندرسون
صُوِّر فيلم «معركة واحدة تلو الأخرى» بكاميرا مدير التصوير مايكل باومان «35 ملم»، وبتقنية الشاشة الكبيرة «فيستا فيجن Vista Vision» الثلاثية الأبعاد، بلا نظارات، وتقنية «آيماكس IMAX»؛ لمنح المتفرج تجربة ضخمة حيَّة وعالية الجودة، والدخول إلى أعماق المُمثلين وإلى ما وراء الأداء ومشاهد الحركة بطريقةٍ لا تستطيع مُعظم الكاميرات التقليدية تحقيقها. تقنية فيستا فيجن مُهمة جدًا لأفلام الحركة، فقد كانت جيدة بما يكفي لألفريد هيتشكوك في فيلميِّ: «شمالاً شمالاً غربًا (1959)»، و«فيرتيجو (1958)»، كما كانت جيدة بما يكفي أيضًا لجون فورد في فيلم «الباحثون (1956)»، ولجميع الأفلام الكلاسيكية التي تستخدم هذا الشكل الفيلميِّ الذي لا يُربط بالأداء الرائع فحسب بل بالتجارب السينمائية الحقيقية، يقول أندرسون: «على الرغم من قِدَم تقنية فيستا فيجن، إلا أنه لا يُفترض أن تفقد رونقها، ومن الرائع حقًا رؤيتها تعود وتزدهر. الهدف هو رؤيتها ضخمة وصاخبة؛ لأنها ستُقدِّم أداءً مُذهلاً كما كانت». ما ظهر جليًّا في مشاهد المطاردة التي تُعد الأكثر إبهارًا في الفيلم؛ إذ تستكشف بدقة مواقع التصوير، يقول أندرسون: «كنَّا نعلم أن أبطالنا على الطريق، وكنَّا نعلم أننا في الصحراء: هناك بدأت الرحلة، هناك ستبلغ ذروتها، وهناك ستنتهي». بعد سنوات من البحث عن مواقع التصوير المختلفة وصل فريق الإنتاج إلى خطِّ النهاية، إلى موقع أطلقوا عليه اسم «نهر التلال»، حيث انتهى بهم المطاف على بُعد ساعة تقريبًا شرق بوريجو سبرينغز، بالقُرب من حدود أريزونا. الموقع الذي كان «هديَّة من السماء» جسَّد ذروة القصة، يقول أندرسون: «كنَّا في السيارة نسيرُ على الطريق، وفجأة شعرنا بحماسٍ لهذا الجزء من الطريق، وكأنه هدية من آلهة السماء. فبعد كل تلك السنوات من القيادة والبحث عن شيءٍ ما، ظهر لنا هذا الطريق الذي سارعنا إلى استغلاله، وانطلقنا بهذه الفكرة. إنه لأمر مُثير للغاية عبور كل تلك الطُرق، لكن أفضل ما في الأمر لقلبِ الأمور هو استغلال ويلا لهذه الفرصة والسيطرة على قصتها والتفوُّق عليها».
كان بول من خلال مشهد «مطاردة السيارات» يتتبع مشاعر ويلا دون إفساد أيّ شيء آخر: الموازنة التي استطاعت أن تجمع ما بين مشاهد الحركة الكبرى والخطيرة وتلك اللحظات الهادئة التي تُحرِّك الشخصيات. كان الأمر أشبه بتجميع قِطع «الليغو»؛ حيث من المهم إتقان كل شيء دون إغفال الحفاظ على سلامة وأمان الجميع، تقول تشيس: «كان الأمر مُمتعًا للغاية. كان خطًا فاصلًا شعرتُ أنني مُضطرة لتجاوزه. بول وأنا تحدثنا عن تتبعه معًا؛ لذا كان إيجادنا لهذا الخط رائعًا جدًا، وبمجرد أن فهمناه شعرنا بذلك». فيما يقول بول عن تلك اللحظات الأكثر مُتعة له كمخرج: «لقد تعلَّمتُ أن العمل أكثر مَلَلاً مما يبدو عليه في الفيلم؛ إذ لا يمنحك نفس الرضا الذي يمنحك إيَّاه العمل الجاد مع الممثلين في مَشهدٍ واحد. أقصى درجات المتعة أن تضطر كمخرج إلى تسليم موقع التصوير لمُنسقيِّ المشاهد الخطرَة مع منحهم الثقة. في الواقع، عليك أن تتنحَّى جانبًا: أن تجلس مكتوف الأيدي وتتركهم يتولون مهمة العمل». كان المنتج ومساعد المخرج آدم سومنر، الذي رحل عن عالمنا في نوفمبر 2024، هو من قاد إنتاج فيلم «معركة واحدة تلو الأخرى» رفقة بول. في تعاونه الخامس مع أندرسون، ظهرت خبرته الواسعة في تحريك المشاهد بدقةٍ واقعية مُتناهية مَزجت ما بين التصوير السينمائي الدقيق الذي يعكس العُمق النفسي للشخصيات وصراعها ضد هواجسها والموضوعات المُعقدة، من خلال خلق عوالَم ينغمس فيها المتفرج كليًّا مع موضوع الفيلم المُثير للجدل، يقول أندرسون: «كنَّا ننطلق ونبدأ التصوير، في فترة الظُهر وكذلك في فترة ما بعد الظُهر أو في المساء. كان يقودنا منتجنا ومساعد المخرج الرائع الذي لا يفتقر إلى الخبرة في القيام بأعمال الحركة واسعة النطاق. إنه يُجيد هذا النوع من العمل، فقد كان يتمتع بخبرةٍ لا تُصدَّق، وكان يُجيد تحريك كل هذه القطع». اعتمد أندرسون على الأسلوب البصري الجريء الذي يتنقل ما بين الكاميرا المتحركة والتصوير الذي يستغرق وقتًا طويلاً على أساسٍ ثابت، بجانب المؤثرات البصرية والسمعية المتعددة الطبقات، والجوانب النفسية الدرامية والواقعية، والمواضيع التي تتفاوت ما بين القوة والضعف والهوَس والتفاؤل والعزلة واليأس والحُبّ والكفاح ونقد الواقع، وبالطبع، الشخصية الأميركية «اللا مثالية» مع الجشع الأميركي الخالص بامتياز. بجانب الخيارَات الموسيقية الفريدة لبيانو جوني غرينوود: واحدة من الأفكار الأصيلة المُتماهية مع مستوى التوتر العام للفيلم، والدافع الرئيس خلف تلوين بعض المشاهد الرتيبة. وبالرغم من أنها بدَت حادَّة بشكلٍ خاص إلا أنها تُعد رفاهية بحد ذاتها؛ إذ يشعر المتفرج بروح الموسيقى في أجساد الشخصيات؛ ما يدفعه إلى تجربة رحلة مُماثلة. في الفيلم يَظهر جليًّا شغف بول القديم بالموسيقى؛ إذ يعتبرها الجزء الأهم الذي لا يتجزأ من الفيلم، والمسؤول الأول من خلال الإيقاع والكلمات عن استحضار الزمان والمكان معًا، يقول أندرسون: «مِن المفيد دومًا أن يكون لديك شيءٌ مثل الموسيقى لتتمسَّك به؛ يمكننا جميعًا فِهمها والشعور بها. في إل باسو، كانت لدينا موسيقى: مقطوعة البيانو الطويلة تلك التي كنَّا نعزفها معًا يوميًا؛ وهكذا حصلنا على فكرة ولمحة سريعة عن مسَار الفيلم وما نحتاجه للاستمرار».
فيما كانت خدمة الغُرف في أنزا-بوريغو، هي التحدي الأكبر الذي واجه إنتاج الفيلم، يقول أندرسون: «الحصول على خدمة غُرفٍ جيدة بعد الساعة التاسعة كان الجزء الأكثر صعوبة. لكنني عندما أسمع كلمة "صعب" لا أفهمها؛ إذ بالعودة إلى التجربة كاملة: كان الذهاب إلى العمل مُمتعًا والنوم مُحبطًا والاستيقاظ في اليوم التالي للعمل ليومٍ آخر مُثيرًا للغاية. ولطول فترة الإنتاج كان لا بد من إيجاد تحديَّاتٍ ما فيها، لكن مجرد وصولنا إلى نهاية التجربة وشعورنا بأننا قد بذلنا قُصارى جهدنا لهو شعورٌ مُرضٍ للغاية بحد ذاته».
 لقطة من فيلم «معركة واحدة تلو الأخرى (2025)» - بول توماس أندرسون
لقطة من فيلم «معركة واحدة تلو الأخرى (2025)» - بول توماس أندرسون
«معركة واحدة تلو الأخرى (2025)» هو أكثر أفلام أندرسون تكلفةً، بميزانيةٍ بلغت 140 مليون دولار، لا يستكشف مواقع التصوير فحسب بل يعكس قُدرة أندرسون المُتقدِّمة في العمل مع العديد من الشخصيات التي تنوَّعت ما بين المواهب اللامعة والصاعدة وتلك الحقيقية من الواقع، ففي هذا الفيلم كان هناك أصحاب متاجر وجنود وممرضات وضباط إصلاحيات حقيقيون، كل ذلك أثَّر على سرديَّة الفيلم وثقافته وعلى مسار شخصياته أيضًا. يقول ليو: «بحصولنا على هذه الفرصة شعرنا فورًا وكأننا فريق؛ بفضل سهولة عملنا معًا، والمرونة التي يُضفيها بول على بيئة عمله المُتكاملة في موقع التصوير، بجانب الشعور بالمسؤولية الذي منحنا إيَّاه كشخصيات لنتمكَّن من تغيير مسَارنا. غالبًا ما يعلَق الكُتَّاب والمخرجون في أفكارهم حول الشكل الذي يريدونه للفيلم، وفي حالته كان بول يُفكر في الفيلم منذ 20 عامًا، لكننا مع جلسات الورش الجماعية سَلَكنا مُنعطفات ومسَارات مختلفة». فيما يقول بينيسيو ديل تورو: «في العمل مع بول، لم أكن أعرف ما أتوقعه. بول يُحبُّ الضحك كثيرًا؛ لذا جعل الأمر مريحًا وممتعًا للغاية. أعتقد أن من مميزاته أنه يُحبُّ أسلوب الممثلين. هو يستمتع بذلك كثيرًا، وهذا أمرٌ رائع بحد ذاته للممثل». على الرغم من زُهده المعروف عنه في العلاقات العامة والشُهرة وحُبِّ الظهور ظلَّت علاقة PTA الجيدة مع الممثلين مِيزة إضافية لأعماله؛ فغالبًا ما حمَل معه الشركاء الذين يختارهم بعناية في أيّ عمل جديد له. كان من المُفضَّلين لديه: الراحل فيليب سيمور هوفمان، الذي تعاون معه في فيلم «لعبة الثمانية الصعبة (1997)» الذي رسم الملامح التجريبية لسينما بول، والذي منح أندرسون الترشُّح الأول لأوسكار أفضل سيناريو أصلي، والفيلم الدرامي النفسي «ماغنوليا (1999)» الذي تلقى إشادات نقدية واسعة النطاق، والذي منح أندرسون الترشُّح الثاني لأوسكار أفضل سيناريو أصلي. والفيلم الشاعري «حبٌ مُترنِّح (2002)» الذي ترشَّح للسُّعفة الذهبية، والفيلم الأقل شُهرة «المعلِّم (2012)» الذي ترشَّح لثلاث جوائز أوسكار. فيما اعتُبِر أندرسون أحد ثلاثة مخرجين تعاون معهم دانيال داي لويس، بدايةً بالفيلم الأوبراليِّ «ستسيل الدماء (2007)» المُقتبس عن رواية «النفط» لأبتون سنكلير، الذي منح أندرسون ترشيحات الأوسكار لأفضل سيناريو مُقتبس، وأفضل مخرج، كما ترشَّح الفيلم لأوسكار أفضل فيلم، وفيلم دراما الأزياء «الخيط الوهمي (2017)» الذي يُصوِّر جانبًا من حياة المُصمم البريطاني رينولدز وودكوك، والذي منح أندرسون الترشُّح لأوسكار أفضل مخرج، وترشَّح الفيلم لأوسكار أفضل فيلم أيضًا. وخواكين فينيكس في تعاونه الثاني معه في فيلمه الأكثر غموضًا «الرذيلة المُتأصلة (2014)»، المُقتبس عن رواية توماس بينشون الصادرة عام (2009)، والذي منح أندرسون الترشُّح لأوسكار أفضل سيناريو مُقتبس. فيما ترشَّح بول أيضًا لأوسكار أفضل سيناريو أصلي وأوسكار أفضل مخرج وأوسكار أفضل فيلم عن فيلم «بيتزا عرَق السوس (2021)» بجانب العديد من النجوم مِن بينهم: جوليان مور، جون ك. رايلي، ويليام ميسي، ميلورا والترز، لويس غوزمان، وفيليب بيكر هال. بالإضافة إلى تعاونه الدائم مع المصور السينمائي روبرت السويت، والمونتيرة ليزلي جونز، ومُصمم الأزياء مارك بريدجز.
وكما أشار المخرج السويدي إنغمار بيرغمان، في حوارٍ صحفيٍّ له، إلى أن سينما بول تُعتبر مِثالاً على قوة السينما الأميركية، لا يزال المخرج المولود في «ستوديو سيتي» الذي صنع أول أفلامه في الثامنة من عُمره، والذي غادر كليَّة السينما في «جامعة نيويورك» ليتعلَّم صناعة السينما من خلال مشاهدة الأفلام، والذي حصد 11 ترشيحًا لجوائز الأوسكار المَرموقة، واحدًا مِن أكثر المخرجين احترامًا في الوسط السينمائي. ولا غرابة في تتويجه بجوائز «أفضل مخرج» المُقدَّمة من أعرِق المحافل السينمائية: مهرجان كان السينمائي الدولي، مهرجان برلين السينمائي الدولي، مهرجان البندقية السينمائي الدولي؛ ففي كثيرٍ من الأحيان، تحاول أفلامه فعل شيء ما أو قوله. فيلم «معركة واحدة تلو الأخرى» كذلك؛ إنه رحلة بريَّة مُمتلئة بالحركة والتشويق. ومنذ العرض الأول الخاص له كان هناك العديد من الإشادات النقدية؛ حيث حصد على موقع «الطماطم الفاسدة» 97%، وعلى «ليتر بوكسيد» 4.3/5، وعلى «ميتاكريتيك» 96%، بالإضافة إلى تلك المُضادة التي رأته كابوسًا أميركيًا حديثًا. إنه الفيلم الذي لا يروي «دراما نفسية سيريالية» تدور أحداثها في وادي سان فرناندو بل «جريمة» تبدو ظاهريًا كفيلم حركة ودراما حربيَّة ومُطاردة سيارات يُقدِّم درسًا فيما سيتعيَّن على الجيل القادم التعامل معه في 162 دقيقة، لكنه أكثر عُمقًا ووعيًا بقوة الإرادة البشرية التي تجسَّدت في قُدرة أندرسون على التحكُّم في القصص الإنسانية والأحداث الصاخبة المُترامية الأطراف، والتركيز على الجزء الأهم في الحياة؛ وهو الزَّخم المُستمر إلى الأمام الذي يتحرَّك في اتجاهٍ واحد فحسب.
يميلُ بول من فيلمٍ لآخر إلى تغيير إيقاع سينمَاه ذات العروض الأوبراليَّة عن الضعف البشري، وفي «معركة واحدة تلو الأخرى» قدَّم عَرضًا أوبراليًا شعبويًا ساخرًا غارقًا في جميع أنواع محتوى عَصره. تقول ريجينا: «ما فعله هو أنه وجد الفكاهة في عبثيَّة الأشياء، في هذا الفيلم الذي يتعلَّق بالحُبّ، بالعائلة، وليس بالضرورة أن تكون عائلة دم، مع أن هذه العائلة موجودة، لكن هناك عائلات أخرى أيضًا: تواصل، التزام». نوعٌ من السرديات الروائية الجدلية الواقعية الرمزية اللا مُتوقعة التي تستكشف أعماق الروح، الشبيهة بالأفلام الوثائقية، التي لا يَبرع فيها إلا PTA؛ إذ لا يُمكن توقُّع سرديات بول كما لم تُمطر أبدًا في جنوب كاليفورنيا على الرغم من توقُّعات هطول المطر التي افتتحت أحبَّ أفلامه إليه وأكثرها فلسفةً «ماغنوليا (1999)». في فيلموغرافيا أندرسون كل فيلم هو أفضل فيلم، كل قصة معركة، وكل شخصية تُصارع لأن تتماسك في عالَمها الضبابي، سواء تلك التي تَستعيد ماضي مَطلع وخمسينيات وسبعينيات القرن العشرين أو المُعاصرة. فيما تحدث هو عن أن الفكاهة جزءٌ لا يتجزأ من سينمَاه، أفلامه في الداخل لا تخلو من «النكتة» بينه وبين المتعاونين معه؛ إنه سعيد لأنه يعمل فيما أحبَّ طوال حياته. وهَا هو يعود من جديد بقصة وشخصيات فيلمه الأكثر جموحًا، الذي يبدو من ذلك النوع من الأفلام التي يُطلق عليها «فيلم العام»: التي لا تُصنع للإبهار الفني والنقدي ولا لبريق شُبَّاك التذاكر فحسب بل للاحتفاء بمسيرةٍ فنية لامعة لواحدٍ من أفضل مواهب السينما الحديثة على الإطلاق، الذي عُد عبقريًا منذ فيلمه الأول. فهل حان الوقت لأن تلتفت هوليوود إلى الوراء كما تُجِيد، وتُتَوِّج كاتب ومخرج مَلحَمَة القرن الحادي والعشرين «ستسيل الدماء (2007)»، بول توماس أندرسون بالأوسكار؟
الهوامش
* هذه المقالة الفنية/النقدية تغطية حصريَّة للمؤتمر الصحفي الدوليِّ الخاص والمُباشر (الهجين)، الذي أُقيم بحضور طاقم فيلم «معركة واحدة تِلو الأخرى (2025)»، في لوس أنجلوس/كاليفورنيا، الخميس 11 سبتمبر 2025.