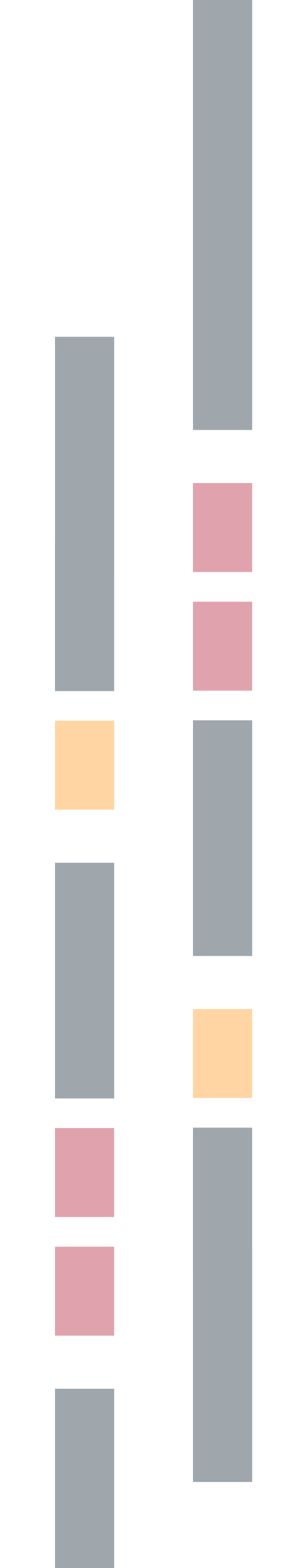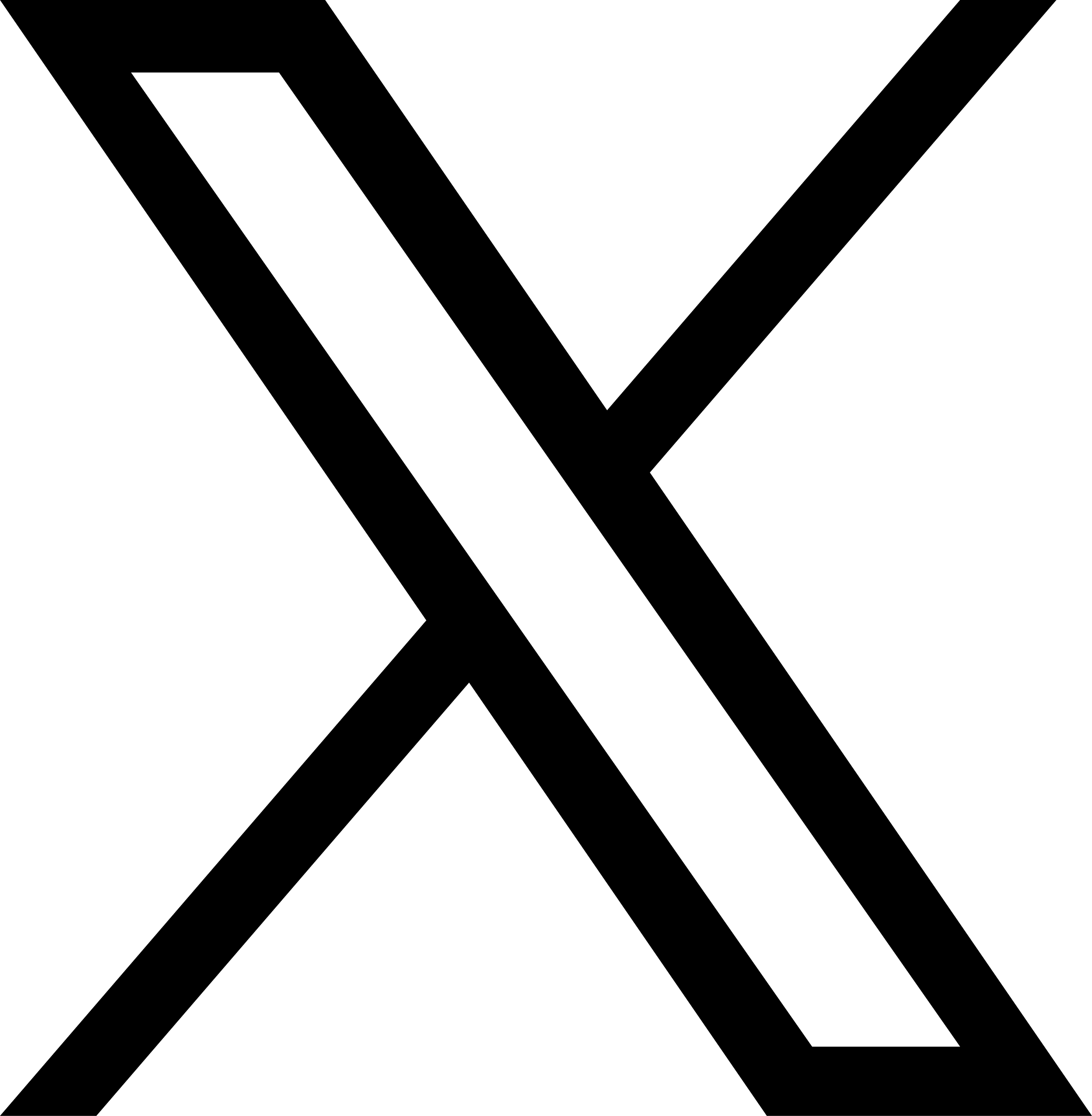شارك
على سبيل التقديم
منذ أن بدأت السينما السعودية تتلمس طريقها نحو الحضور المحلي والدولي، ظهرت على سطحها ثيمات جريئة في المعالجة، تجاوزت ما كان يُعدّ من المحظورات أو من المسكوت عنه سابقًا. ومن بين أبرز تلك الثيمات، تأتي ثيمة الحب، بوصفها واحدة من أكثر الموضوعات التي أثارت الفضول والتساؤل، بالنظر إلى تقاطعها العميق مع البنية الاجتماعية والثقافية المحافظة التي اتسمت بها المملكة لعقود طويلة.
لقد ظل الحب، في الثقافة الشعبية السعودية، حبيس القصائد الغنائية والروايات والقصص القصيرة، بينما غاب حضوره بصورته اليومية الإنسانية خلف جدران التردّد والحذر. غير أن التحولات الكبرى التي شهدها المجتمع السعودي في أعقاب إطلاق رؤية المملكة 2030، وما تبعها من انفتاح ثقافي ووعي إنساني، أعادا التفكير في مفهوم جودة الحياة، وفتحا المجال أمام دعم الإبداع، ما أتاح لصنّاع السينما السعودية إعادة اكتشاف هذه الثيمة بمزيد من الجرأة، ولو عبر الرمزية أو التلميح أحيانًا.
في هذا الإطار، ظهرت أعمال سينمائية حديثة نسبيًا، لم تكتفِ بتقديم الحب كمشاعر رومانسية بين شخصين، بل عملت على تفكيكه كفكرة اجتماعية، ومحاولة تجريده من حمولته الكلاسيكية. من بين تلك الأعمال تبرز أفلام مثل: بركة يقابل بركة 2016 لمحمود صباغ، وحد الطار 2020 لعبدالعزيز الشلاحي، ورقم هاتف قديم 2022 لعلي سعيد، كنماذج فنية تعاملت مع ثيمة الحب في سياق سعودي خاص، حيث تتصارع الرغبة الفردية مع القيم الجمعية، ويغدو الحب أحيانًا فعل مقاومة، وأحيانًا مرآة للحنين، وأحيانًا أخرى مجازًا لحب أكبر؛ حب الفن أو الحياة.
يهدف هذا المقال إلى تفكيك المعالجات السينمائية السعودية الحديثة لثيمة الحب. فهل كان صنّاع هذه الأفلام صادقين في تقديمهم للحب ضمن هذا السياق الاجتماعي المعقد؟ أم أن الصورة السينمائية اختزلت العاطفة في رمزيات فنية مضمرة، تجنبًا للاصطدام المباشر؟ خاصة أن التعبير السينمائي يُتهم غالبًا بأنه تعبير الطبقة المثقفة، التي قد يكون في تعاطيها مع القضايا الإنسانية شيء من الاستعلاء، أو تنزلق إلى فخ الترويج لرؤية خاصة تتجاوز الحكاية، أو تدمج البعد الإنساني في المنظور الرؤيوي الفكري دون مراعاة لحساسية الموضوع.
وقبل إصدار أي حكم نقديّ متسرّع، سنحاول أن نخوض في تحليل النماذج الثلاثة المختارة، محاولةً لتفكيك بنية خطابها الموضوعي ورؤاها الفنية. وتجدر الإشارة إلى أن اختيار هذه الأفلام لم يكن عشوائيًا أو تعسفيًا، بل تم بناءً على معيار رئيس، هو حضور ثيمة الحب بوصفها العمود الفقري للفيلم. بمعنى أن الحكاية السينمائية المختارة ما كانت لتقوم أو تُبنى لولا مركزية ثيمة الحب فيها؛ فغياب هذه الثيمة سيجعل وجود الفيلم -موضوعيًا وربما فنيًا- في حكم المتداعي.
ولغرض تقديم قراءة نقدية دقيقة، سنطرح على كل فيلم عدة أسئلة نراها محورية وهامة، من قبيل: هل للفيلم سؤال موضوعي آخر غير الحكاية الظاهرة (قصة الحب)؟ ثم هل كانت حكاية الحب أمينة للواقع الزمني والمكاني والاجتماعي في تكوينها وخطابها وتفاصيلها؟ ثم كيف عالج الفيلم ثيمة الحب فنيًا، وأخيرًا هل خدم الأسلوب الفني هذه الثيمة الرئيسة؟
بركة يقابل بركة
في عام 2016، أتيحت لفيلم بركة يقابل بركة فرصة فريدة جعلته ثاني فيلم سعودي يحظى بمشاهدة واسعة، بعد فيلم وجدة 2012 للمخرجة هيفاء المنصور. عُرض الفيلم في مهرجان برلين السينمائي لعام 2016، ثم انطلق في جولة دولية مثّل خلالها السعودية في عدد كبير من المهرجانات، وترشح لتمثيلها في جائزة الأوسكار. ولعل الحدث الأبرز في مسيرة تسويقه كان إدراجه ضمن باقة الأفلام المعروضة على رحلات الخطوط السعودية، وهي فرصة استثنائية في ظل غياب صالات السينما في ذلك الوقت داخل المملكة، ما منح الفيلم منصّة فعالة للوصول إلى الجمهور المحلي المستهدف.
هذا الوصول المباشر لجمهور الفيلم الحقيقي -لا النخبوي أو النمطي- كان أحد العوامل الحاسمة في نجاح التجربة. فالمخرج محمود صباغ، خلافًا لكثير من صناع الأفلام آنذاك، لم يواجه عوائق كبرى في إيصال عمله للجمهور، لا الواقعي ولا الافتراضي. وقد تُوج هذا النجاح لاحقًا بعرض الفيلم على منصة Netflix.
هذه الخلفية تسوِّغ لنا طرح أسئلتنا بجدية على الفيلم كما ورد في مقدمة المقال. وإذا فكرنا في الإجابة بموضوعية، سنجد أنها تنقسم إلى وجهتين: أولًا، من زاوية السياق التاريخي الذي أُنتج فيه الفيلم -أي ما قبل رؤية المملكة 2030- حين كان المجتمع لا يزال خاضعًا لشروط دينية واجتماعية ضاغطة، فإن ثيمة الحب، رغم جوهريتها، لا يمكن فصلها عن سياقات القمع والمنع، ما يجعلها تتصدر أولوية الحكاية، وتتخذ طابعًا مقاومًا يوصلها إلى مرتبة السؤال الرئيس للفيلم.
أمّا الوجهة الثانية، والتي تنظر إلى الفيلم بمنظور نقدي يتجاوز اللحظة الزمنية، فإنها تكشف عن تمحور الفيلم حول نقد اجتماعي وفكري مبطن، يتجلى في بنية الفيلم الفنية، من الكتابة، مرورًا بالصور الأرشيفية، إلى معالجة قضايا مثل التحريم والمنع، ومحاكمة النوايا، وصولًا إلى النظرة المجتمعية السلبية للفن وصُنّاعه. ضمن هذا الإطار، تتراجع ثيمة الحب في الفيلم إلى المرتبة الثانية، بوصفها وسيلة وليست غاية، ما يُضعف بعدها الجمالي.
الخلل، إذًا، لا يكمن في وجود خطاب فكري، بل في هيمنته على خطاب الحب، ما أفقد الحكاية عفويتها، وجرّدها من بعدها الإنساني الخالص. هذا التحول في سُلّم أولويات الفيلم دفع بالحب، كثيمة عليا وسامية، إلى مرتبة أدنى، بحيث بدت العلاقة بين «بيبي حارث» و«بركة عرابي» كأداة لخدمة نقد اجتماعي أوسع، وليس بوصفها قصة حب قائمة بذاتها.
من هنا يمكن فهم السبب وراء اعتماد المخرج أسلوبًا كوميديًا، يخفف من حِدّة الثقل الرمزي، ويُختتم بانفصال ناعم لا يُخلّف جرحًا دراميًا. فالفيلم، في جوهره، لم يكن قصة حب بالمعنى التقليدي، بل حكاية مقاومة ناعمة لحقبة اجتماعية، استُخدم فيها الحب كوسيلة، لا كغاية. وهذا ما قد يدفع بعض المتلقين إلى إخراج الفيلم من خانة قصص الحب الخالص، ووضعه في خانة أفلام المرحلة، دون أن يُنقص ذلك من قيمته كوثيقة بصرية عن واقع اجتماعي معين.
فنيًا، يُلاحظ أن فيلم بركة يقابل بركة لديه جماليته البصرية الخاصة، التي جعلت منه فيلمًا هامًا في مرحلة مبكرة نسبيًا في السينما السعودية، وأخص جمالياته جاءت في جانب إبراز جمالية المكان، بالتحديد في المشاهد الخارجية، فرغم صعوبات التصوير الخارجي في ذلك الوقت، إلا أن المخرج لم يستسلم لقاعدة الممكن، بل لجأ إلى المرغوب الفني، فمثَّل المدينة (جدة) وجعلها تتموقع في منزلة تضاهي منزلة البطولة، ولم يفعل ذلك بالاعتماد على حركة الكاميرا الحرة التي تجول في كل اتجاه، بل استخدم البعد الفوتوغرافي لها، وكان هذا الخيار سيهدد البعد البصري للفيلم، لولا أن المخرج ابن المدينة العارف، الذي يدرك ويرى حركة إنسانها داخل فريماته، وكان بسبب ذلك أمام اختبار صعب جدًا، لكنه نجح فيه باقتدار، وهو حركة الممثلين داخل الكادرات الثابتة، ما أعطى للفيلم جماليته الخاصة، المستمدة من وعي الفنان، ومعرفته بمواقع التصوير المناسبة، التي تستطيع من خلال كاميرا ثابتة أن تُخرج كل ذلك الجمال، جمال في السلالم تحت (كبري المربع)، وجمال الميناء من وراء شاطئ البحر، وغيرها.
حد الطار
في مقابل التجربة التي قدّمها المخرج محمود صباغ في فيلم بركة يقابل بركة، يأتي فيلم حد الطار 2020 لعبدالعزيز الشلاحي بوصفه مثالًا على معالجة أكثر صفاءً، وأكثر تواضعًا من حيث ادعاء الأسئلة الفكرية أو الاشتباك المباشر مع الخطابات الكبرى. فيلم يحترم حكاية الحب من حيث كونها حكاية، ويصغي لها لا بوصفها ذريعة درامية، بل بوصفها جوهرًا إنسانيًا كاملًا، يمكن البناء عليه فنيًا وجماليًا، دون افتعال أو إقحام.
لقد حظي الفيلم، على خلاف سابقه، بفرصة تلقٍّ واسعة في دور العرض السينمائي داخل السعودية، بعد إعادة فتح صالات السينما، وهو ما أتاح له أن يخاطب جمهوره المحلي من موقع مريح، دون وسائط ولا حواجز. هذا النوع من التلقي الطبيعي، أعطى للفيلم مساحة أكبر للتأثير والتثبيت في الذاكرة البصرية المحلية، وساعد على ترسيخ العلاقة الحيّة بين الشاشة والمُشاهد.
وإذا عدنا إلى الأسئلة النقدية التي اختطها هذا المقال منهجًا، يمكننا القول إنّ حد الطار يجيب عليها بإجابات مختلفة تمامًا، وأكثر توازنًا على المستويين الدرامي والفني.
يبدو أنّ الفيلم اختار بوعي أن يظل داخل مناخ الحكاية، دون أن يُغريه الانحراف إلى خطاب رمزي ضاغط أو استعراض رؤيوي متعالٍ. لم يكن هناك سؤال آخر يتعالى على سؤال الحب، بل كان الحب هو نواة الحكاية، ومركز التوتر، ومحرّك السرد. هذا الإخلاص لمركزية الحب جعل للفيلم طابعًا دراميًا نقيًا، خلّصه من نبرة النقد الاجتماعي المقنّع، التي كثيرًا ما تُضعف من حضور العاطفة في الأفلام المشابهة.
إنّ حكاية «دايل» و«شامة» لم تُحمَّل بعبء التمثيل ولا الترمُّز، بل عُوملت كعلاقة ممكنة في واقع صعب، لا بوصفها بيانًا، بل قصة يمكن تصديقها، والتعاطف معها دون الحاجة إلى مجاز صريح.
بنى الفيلم إلى حد كبير حكاية الحب داخل إطار اجتماعي واقعي، دون ادّعاء تسجيلي، ودون إفراط في التجميل. الحي الشعبي، الإشارات إلى العادات، ثقل العائلة، التوجس من الفضيحة، القلق من المجتمع، كلها كانت ملامح حاضرة، دون أن تكون مسيطرة على الحكاية.
وقد كان المخرج عبدالعزيز الشلاحي ذكيًا في اختياره الإيحاء البصري بدل التصريح المباشر. مثال ذلك، مشهد «دايل» وهو يجمع أعقاب السجائر في المكان الذي يلتقي فيه مع «شامة» في دلالة حساسة وشفّافة على رغبته في إخفاء آثار اللقاء خشية الفضيحة. هذا المشهد وحده، بلا كلمة، يلخص ما تعنيه المراقبة الاجتماعية على الفرد العاشق.
هذه الأمانة في نقل الجو، دون الحاجة إلى شعارات، منحت الفيلم صفة الحميمية، وجعلت حكاية الحب فيه أقرب إلى الحقيقة من أن يكون مجرد ترف فني.
يمكن القول إنّ فيلم حد الطار من أكثر التجارب السينمائية السعودية اتساقًا بين الشكل والمضمون. الرؤية البصرية كانت ناضجة، تحمل حسًّا تشكيليًا حادًا، يتجنب الزخرفة لصالح التكوين. زوايا التصوير، حركية الكاميرا المتناسقة مع المشاهد، الألوان الخافتة، والموسيقى الموحية، كلها كانت عناصر تصبّ في اتجاه تعميق الإحساس بحالة الحب، لا تضخيمه أو التغني به.
اختار الفيلم أن يسرد الحكاية بشيء من الاقتصاد والتقشف، تاركًا للمتلقي حرية التورط العاطفي دون وصاية. لم تكن هناك مشاهد زاعقة، ولا لحظات درامية مفتعلة، بل انسياب حذر لقصّة حب هشّة تنمو بين شخصين ينتميان إلى عالمين اجتماعيين معقدين، الأول؛ عالم المطربة الشعبية متمثلًا في «بدرية» والدة «شامة»، المخطوبة أصلًا لابن عمها المسجون في قضية قتل، والآخر في تجربة «دايل» ولد السيّاف، ومنفذ أحكام الإعدام، والذي يدفعه عمه باتجاه الزواج من ابنته، والابتعاد عن قصة حبّه، وكلاهما يعرفان أن حبهما مؤقت أو محكوم بالنهاية أو الفقد.
ربما لهذا السبب بدا الفيلم وكأنه ينتمي إلى سردية الحب بوصفه قدرًا لا يُعاش طويلًا، بل يُلمَح ويُفقد، وهي سردية لها عمق تراجيدي وجاذبية إنسانية مقاومة للفشل.
في النهاية، لا يحاول حد الطار أن يدّعي بطولة فكرية، ولا يسعى إلى توريط الحب في صراع فكري ضاغط. إنّه فيلم عن حب يُعاش في الظلال، وعلى أسطُح البيوت الشعبية، لكنّه يظل حُبًا حقيقيًا، يشعر به المتلقي لأنه صُوِّر له لا عنه. ولهذا يمكن اعتباره أحد أنقى محاولات السينما السعودية في تقديم الحب كقيمة قائمة بذاتها، لا كقناع يخفي سؤالًا آخر.
رقم هاتف قديم
في تجربته القصيرة، قدّم علي سعيد، في رقم هاتف قديم، أحد أنقى أشكال التعبير عن الحب باعتباره أثرًا لا يُمحى، وذكرى لا تسعى إلى الاكتمال بقدر ما تنبض في الفراغ الروحي. لا يُخفي الفيلم طبيعته المهرجانية النخبوية، ولا يتملّق جمهورًا واسعًا، لكنّه مع ذلك ينجح في تكثيف التجربة العاطفية عبر لغة سينمائية تتجاوز السرد التقليدي، وتتّجه نحو السينما الشعرية، حيث يصبح كل مكوِّن فني في الفيلم، من العنوان، والإضاءة، والديكور، والحركة البطيئة، ونوعية الموسيقى، جزءًا من جسد واحد؛ حنين لا يُقال بل يُرى.
الفيلم القصير، إذًا، لا يُقاس بمحدوديته الزمنية، بل بما يحتويه من كثافة، وقدرة على فتح مساحات شعورية داخل المتلقي. ولعل استلهام العنوان من قصيدة الشاعر العراقي مظفر النواب -دون التورّط في تمثيل القصيدة حرفيًا- يقدّم إشارة ذكية إلى ما يطمح إليه الفيلم، أن يحضر الشعر كتلميح لا كتوظيف مباشر، وأن تُستحضر التجربة الوجدانية لا كاقتباس، بل كروح عامة.
هل للفيلم سؤال موضوعي آخر غير الحكاية الظاهرة؟ الإجابة بكل وضوح: لا. ففيلم رقم هاتف قديم وفيّ لسؤاله الوحيد، الحب. لكن ليس الحب كعلاقة حية، بل كذكرى بعيدة، وكظلّ يتردد على خط مهجور. الفيلم كذلك لا ينشغل بقضايا اجتماعية ولا يصدر أحكامًا ولا يورّط المشاهد في خطاب نقدي مبطن، بل يكتفي بأن يهمس له بسؤال الحنين. بلا مزاحمة، ولا تصعيدات فكرية أو رمزية. وهو بهذا ينجح في إبقاء الحب في مركز الحكاية دون الولوج في مساحات التعالي الفكري.
تبرز حساسية الفيلم في كونه لا ينتمي إلى الواقع بالمعنى التسجيلي، بل يصنع واقعه الخاص، واقعًا يُعيد تكوين الماضي كما تحتفظ به الذاكرة، من طراز السيارة، إلى تصميم الأثاث، إلى الإضاءة الخافتة، والمباني التي تشبه زمنًا اختفى، ومن ملابس البطل، إلى الموسيقى التصويرية التي تهمس أكثر مما تُعلن، كل هذه العناصر سعت إلى أن تصف زمانًا محددًا في الذاكرة.
وهذا الإخلاص للذاكرة العاطفية، هو ما يجعل الفيلم أمينًا، لا لواقع خارجي، بل لواقع داخلي يسكن صانع الفيلم، وكأن الزمن الذي يدور فيه فيلمه ليس خطّيًا، بل دائري، يعود دومًا إلى لحظة الاتصال بذلك الرقم، الذي لم يعد أحد يجيب عليه.
الفيلم، في اختياره للرمزية الخفيفة، وللسرد البصري، يقدم نموذجًا ناضجًا لسينما لا تشرح، بل تلمّح. وهو بذلك يخدم ثيمة الحب بأعلى درجات الجمالية، ويجعلها تحضر كأثر باقٍ، لا كعاطفة راهنة.
في المحصلة، رقم هاتف قديم لا يسعى إلى تمثيل قضية، ولا إلى تأريخ لحظة اجتماعية معينة، بل يُغني عن ذلك كله بتقديم الحب كما يسكن الذاكرة، مشوشًا، هادئًا، مؤلمًا، وصافيًا في الوقت ذاته.
في الختام
من خلال التجارب السينمائية السعودية السابقة، والمتباينة زمنًا وأسلوبًا، بدا الحب لا بوصفه حكاية تُروى، بل بوصفه مِرآة مزدوجة، مرآة يطل منها الفرد على هشاشته ورغبته، وأخرى تعكس تقاطعه مع مجتمع يُراقب ويقيّم ويصوغ الحدود. في بركة يقابل بركة، كان الحب مُتواريًا خلف خطاب اجتماعي ناقد، أقحم العاطفة في سياق الرفض الفكري، ما أدى إلى انفصال جزئي بين الشكل والمضمون. أما حد الطار، فتنحى عن الثقل الرمزي، واحتفى بالحب كحكاية واقعية تُصاغ بجماليات متقشّفة لكنّها حقيقية، ومؤثرة بحبكتها السردية المشدودة. في حين قدّم رقم هاتف قديم تجربة تأملية في الحنين، تُجسّد الحب لا في حضوره، بل في فقدانه، ليصبح رقم الهاتف المهجور استعارة عن المسافة والحنين.
كل فيلم من هذه الثلاثية، أجاب بطريقته عن أسئلة المقال المنهجية، ووسّع فهمنا للحب داخل السينما السعودية، مرة كاحتجاج، ومرة كاعتراف، ومرة كذاكرة.