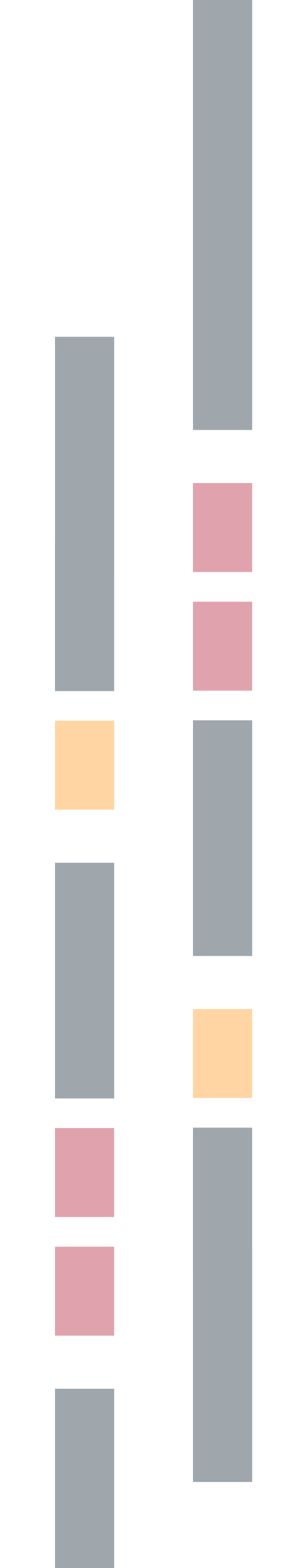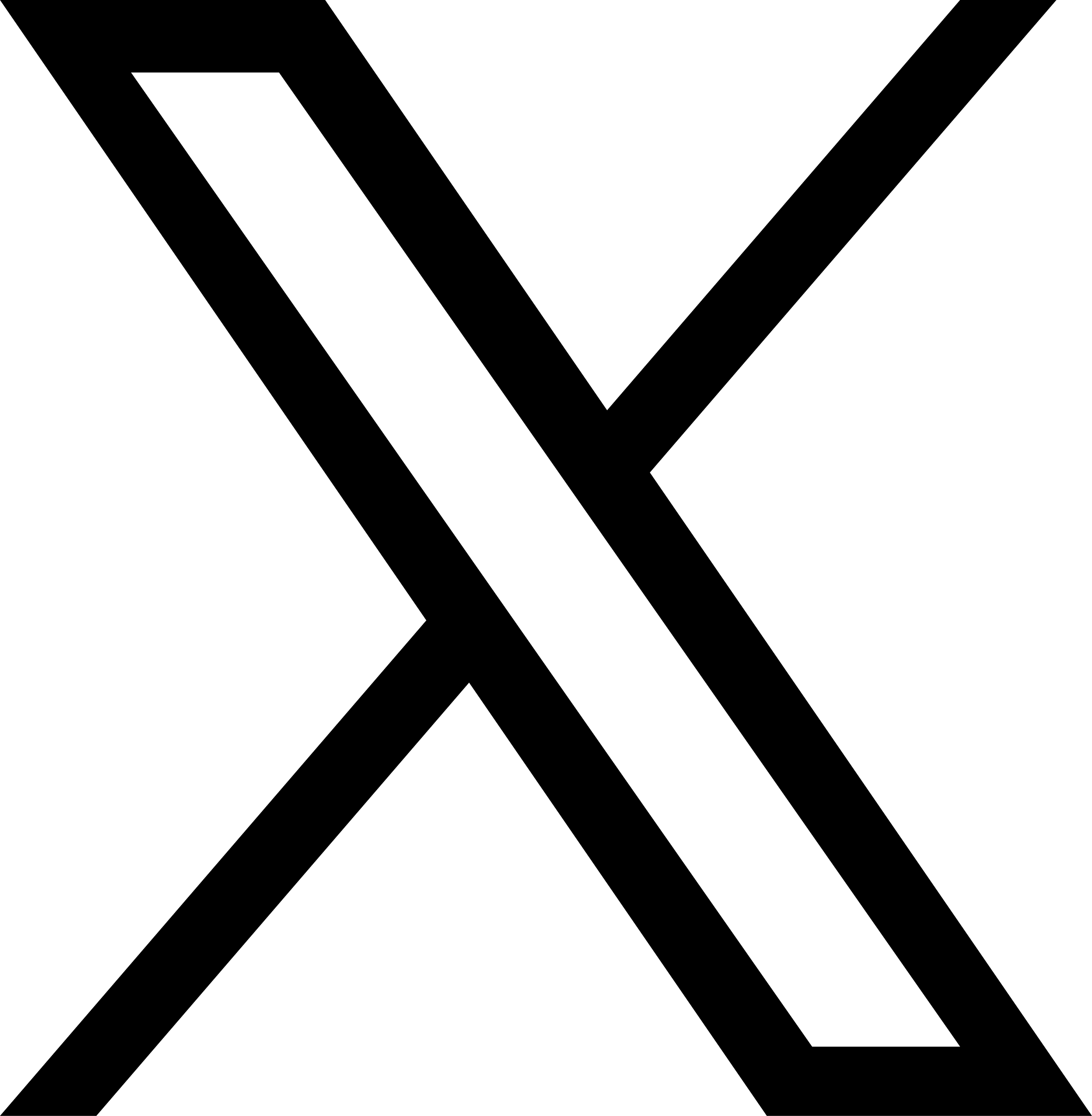شارك
لا يمكن مشاهدة فيلم »سوار« للمخرج أسامة الخريجي دون الشعور بأننا أمام مسرحية درامية مثالية لفكر الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا (1930-2004). يروي الفيلم قصة تبديل رضيعين، سعودي وتركي، في مستشفى بنجران، يتجاوز طرح السؤال التقليدي حول »الطبيعة مقابل التنشئة« إنه، سواء عن قصد أو عن غير قصد، يفكك الأسس ذاتها التي تقوم عليها مفاهيم الهوية والأصل والانتماء والاسم الخاص.
إن قراءة الفيلم عبر عدسة دريدا لا تقلل من شأنه كدراما إنسانية مؤثرة، بل على العكس، ترفعه إلى مستوى تحقيق فلسفي عميق في استحالة الحضور النقي، وجراح الهوية التي لا تندمل، وسياسة العلامة التي تكتب مصائرنا.
إن الخوض في فكر دريدا يقتضي الاستعداد لمواجهة شبكة معقدة من المفاهيم التي تتحدى الأسس التقليدية للفلسفة الغربية، فلا يمكن فهم أعماله عبر تناول مفاهيمه بشكل معزول، بل يجب قراءتها كمنظومة متكاملة تعمل بشكل متضافر على تفكيك ما أسماه »ميتافيزيقا الحضور metaphysics of « presence؛ وهي النزعة الفلسفية الممتدة من أفلاطون إلى هوسرل، التي تمنح الأولوية للمفاهيم التي تبدو نقية، وحاضرة بذاتها، وغير قابلة للوساطة، مثل الحقيقة، والأصل، والوعي الذاتي. في قلب هذا المشروع التفكيكي، تبرز ثلاثة مفاهيم تبدو متباعدة للوهلة الأولى، لكنها عند دريدا تشكل ثالوثًا مفاهيميًا متكاملًا: الاسم الخاص، والهوية، والختان.
أصل مستحيل
يرى دريدا أن المعنى لا يوجد بشكل ثابت في أي علامة (كلمة، إشارة، توقيع)، بل يتشكل من خلال »الإرجاء« différance، وهو مصطلح يجمع بين معنيين أساسيين: الاختلاف والتأجيل. فالكلمة تكتسب معناها من خلال اختلافها عن الكلمات الأخرى في نظام اللغة، وهذا يعني أن هويتها لا تكون حاضرة بالكامل أبدًا، بل تُؤجّل وتتشكل من خلال آثار الكلمات الغائبة. كما يرى دريدا أن التوقيع، الذي يُفترض أنه علامة على حضور الشخص، لا يمكن أن يؤدي وظيفته إلا بفضل قدرته على التكرار في غياب صاحبه. فالتوقيع يعتمد على إمكانية التعرف عليه وتكراره، وهذا التكرار هو ما يفصله عن حضور الموقّع الأصلي ويجعله علامة تعمل في غيابه. هذا الانفصال، أو »الجرح«، هو ما يمنح العلامة استقلاليتها ويجعلها قابلة للتداول، وهي فكرة أساسية سيتم ربطها لاحقًا بالختان.
ويُفكك دريدا فكرة أن الاسم الخاص أساسٌ ثابتٌ للهوية. فمن خلال تحليل دلالات الكلمة الفرنسية "le nom propre"، يوضح أن الاسم ليس ملكية شخصية خالصة، بل جزء من نظام أوسع من اللغة والقانون والملكية. كما أن الاسم لا يسبق الذات، بل يُمنح لها من قبل الآخرين (كالعائلة أو المجتمع)، مما يمثل »محوًا «أصليًا لخصوصية الفرد منذ البداية. بالتالي، فإن الاسم ليس تعبيرًا عن جوهر الذات، بل »جرح رمزي أول«، يمثل نقشًا لقانون الآخر على الفرد. هذا النقش هو ما يؤسس الذات في سياق تاريخي وقانوني معين، ويربطه دريدا بشكل مباشر بطقس الختان، الذي يُعتبر فعلًا رمزيًا أساسيًا يُلصق بالذات هوية خارجية
ويستخدم فيلسوف التفكيك الختان كاستعارة مركزية لمشروعه الفلسفي. فهو لا يراه طقسًا دينيًا فحسب، إنما فعلًا فلسفيًا يجسد منطق العلامة والجرح. فالختان »توقيع مقدس« يُنقش على الجسد، يؤسس الانتماء للمجتمع من خلال فعل القطع والانفصال عن حالة طبيعية مفترضة.
هنا مفارقة عميقة، حيث إن الختان حدث فريد وغير قابل للتكرار بالنسبة للجسد الفردي، وفي الوقت نفسه علامة قابلة للتعميم على مستوى المجتمع. هذه المفارقة تعكس بنية التوقيع والأثر: فالهوية تنشأ من حدث فريد وصادم (الجرح) ولكن معناها وتداولها يعتمدان على أثر عام قابل للتكرار (الندبة). ويزيد من أهمية هذا التحليل التشابه بين الكلمة العبرية »ميلة« التي تعني »الختان« و»الكلمة«، مما يمحو التمييز بين النقش المادي على الجسد والنقش الرمزي للغة، ويجعل كل ختان شكلًا من أشكال الكتابة.
توقيع فاشل وجرح أصلي
لا يمكن قراءة فيلم »سوار «باعتباره مجرد عمل سينمائي، بل يجب النظر إليه بوصفه بيانًا ثقافيًا وصناعيًا ذا دلالات عميقة. فاختياره ليكون أول فيلم روائي طويل يفتتح الدورة الحادية عشرة من مهرجان أفلام السعودية تحت محور »سينما الهوية«، يرفعه مباشرة من خانة الإصدار التجاري المعتاد إلى مصاف المؤشر الذي يقيس طموحات الأمة السينمائية. لم يكن اختيارًا عفويًا بقدر ما بدا قرارًا مدروسًا من قبل منظمي المهرجان، على رأسهم الشاعر أحمد الملا؛ لعرض نموذج سينمائي محدد: سينما متجذرة في الهوية المحلية، وفي الوقت نفسه تمتلك القدرة على مخاطبة قضايا إنسانية عالمية.
تبدأ الكارثة في الفيلم من علامة، من »توقيع« يُفترض أن تضمن الحضور الخالص والهوية النقية: السوار الطبي الذي يوضع على معصم المولود. الاسم الخاص" في أبسط وأكثر صوره المادية، علامة تهدف إلى ربط جسد ما بهوية محددة بشكل لا يقبل الشك، ومنع أي التباس. إنه يمثل وعد النظام بضمان الأصل.
لكن في »سوار«، يصبح هذا التوقيع هو موقع الكارثة، حيث يفشل في أداء وظيفته بخطأ بشري عارض، سرعان ما يكشف عن الطبيعة البنيوية لكل العلامات. فالتوقيع، كما يرى دريدا، يعتمد في جوهره على قابليته للتكرار؛ أي قدرته على أن يُعاد إنتاجه في سياقات مختلفة. ولكونه قابلًا للتكرار، فهو بالضرورة قابل للانفصال عن أصله ونيته، وقابل لأن يُطعّم في سياق خاطئ. السوار الذي وُضع على معصم الطفل السعودي كان قابلًا بنيويًا لأن يوضع على معصم الطفل التركي، وهذه الإمكانية الكامنة في كل علامة هي التي فجرت المأساة.
لذلك، فإن السوار ليس مجرد رمز لهشاشة الأنظمة البيروقراطية، بل »جرح« بالمعنى الدريدي الدقيق. »القطع« الذي يفصل الهوية عن أصلها المفترض، ويطلقها في سلسلة لا نهائية من الإرجاء. إن الخطأ في التوقيع هو الجرح الأصلي الذي يجعل من الهوية سؤالًا مفتوحًا ومؤلمًا بدلًا من أن تكون جوابًا مغلقًا ومريحًا. إنه يمثل اللحظة التي تنهار فيها أسطورة الأصل النقي، وتُكشف الهوية على حقيقتها: بناء متزعزع، أثر لأثر، وليس حضورًا كاملًا.
عنف ميتافيزيقا الحضور
إذا كان السوار توقيعًا فاشلًا يفتح جرح الهوية، فإن فحص الحمض النووي (DNA) الذي يكشف الحقيقة بعد أربع سنوات يمثل الإغراء الأكبر لـ »ميتافيزيقا الحضور«، ويُقدَّم في السرد بوصفه الحقيقة النهائية، الأصل الذي لا يمكن دحضه، والكلمة الفصل التي تعيد كل شيء إلى مكانه »الصحيح« و»الطبيعي«. الإيمان بوجود مركز ثابت، وأصل نقي، أو »متعالٍ« مدلول يمكن العودة إليه لتأسيس المعنى ووضع حد للعبة الاختلافات.
لكن الفيلم، في معالجته الدرامية الحساسة، يفكك هذا الادعاء بقوة؛ فـ »حضور« الحقيقة البيولوجية لا يجلب السكينة أو الحل، بقدر ما يمارس عنفًا هائلًا، يمزق النسيج العاطفي والاجتماعي واللغوي الذي تشكل على مدى سنوات من التربية والحب. هذا العنف يكشف أن ما نسميه »الأصل« (الدم) ليس أساسًا سلميًا ومستقرًا، بل قوة تفكيكية قادرة على محو »الأثر« (trace) الذي خلفته سنوات من الحياة المشتركة. إن سعي الشخصيات وراء حقيقة الدم هو بحث عن مركز مفقود، لكن ما يجدونه ليس طمأنينة الحضور، إنما فوضى الاختلاف وعذاب الاختيار المستحيل. هنا، يطرح الفيلم السؤال: هل الهوية بالدم أم بالتربية؟ لكنه من منظور دريدا، يوضح أن هذا السؤال نفسه فخ ميتافيزيقي. فالهوية ليست هذا أو ذاك، لكنها التوتر الدائم بينهما، »الأثر«الذي يتركه أحدهما على الآخر، الندبة التي لا يمكن محوها والتي تشهد على الجرح الأصلي.
هوية مفروضة من الآخر
كل طفل في الفيلم يحمل اسمًا لا يتوافق مع »حقيقته «البيولوجية. هذا الاسم، الذي يُفترض أنه »خاص«، هو في الحقيقة ليس ملكًا له، بل هو علامة فرضها عليه الآخر (الأسرة التي ربته، الثقافة التي نشأ فيها). إنه يجسد فكرة دريدا عن »المحو الأصلي للاسم الخاص«، حيث إن الاسم لا يعبر عن جوهر فريد، بل يدرج الفرد في نظام من اللغة والثقافة والقانون يسبقه ويؤسسه. الطفل السعودي الذي يحمل اسمًا تركيًا، والعكس، يعيشان تجسيدًا حيًا ومؤلمًا لهذا الاغتراب التأسيسي الذي يرى دريدا أنه شرط كل هوية.
يمكننا أن نذهب أبعد من ذلك ونقرأ تجربة كل طفل كشكل من أشكال »الختان الرمزي، وهو المفهوم الذي اعتبره دريدا مفتاحًا لمشروعه الفلسفي بأكمله. فكل طفل قد »قُطع «عن أصله البيولوجي، ونُقش على جسده ووعيه قانون وهوية الآخر. لقد تم »ختانه« في ثقافة ليست ثقافته »الأصلية«؛ فالطفل السعودي تم وسمه باللغة التركية والعادات التركية، والطفل التركي تم وسمه باللهجة النجرانية والثقافة السعودية. هذا »الجرح «هو ما شكل هويته الفعلية والمحسوسة.
وعندما تأتي حقيقة الحمض النووي، فإنها لا تشفي الجرح، بل تفتحه من جديد، وتضع الطفل في مواجهة ندبته الأصلية. الهوية، كما يظهر الفيلم ببراعة، ليست امتلاءً أو جوهرًا نقيًا، بل هي أثر لجرح، لقطع، لـ »ختان «رمزي يؤسس الانتماء من خلال الانفصال، ويجعل الذات مدينة للآخر الذي وسمها.
تفكيك الصورة: حواجز تترجم »الجرح«
لا تتجلى الرؤية »التفكيكية «فقط في السرد، بل في التكوين البصري للفيلم نفسه، إذ وظّف الشريط اللغة السينمائية ببراعة لترجمة مفاهيم »الفصل« و»الابتعاد« وغياب الحضور »النقي« إلى صور ملموسة. خاصة حين يلاحظ المشاهد تكرار وجود الحواجز الزجاجية، سواء كانت فواصل المكاتب، نوافذ السيارات، أو حتى زجاج المنازل. مفردات بصرية تعكس الحالة النفسية والعلاقات بين الشخصيات. حواجز شفافة، تسمح بالرؤية لكنها تمنع التواصل الحقيقي، مما يرمز إلى أن الشخصيات ترى بعضها وتعيش معًا، لكنها تفصلها »جدران« غير مرئية من الغموض والشك، معززًا فكرة أن »الآخر« قريب جدًا لكنه بعيد في آن واحد.
كذلك اختار الخريجي إبقاء الشخصيات بعيدة عن بعضها في كثير من المشاهد، وعدم استخدام لقطات مقربة (close-ups) بكثافة، فقلما تلمس الشخوص بعضها، خاصة »الرجلين ووزوجتيهما«، أو تحتضن بعضها إلا نادرًا. تباعد الجسدي يعكس تباعدًا عاطفيًا ووجوديًا، فهم ليسوا قريبين بالمعنى الجوهري، لأن »الخيط «الذي يربطها، الدم، انقطع أو تبدل، مما يتركها معلقة في حالة من عدم الانتماء.
من جهة، أدار الخريجي الممثلين بطريقة تعكس الرؤية التفكيكية. يبدو أنه لم يطلب منهم أداءً عاطفيًا مبالغًا فيه، بل أداءً مقيدًا ومتحفظًا، يركز على التفاصيل الدقيقة في تعابير الوجه ولغة الجسد. أداء يوسف ديميروك وفهيد الدمناني: الممثلان اللذان قاما بدور الأبوين قدما أداءً يجسد بشكل ممتاز »عنف ميتافيزيقا الحضور«. الدمناني، بدور الأب السعودي، لا يظهر غضبًا صريحًا، بل حالة من الصدمة الداخلية والبحث عن معنى مفقود. أما ديميروك، بدور الأب التركي، فيقدم أداءً متزنًا يعكس الصراع بين حبه للطفل الذي رباه وحقيقته البيولوجية المكتشفة حديثًا. أداؤهما لا يحل الصراع، بل يجسده في كل نظرة وحركة، مما يترك المشاهد في حالة من عدم اليقين.
سينما الأثر والوعد
إن الأسلوب الإخراجي لأسامة الخريجي، ينسجم بشكل لافت مع الأخلاقيات التفكيكية. فاللغة البصرية التي »تحاكي عين المراقب عن بعد« وتتجنب الوقوع في فخ الميلودراما أو إصدار الأحكام، هي بمثابة تطبيق سينمائي لمبدأ وضع المفاهيم قيد المحو/ الكشط sous rature).) المخرج لا يحاول فرض حل، أو استعادة »النظام الصحيح«، أو إخبارنا من هو الأب »الحقيقي« أو الابن»الحقيقي«. بدلًا من ذلك، هو يضعنا كشهود على استحالة الحل، على المأزق الذي لا مفر منه. إنه يرفض إغلاق الجرح، وبدلًا من ذلك، يستكشف أبعاده المؤلمة.
هذا الموقف الأخلاقي يتجلى أيضًا في قرار المخرج تعديل النهاية بعد لقائه بعائلة حقيقية مرت بتجربة مماثلة، حيث حذف مشهدًا يظهر فيه أب يتخلى عن الطفل الذي رباه. هذا القرار ليس مجرد تليين للدراما، بل هو اعتراف بأن منطق »الأصل« والدم، إذا تم اتباعه حتى نهايته المنطقية، يؤدي إلى عنف غير إنساني. إنه اختيار واعٍ للبقاء في منطقة التوتر، في فضاء »الأثر« والمسؤولية تجاه الآخر، بدلًا من الاستسلام لوهم الحضور النقي.
في النهاية، يرفض فيلم »سوار« تقديم إجابة سهلة، وهذا هو مصدر قوته الفلسفية العميقة. إذ لا يعيد الطفل السعودي إلى »أصله «والتركي كذلك في خاتمة تعيد تأسيس النظام الميتافيزيقي. بل يترك العائلتين والطفلين في مساحة »عتبية« liminal، وهو وصف لحالة من عدم اليقين والغموض، تنهار الهويات السابقة ولم تتشكل بعد الهويات الجديدة، مساحة تكون فيها الأطر المألوفة غائبة، مما يفتح المجال لإعادة التفكير في الذات والعالم.
تبقى العائلتان في حالة تفاوض دائم مع هوياتهم المجروحة، وتظلان على علاقة وثيقة. مجسدين ما يسميه دريدا »أثر الآخر في الذات«، حيث لا يمكن لأي هوية أن تكون نقية، بل هي دائمًا هجينة، وموسومة بالآخر، ومؤلفة من طبقات من الآثار المتناقضة.
»سوار« ليس فيلمًا عن إيجاد الهوية، لكنه عن استحالة إيجادها ككيان ثابت ومكتمل، أو بعبارة أخرى فيلم عن الهوية كدوران دائمCircumfession حول جرح لا يمكن إغلاقه أو فهمه بالكامل، دوران حول الذات نتيجته الحتمية »الدوار«. وبهذا المعنى، يصبح الفيلم نفسه »توقيعًا« للسينما السعودية الجديدة التي يبحث عنها مخرجه: سينما »صادقة« لا تدعي امتلاك هوية خالصة، بل تعترف بأن هويتها تتشكل في علاقتها المعقدة مع الآخر، وفي جراح تاريخها، وفي الوعد المفتوح دائمًا بما هو آتٍ.