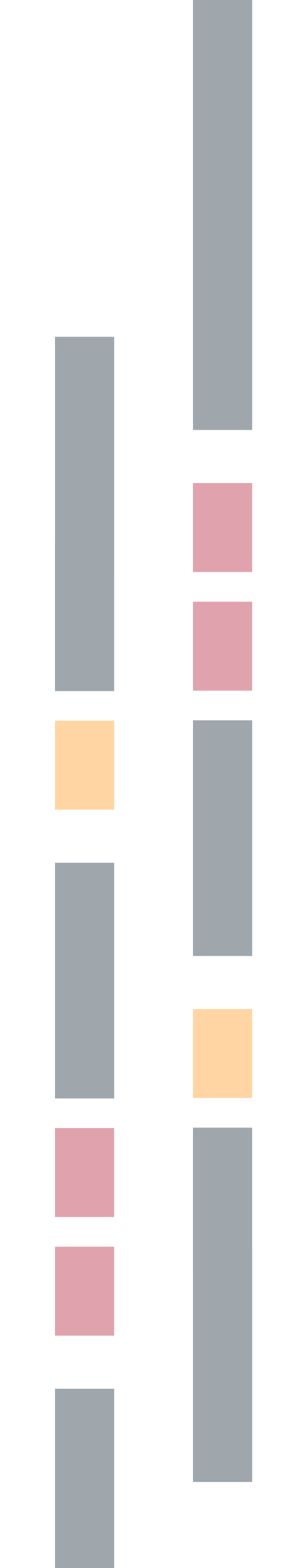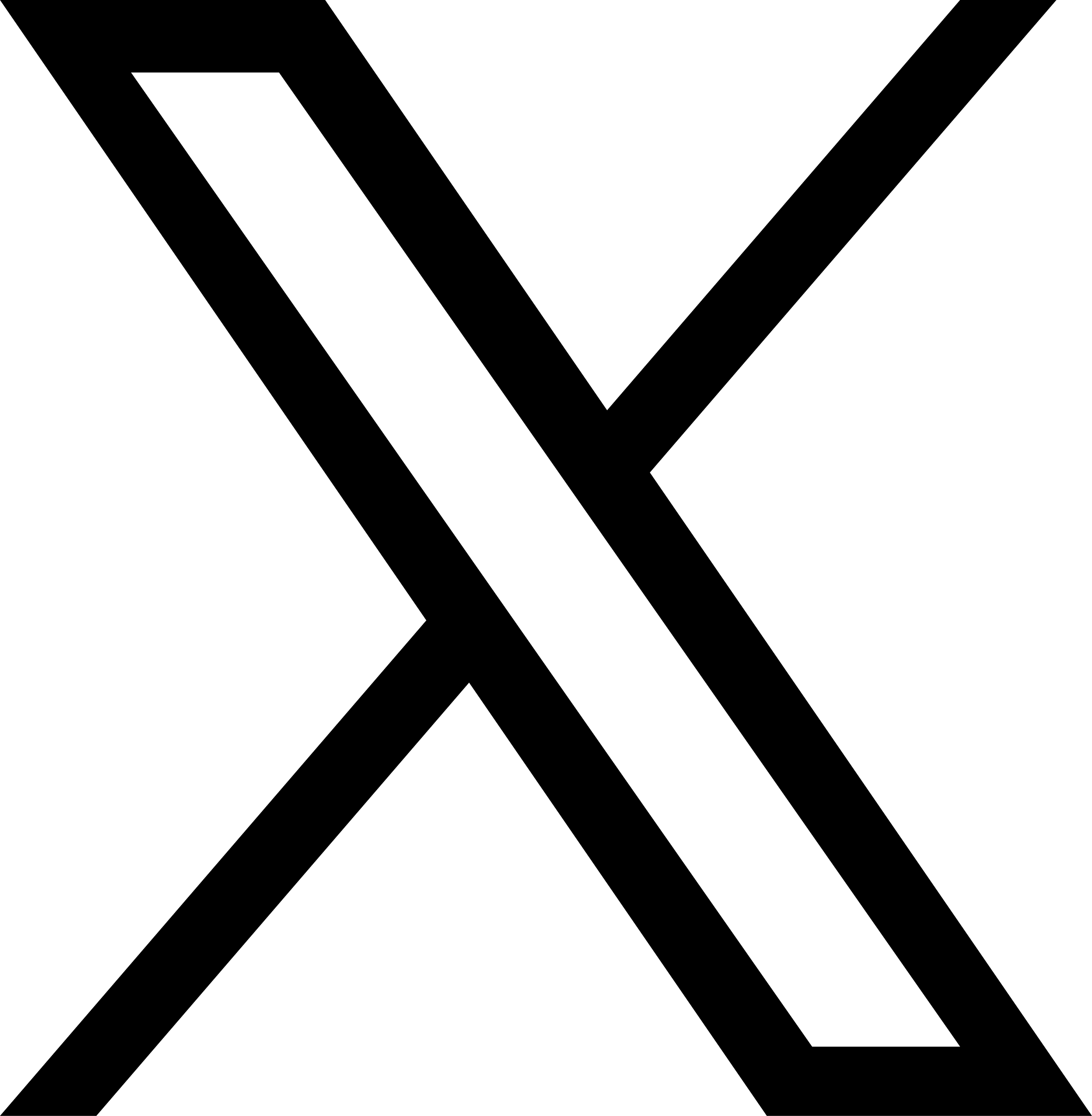شارك
«لقد اقتحمنا السينما كما اقتحم رجال الكهوف قصر لويس الخامس عشر». - جان لوك غودار
في وقتٍ كانت فيه السينما بأهميةِ الخبز، قِيل إن غودار أَعلن عند عودته إلى باريس: «سأكون كوكتو الجديد». ومن بوابة النقد السينمائي، بآلافِ الأفلام التي شاهدها من أرشيف السينماتيك الفرنسي، بمقالاتهِ الجدليَّة التي ناقشت جودة الأفلام، بخمسةِ أفلامٍ قصيرة، مُتسلِّحًا بشغفه وثقافته، مُتخطيًا الحرَس القديم في صناعة السينما بجرأةٍ ولا مبالاةٍ بالأسلوب التقليدي للنظام الكلاسيكي نقل الصناعة من الاستديو إلى الشارع، وصنع أفلامًا فنية مقاليَّة أضحت بعدها كل الأفلام الجديدة قديمة فجأة. الأفلام التي حَلم بها خلَّدت المدينة والمتاحف والمكتبات والنهر، جنبًا إلى جنب مع المقاهي المُمتلئة بالموسيقى.
إدراك غودار ورِفاقه من منظورٍ نقديّ لـ«نظريَّة المؤلف» ساهم في اعتبار المخرج القوة الإبداعية المركزية ومصدر الشكل والمعنى في الفيلم؛ ما خلَق فِهمًا جذريًّا جديدًا مُهمًا في الصناعة أضفَى الشرعِيَّة على الدراسة الجادة للسينما؛ إذ اُعتبرت الأفلام إبداعات شخصية بالمقام الأول وطريقة إنتاجها أشبه بكتابة رواية أو نَظْمِ قصيدة أو رسم لوحة فنية أكثر من كونها إنتاجات تجارية لعملٍ ثقافي. فقد ذكر الناقد ويليام ڨي كوستانزو -في كتابه «السينما العالمية من منظور الأنواع السينمائية»- أن غودار لم يرَ فرقًا ما بين صانع الفيلم وكاتب النقد على الإطلاق، فقد قال عام 1962: «عندما كنتُ ناقدًا سينمائيًا أعتبرتُ نفسي صانع سينما. اليوم، ما زلتُ أعتبر نفسي ناقدًا سينمائيًا أكثر من أيّ وقتٍ مضى؛ فبدلًا من كتابة مراجعة نقدية فأنا أُخرج فيلمًا». ولتأكيد «الموضوعية السينمائية» شمل إعادة اختراع السينما من جديد ضخِّ شيء من الحياة في الفيلم، وإمكانية مشاهدته ليس بناءً على التقنيات فحسب بل على التكوين الذي يُمكِّن المتفرج مِن معرفة مَن صنع الفيلم مَن كان المؤلف، في وقتٍ كان يُنظر فيه إلى المخرجين على أنهم -ببساطة- ليسوا أشخاصًا يَحظون باحترامٍ كبير ولكنهم الأشخاص الذين صوَّروا الفيلم. بعبارةٍ أخرى، الأسلوب السردي للفيلم الذي يشاهده المتفرج كان أكثر أهمية من التكوين الإبداعي للفيلم ذاته. والنظرية التي حمل مِشعَلها المُنظِّر والناقد السينمائي أندريه بازان -المؤسس المُشارك لمجلة «كاييه دو سينما»- هي من بدأت في تطوير الأفكار السينمائية الإبداعية لجيلٍ جديد شابّ من المخرجين بمعداتهم وميزانياتهم الضئيلة (كلود شابرول، فرانسوا تروفو، آلان رينيه، جان لوك غودار، جاك ريفيت، آغنيس فاردا، جاك ديمي، لويس مال، إريك رومير)؛ إذ أصرَّ على أن الأفلام يجب أن تكون أخلاقية كونها مشاريع شخصية تحدد رؤية المخرج الفردية التي تعكس معتقداته وأفكاره وثقافته حول الفنون. قال جان رينوار مُؤكدًا: «منح بازان براءة الاختراع للسينما؛ كما توَّج شُعراء الماضي ملُوكهم». رؤيته التي آمن بها هؤلاء النقاد -بمقالاته ومجلته ونادِيه السينمائيّ الذي كان يُديره في متحف «ميزون دي ليتر»-؛ جعلت الجمهور يُدرك أن الفيلم الذي يشاهدونه ليس واعيًا بذاته فحسب بل يوجد «المخرج» واضح ومحدد للغاية خلف السِّتار.
بهذه الروح الفرنسية التنويريَّة جاء فيلم «منقطع الأنفاس Breathless» أو «اللاَّهث» عام (1960) كخطوة صريحة أولَى لبدءِ عهدٍ جديد في صناعة السينما؛ باعتباره الصورة الحقيقية لانتقال السينما من الكلاسيكية إلى سينما ما بعد الحداثة. والمناخ كان ملائمًا ومساندًا لظهوره؛ إذ شهدت أوائل ستينيات القرن العشرين ظهور الحركات الثقافية والفنية المُضادة التي جاءت كردة فعل تجاه المعايير السائدة في المجتمعات وقدَّمت بدائل ثقافية وفنية جديدة. وكردة فعل سينمائية أصيلة قوية ضد «سينما الجودة» كان هناك إجماعٌ على أن الفيلم كسر كل قواعد الإنتاج دفعةً واحدة، وأصبح فنًا بديلاً قائمًا بذاته ما زال يُدرَّس في الجامعات والمعاهد السينمائية إلى اليوم. إذ كما قال غودار: «هناك الثقافة؛ وهي القاعدة. وهناك الاستثناء؛ وهو الفن»، أدرك المتفرج -للمرة الأولى- أن هناك شيئًا مختلفًا؛ أنه قد تمَّ توجيهه عمدًا إلى اتصال العين الذي يقابل الكاميرا المَحمولَة باليد، والأسلوب البصري الجريء، والحوار الغير مُتزامن، والاستخدام غير التقليدي للقفزات الانتقالية المفاجئة اللاً منهجية بين المشاهد «jump cuts»، والفجوة الزمنية المحسوسة ما بين اللقطات، وتداخل الموسيقى التصويرية مع الأصوات، ومقاييس تقنية وجمالية جديدة في الشكل والمونتاج، حيث استخدمت سيسيل دوكيغيز تقنيات التأمل الذاتي في المونتاج، التي تدعو إلى لفتِ انتباه المتفرج إلى عملية صناعة الفيلم نفسها من خلال طمس الحد الفاصل ما بين الخيال والواقع: الشخصيات التي تخاطب الكاميرا مباشرة، ومعدات الفيلم المرئية بجانب ظهور غودار نفسه في اللقطات، وإشارات إلى أفكار أو مواقع أو مخرجين آخرين داخل القصة. كتب غودار في مجلة «كاييه دو سينما» عام 1963: «فيلم منقطع الأنفاس، من ذلك النوع من الأفلام التي يحدث فيها كل شيء، إذ يدور الفيلم على أن كل ما يفعله الناس يُمكن أن يتجسَّد فيه. في الواقع، كانت نقطة انطلاقي وما أردته هو أن أتناول قصة تقليدية على نحوٍ مُختلف؛ أن أُعيد خلق كل ما فعلته السينما، أن أمنح إحساسًا بتجربة تقنيات صناعة السينما للمرة الأولى كما لو تمَّ ابتكارها للتَوّ». ومع كل هذه العناصر الجديدة والمُتغيِّرة ظلَّت باريس -ما بعد الحرب العالمية الثانية- الحيويَّة كلوحة فنية مُمتلئة بالضوء، العنصر الثابت الوحيد في أثناء التصوير (شارع الشانزليزيه، شارع جورج الخامس، شارع فيرنيه، قوس النصر، سينما «نابليون» في شارع الجيش الكبير، سينما «ماك-ماهون» في شارع ماك-ماهون، كاتدرائية «نوتردام»، شارع سان جيرمان، شارع مونبارناس)؛ إذ حرَّر غودار الكاميرا من القيود النظرية والحركية التقليدية المَنوطة بها؛ ففي الأوقات التي لا تُصبح فيها الكاميرا شخصية بحد ذاتها؛ تتبع بقية الشخصيات التي تُركت لها حرية الحركة بشكلٍ طبيعي داخل مواقع التصوير المفتوحة بديكوراتها واكسسواراتها غير المُكلِفة. مكتفيًا بنظريته الحديثة المؤطَّرة بموسيقى مارتيال سولال «الجاز»، التي تتعلَّق بحركة الارتجال أكثر من كونها فنًا قائمًا بحد ذاته، الطُرق الجديدة التي تُفكِّك اللحن ثمّ تتوسع فيه؛ ما ناسب الطبيعة التأملية الشاعرية للفيلم. مُبتعدًا بذلك عن قواعد ولوائح النقابات الصارمة لمعايير إنتاج المدرسة السينمائية الأميركية الكلاسيكية والفرنسية المصقولة التي جاء غودار لتدميرها بقوله الشهير: «يَكفي مسدس وفتاة لصناعةِ فيلم».
كانت بداية الطريق إلى تحرُّر أبطاله من القيود التي تُلجم تطلُعاتهم نحو التحرُّر؛ قصةٌ مغمورة وُجِد في بُنيتها الفرصة المُنتظرة دومًا. ففي عام 1952 كان هناك شابٌّ فرنسيّ يُدعى «ميشيل بورتاي» واقعٌ في حبِّ صحفية أميركية تدعى «بيفرلي لينيت»، يسرق سيارة لزيارة والدته المريضة في «لوهافر» وينتهي به الأمر بقتل الشرطي «جريمبيرغ»، وفيما يَختبئ في باريس تُسلِّمه حبيبته إلى الشرطة في نهاية المطاف. فرانسوا تروفو هو مَن قرأ القصة أوَّلاً في مجلة «الأخبار المُوجزة» فقام بمعالجتها رفقة شابرول ثمّ سلَّمها إلى غودار. في الأساس شُهرتهما في الوسط السينمائي في ذلك العام مَن ساعدت في لعب دورٍ مساندٍ في الفيلم؛ ففي أعقاب صدور: «سيرج الوسيم (1958)» لشابرول، و«400 ضربة (1959)» لتروفو، تحدَّثا إلى المنتج جورج د.بيوريغار في مهرجان كان السينمائي الدولي 1959 لتأييد غودار كمخرج. وبمنحهِ الضوء الأخضر اجتمع مع الطاقم الغير مُصرَّح في مقهى «نوتردام»، وكتب الحوارات في دفتر تمارين، ولم يسمح لأحدٍ بقراءة ما كتبه أو ما يكتبه تزامنًا مع التصوير، ويكتفي بمنح الممثل سطرًا أو ما يحتاجه في المشهد مع بروفات قصيرة قبل التصوير مباشرة حتى تنفد أفكاره. يُكرِّر ذلك طيلة أيام التصوير التي تتراوح ما بين 15 دقيقة إلى 12 ساعة. جدول التصوير غير المُنتظم هذا كان «أزمة الفيلم» لدرجة ادِّعاء كورتار بأن المنتج د.بيوريغار دخل في شِجارٍ بالأيدي مع غودار حين صادفه في أحد المقاهي بعد أخذه إجازة مَرَضِيَّة. لكن القصة التي تمَّ ارتجالها تقريبًا لم تختلف جذريًّا عمَّا كتبه تروفو باستثناء مَشهدين، أحدهما: «غرفة الفندق» الذي أصبح أطول في نسخة غودار، والذي عُد المشهد الأهم والجوهريّ في «منقطع الأنفاس» بحسب النقاد؛ لأن غوادر قال كل شيء يريده وما سيكون عليه الفيلم، إضافة إلى ابتكاره أسلوب «القطع المُتقطع»، أيّ القطع القفزي المُكثف الذي استخدمه طوال المشهد حيث تضمن حركة وحوارات عرضية وقصّ كل ما هو مُمل داخل المشهد ذاته دون المساس بجوهره، واعتماده على الضوء الذي يتسلَّل من نافذة فندق «دي سويد» الذي أقام فيه غودار أوائل خمسينيات القرن الماضي وأصرَّ على التصوير فيه. عن هذا المشهد الملفوف في سحابة كتب الناقد روجر إيبرت مُتأملاً: «تقتبس باتريشيا من فوكنر: "بين الحزن والعدم، سأختار الحزن". يقول ميشيل إنه لن يختار شيئًا؛ "الحزن حلٌّ وسط". تقفُ أمام ملصق لرينوار لفتاةٍ صغيرة، وتسأل مَن الأجمل؟. يجلس ميشيل أسفل مُلصق لبيكاسو لرجلٍ يحمل قِناعًا. طوال هذا المشهد الطويل، وبشكلٍ مُحيِّر، يَرمي كلاهما سجائرهما المُهمَلة من النافذة». أمَّا الآخر، فقد كان المشهد الأخير في الفيلم وهو الأكثر إرباكًا وإثارةً للتساؤلات: «موت ميشيل» هل كان مقصودًا؟ هل هو تعبير عن الغضب لمحاولة نشر أسلوب الحياة الأميركية في باريس؟ هل سيطرة باتريشيا على ميشيل تُمثّل هيمنة السينما الأميركية على السينما الفرنسية؟ ولانعدام الإجابات عُد أحد أشهر مشاهد السينما، ونهاية يتم الإشارة إليها دومًا بكونها أقرب للكوميديا من التراجيديا رغم عُنفها. كان عدم التوافق الغير مُقنع هذا هو «مفاجأة الفيلم» والجانب الأكثر ثوريَّة في القصة. تصوير التناقض من خلال الأفكار والمواقف والعواطف التي لا تنسجم مع بعضها البعض والمشاهد التي تختلط فيها السعادة مع الكآبة. هذه الحالة التي لم تتعود عليها السينما منذ «وصول قطار إلى محطة لا سيوتا (1895)» للأخوين لوميير، أيّ منذ اختراع مفهوم السينما برمته في فرنسا ذاتها. وما أعجب النُخبة حينها هو هذه الطاقة المُذهلة للكوميديا السوداء التي بثَّها الفيلم بلا أيّ معنى. لكن تروفو اعتقد بأن تغيير غودار لمشهدِ نهاية الفيلم كان شخصيًا جدًا بالنسبة له: «في نصِّي ينتهي الفيلم بميشيل وهو يسير في الشارع بينما يلتفت إليه المزيد والمزيد من الناس ويُحدِّقون به؛ لأن صورته على جميع صفحات الصُحف، لكن غودار اختار نهاية أكثر عُنفًا لأنه بطبيعته أكثر حُزنًا مني».
الأسلوب الوثائقي لكاميرا المُصوِّر الحربيِّ راؤول كورتار (35 ملم، Caméflex Eclair) لم يكن له دور بارز في عكس كل ما يريده غودار بانسيابية على الشاشة فحسب بل ساهم في حلِّ مشاكله المادية أيضًا. ورغم الصوت المرتفع جدًا للكاميرا لدرجة أن جزءًا كبيرًا من الفيلم دُبلج في مرحلة ما بعد الإنتاج، إلا أن مراحل التصوير الثلاث كانت الأهم بالنسبة له: ما قبل التصوير، أثناء التصوير، وما بعد التصوير، يقول كورتار في حوارٍ له -مع «الغارديان»-: «كان غودار من النوع الذي يُخطط طويلاً قبل التصوير؛ تصل إلى موقع التصوير فتجده جاهزًا برؤيته، بينما وصلت أنتَ جاهزًا برؤيتك كمدير تصوير». وخلافًا للمخرجين أمثال هيتشكوك الذين سيقومون بترتيب جميع الأشياء تمامًا حتى اللحظات الأخيرة من تصوير المشاهد، تلتقط الكاميرا الغوداريَّة الارتجالية بأبعادٍ مختلفة وإضاءة طبيعية التعابير الساحرة والتلقائية لأبطال الفيلم: الفرنسي الرياضي جان بول بلموندو بقبعته وجواربه الحريريَّة وتقليده لتعابير وجه همفري بوجارت. كانت موهبة بلموندو التي لفتت انتباه غودار عندما كان ناقدًا وولعه ببوجارت هما ما استغلَّه لمنحه دور «ميشيل» الذي خلَّده كبطل قوميّ. أمَّا الأميركية جين سيبيرج فقد كانت فتاة فاتنة وهادئة وقعت في حبِّ السينما عندما شاهدت مارلون براندو في فيلم «الرجال (1950)»، وجاءت من هوليوود للبحث عن فرصٍ مناسبة في باريس بعد فشل فيلمها «صباح الخير أيها الحزن (1958)» للمخرج الأميركي أوتو بريمنغر، المُقتبس عن رواية فرانسواز ساغان. غودار رأى فيها ما لم يرَه الأميركيون بمنحها دور «باتريشيا» وسُدس ميزانية الفيلم -اشترطت مقابل ظهورها 15000 دولار-. وبقصَّة شَعرها الأشقر القصير جسَّدت أيقونة الأنوثة والجمال في ستينيات القرن الماضي. لكن بهاء الشخصيات ظلَّ حبيس الشكل أمَّا المضمون فقد كان ينطوي على الكثير من السطحية والنرجسية؛ إذ وصف بعض النقاد الفيلم بكونه: «شرسٌ بلا حدود، وخالٍ تمامًا من أيَّة نبرةٍ أخلاقية» تمامًا مثل ميشيل، اللص الفوضويّ المُندفع والمُتظاهر على الدوام كما لو أنه يحاول أن يكون رجل عصابات مثل بوجارت في محاولةٍ منه لأن يكون رائعًا لكنه يفشل في ذلك حتى. وفيما راح مُحبوُّ السينما الفرنسية في جميع أنحاء العالم يقتنون المُلصقات التي تُظهر المشهد الرومانسي لبطليّ «منقطع الأنفاس»: ميشيل ببدلته الرسمية وباتريشيا بقميص «نيويورك هيرالد تربيون»، وهما يتحدثان ويتمشيَّان على طول شارع الشانزليزيه، كان غودار يكسر الصورة: «النجم»، والمُثُل: «باريس ستظلُّ دومًا لنا»، وسينما الأفلام ذات الأسماء الرنَّانة التي تتجاوز الميزانية. هذا الفيلم ليس «كازابلانكا (1942)» والقصة ليست لـ«روميو وجولييت»، حيث المأساة لا ترقى إلى مستوى المأساة بل إلى مستوى الشخصيات. ففي بعض الحوارات يقول ميشيل لباتريشيا: «أردتُ رؤيتك لأرى ما إذا كنتُ أرغبُ في رؤيتك». ومرَّة أخرى يقول: «عندما تحدثنا؛ تحدثتُ عن نفسي، وتحدثتِ عن نفسك؛ عندما كان ينبغي لنا أن نتحدث عن بعضنا البعض». كانت باتريشيا طالبة «السُّوربون»، التي تُجسِّد خيبة أمل الشباب والمواضيع الوجوديَّة شخصية على قَدرٍ من الوعي -على الأقل- لمحاولة أن تُقرِّر ما الذي يُعجبها فيه.
طوَّر «منقطع الأنفاس» نوعًا من الوعي الذاتي الذي بدأ في أربعينيات القرن العشرين في فرنسا عندما دعا الناقد أليكسندر أستروك إلى أن تتحول السينما إلى لغة والكاميرا إلى قلم والمخرج إلى مؤلف، إلى أن تصبح السينما وسيلة للتعبير عن الفكرة لا مجرد عرض. ففي مقالته التي بدأت الموجة «ولادة طليعة جديدة: كاميرا القلم» التي نُشِرَت في مجلة «الشاشة الفرنسية» عام 1948، كتب أستروك: «كان ديكارت اليوم، قد أغلق نفسه بالفعل في غرفة نومه مع كاميرا 16 ملم وبعض الأفلام، كاتبًا فلسفته عن الفيلم؛ لأن مقالاً عن المنهج سيكون اليوم من هذا النوع بحيث يُمكن فقط للسينما التعبير عنه بشكلٍ مُرضٍ»، ردًا على مقولة ب.موريس ناديو في Combat: «لو عاش ديكارت اليوم، لكان سيكتب الروايات». هذا الميل الطليعيّ الواعي الذي ساهم في عودة مصطلح حركة عشق السينما «سينيفيل» الذي وصف به الناقد الإيطالي ريتشوتو كانودو عام 1920 نمط مُشاهديّ السينما في فرنسا الذين يجمعون ما بين غِواية السينما والخبرة بثقافتها، كان جليًّا عند غودار منذ كان ناقدًا سينمائيًا مُثقفًا باحثًا عن المعنى في السينما ومُعجبًا بجماليات سينما جان كوكتو وروبير بريسون الفرنسية الروحيَّة، وبأساليب وتقنيات سينما يوجيرو أوزو اليابانية، وبالفيلم الهوليووديّ الأسود خاصةً في سينما أورسن ويلز وألفريد هيتشكوك، وبواقعيَّة سينما مؤسس الموجة الإيطالية الجديدة روبرتو روسيليني التي أرخَت بِظِلالها على سينمَاه. بجانب تأثّره الكبير بالأفكار الوجوديَّة الفلسفية عند جان بول سارتر، وألبير كامو في رواية «الغريب»؛ إذ يستكشف في «منقطع الأنفاس» الأفكار العبثية بجانب العزلة في حياة الأفراد من خلال التركيز على الشخصيات اللامنطقية ذات الموقف السلبي تجاه الحياة والمجتمع مع الرفض الواضح في الانخراط في العواطف والأعراف الاجتماعية؛ لذا ظهرت العزلة كسِمَة بارزة في الفيلم كما في الرواية: يعاني «ميشيل» من عدم القدرة على التواصل الحقيقي مع الآخرين فيما يعيش في عالَمه الخاص؛ كما يجد «ميرسو» نفسه معزولًا عن مشاعر الآخرين ولا يشعر بالانتماء للمجتمع. هذا الاغتراب الوجوديّ في المنهج الأدبي الفلسفي التجديدي في الرواية الذي تجسَّد في المنهج السينمائي التجريبي التجديدي في الفيلم ينعكس إلى صورة من اللامبالاة العبثية التي تتقبَّل الموت بنفس القَدر الذي تتقبَّل به الحياة. وفي بداية خمسينيات القرن العشرين سبَّب انتشار عروض الأفلام الأميركية -التي مُنعت في أثناء الاحتلال الألماني- في فرنسا تراجعًا كبيرًا للنوع السينمائي الفرنسي الشعبي؛ إثر اتفاقيات «بلوم-بيرنز» عام 1946 التي هدفت إلى قضاء ديون فرنسا لأميركا -البالغة 2.8 مليار دولار- من خلال فتح السوق الفرنسي أمام المنتجات الأميركية خاصةً الأفلام. كان ذلك في وقتٍ لم تكن فيه السينما الفرنسية مُمارسة ثقافية بعد فيما كانت السينما الأميركية سينما الشباب والمثقفين بمَن فيهم غودار الذي لوَلَعِه بثقافة هوليوود دافع في كتاباته بشكلٍ خاصّ عن أفلام «الغرب الأميركي» وأفلام «النُّوار»، وأهدَى «منقطع الأنفاس» إلى استديو الإنتاج الأميركي «مونوجرام بيكتشرز»، واقتبس من خطّ همفري بوجارت مباشرة تكريمًا لهوليوود. لكن أفكاره وهواجسه الطليعية كمُفكِّر التي كان يترجمها مباشرة على الشاشة كمخرج كما كان يفعل في المقالة كناقد كانت بداية الطريق إلى تحرُّر السينما من المرئيات والصور لتصبح وسيلة للكتابة والتعبير عن الفكرة؛ لأن الأفكار والفلسفات المعاصرة للحياة هي من النوع الذي لا يمكن أن تُنصِفَه إلا السينما. مساهمته التي بحث من خلالها عن الموقف الفرنسي مقابل الموقف الأميركي كانت أعمق من مجرد تقليد حبكة «جريمة ودراما عصابات» أميركية بل «ميلودراما» ذات دوافع نفسية وشخصية وفكرية لا تسير على القواعد الخمس في الصناعة: الفكرة والسيناريو والإنتاج والمونتاج والعرض؛ إذ وجبَ مِن حينه أن يحتوي الفيلم على بداية ووسط ونهاية لكن ليس بالضرورة بذلك الترتيب. ما دفع النقاد إلى اعتبار سِرقة ميشيل للسيارة رمزًا مجازيًا لغودار نفسه حين بدأ الموجة. قال الناقد دودلي أندرو: «سرق غودار نوعًا سينمائيًا هوليووديًا ودفعه على الطريق». ومن جديد بتعبيرٍ أصيل عن الواقعية دفع «منقطع الأنفاس» الجمهور الفرنسي الشعبي إلى القاعات، ومُجدِّدًا الشكل الفيلمي النوعي أصبح تراثًا ثقافيًا شكَّل جزءًا من الذاكرة الوطنية.
قبل صدور الفيلم بأشهر حصد غودار جائزة «جان فيغو»، وكان مُلصقه على غلاف عدد يناير لـ«مجلة كاييه دو سينما». وحال صدوره اكتسح دور السينما، وجذب في إطلاقه الأول في فرنسا فقط ما يفوق المليونيِّ مشاهدة، وتلقى نجاحًا جماهيريًا ونقديًا. قال لوك لوميت: «من بين جميع الوافدون الجُدد للسينما الفرنسية فإن فيلم "منقطع الأنفاس (1960)" ليس الأفضل لأن فيلم "400 ضربة (1959)" سبقه كبداية، إنه ليس الأكثر لفتًا للانتباه لأن لدينا فيلم "هيروشيما حُبِّي (1959)"، ولكنه الأكثر تمثيلاً للموجة الجديدة». وبحلول يونيو من العام ذاته كان يُشار إليه باعتباره نقطة تحوُّل السينما الفرنسية. كان تفوقه على أفلام رفاقه ناجمًا عن كونه الدليل الحيّ الذي فتح باب المغامرة التي شكَّلت نقطة ارتكاز في تاريخ السينما. أمَّا بالنسبة لغودار فقد أصبح نجمًا سينمائيًا من حينه؛ بتصدُّر خبر زواجه من آنا كارينا -التي ستُصبح نجمة الشاشة الكبيرة- أغلفة المجلات والصُحف بعد العرض الأول للفيلم مباشرة. قبل ذلك بأشهر وصلتها دعوةٌ من غودار -بعد أن شاهدها في إعلانٍ تلفزيونيّ- للحضور من أجل دورٍ صغيرٍ في «منقطع الأنفاس» وظنَّت أنها مِزحة. وحين سألت أصدقائها عن هذا الرجل الغريب جدًا الذي يرتدي نظارة سوداء على الدوام، قالوا لها: «لا بد أنكِ مجنونة. الجميع يعرف غودار. فيلمه لم يصدر بعد لكن الجميع يعلم بأنه فيلمٌ رائع. اذهبي وقابليه». رفضت الدور لكنها قبلت عرضه الآخر. كل شيء جاء من هذا الفيلم، هذا النجاح والبريق الفوري كان مَفْخَرَةً له، لدرجةٍ ذكر فيها الناقد بيرت ريبهاندل في كتابه «جان لوك غودار: الثائر الدائم» أن غودار كان يسير في الوسط السينمائي ويقول: «أنا أسطورة». وما بين الناقد الذي صَنع الفيلم والفيلم الذي صَنع النجم، من «منقطع الأنفاس (1960)» إلى «نهاية الأسبوع (1967)» عَمد غودار إلى تنقيح وتفكيك رموز الصناعة وأعاد ترتيبها، ومع مرور الوقت أصبحت له رموزه وأدواته وأساليبه الخاصة به، التي انعكست لاحقًا على السينما الفنية والتجارية بتقليدها الابتكارات الشكلية والمرئية التحريرية لسينما المؤلف؛ فقد أثَّر الأسلوب الغوداريّ الفني والفكري في «منقطع الأنفاس» على سينما «أفلام الطريق» الأوروبية منذ بدايات سبعينيات القرن العشرين خاصةً في سينما مؤسس الموجة الألمانية الجديدة فيم فيندرز: «ملوك الطريق (1976)»، و«باريس تكساس (1984)». كما أَلهم الإرث الأسلوبيّ السردي والمنهجي في الفيلم صناعة السينما المُستقلة المعاصرة في العالَم أجمع بما في ذلك السينما العربية؛ من خلال المحاولات الجادة التي سَعت إلى كسر حِدة الشكل المُتعارف عليه بتجريب أساليب سردية جديدة، خاصةً في سينما محمد خان الذي بدأ بفيلمه «ضربة شمس (1979)» تيار الواقعية الجديدة في السينما المصرية، وعاطف الطيب في فيلم «سواق الأتوبيس (1982)»، وداوود عبد السيد في فيلم «الكيت كات (1991)». وبشكلٍ خاص كان له تأثير بارز على السينما الأميركية ذات الطابع المُستقل خاصةً في سينما روَّاد أقطاب الموجات الأميركية المعاصرة: مارتن سكورسيزي، وفرانسيس فورد كوبولا، وكوينتين تارانتينو، الذي لم يُطلق قبل سنوات على شركة الإنتاج التي يملكها «عُصبة الغرباء» تقديرًا منه لغودار فحسب بل كان أبرز الحضور الأميركي المُحتفي هذا العام بعودة غودار من جديدٍ إلى قلبِ «الكروازيت»، إلى المهرجان العريق الذي لم يكفَّ عن تكريمه؛ إذ اُختير فيلم الأميركي ريتشارد لينكليتر «الموجة الجديدة (2025)» للتنافس على السعفة الذهبية المرموقة، والذي يسرد تفاصيل إنتاج «منقطع الأنفاس». وهو فيلم أكثر مِن كونه سيرة ذاتية لكواليس صناعة أحد أنجح الأفلام بالأبيض والأسود بل تكريمٌ من سينفيليّ أوستن، تكساس لسيرةِ موجة سينمائية كاملة شكَّلت كتالوج أيقونيِّ لسينما ما بعد الحداثة، وإن كان سرد الفيلم يخالف روح غودار؛ إذ نظر النقاد إلى الأسلوب باعتباره أميركيًا أكثر من كونه فرنسيًا، برَّر لينكليتر ذلك بقوله: «من المستحيل تقليد غودار؛ سنفشل. لكننا حاولنا تقليد أسلوب الموجة».
الفلسفة التي بدأت بـ«منقطع الأنفاس (1960)» شكَّلت مزيجًا من الواقع واللاَّ واقع في الآنِ ذاته؛ فبينما ظهرت الشخصيات مُفرطة الواقعية كما لو كانت تعلم بأنها في فيلم، بقيت طوال الوقت تسير في دوائر مُفرَغة من أسلوب الحياة المُعاش ذاته. كان الفيلم عالَمًا موازيًا أشبه بالحُلم؛ الصفة اللصيقة بأفلامِ غودار الذي يرى بأن السينما مهما اقتربت من الواقع لا يمكنها الإجابة عن الأسئلة الوجوديَّة باعتبار الفيلم المِعيار السينمائي للفن وليس الحياة. وفي المشهد الذي ظهر فيه المخرج جان بيير ميلفيل -الأكثر شُهرة في فرنسا بعد تقاعد جان رينوار الذي وضع قواعد اللعبة في ثلاثينيات القرن العشرين-، مُجسِّدًا شخصية الأديب بارفيوليسكو، الذي يجري معه الصحفيين حوارًا بمَن فيهم باتريشيا، صرَّح عن نظرياته حول الحياة والحُبّ والموت، وحين سُئل: «ما هو أعظم طموحاتك؟». أجاب: «أن أُصبح خالدًا ثمَّ أموت». أُمنية تحقَّقت على الوجه الأكمل؛ إذ لم يكن يطمح للخلود الذي بحث عنه «جلجامش» بل للخلود في الفن الذي يحتفظ بلحظةٍ من الوجود دون أن يقتلها أو يموت بموتها. جان لوك غودار يعرِف كيف يجمع ما بين كل ما هو مُتناقض: الواقع والحُلم، اليأس والأمل، الصور والكلمات، الموسيقى والأصوات.. وبرحيلهِ جسَّد واحدة من أكثر النهايات عبثية في تاريخ السينما لفنانٍ مُجدِّد عاشق للسينما وملأها بالشِّعر والفلسفة. كجزء من فلسفته المُضادة في الحياة، صرَّح في حوارٍ له -مع برنامج «Pardonne-moi»-، عن خوفه القديم من أن يُجرّ في عربةٍ يدويَّة عندما يَشتد به المرض. سنواتٌ بعد، عام 2022 غادر المَشهد اختياريًا، مُغلقًا القوس من حيث بدأ، تاركًا وصيته: «مَن يُحبُّ الحياة؛ يَذهب إلى السينما».