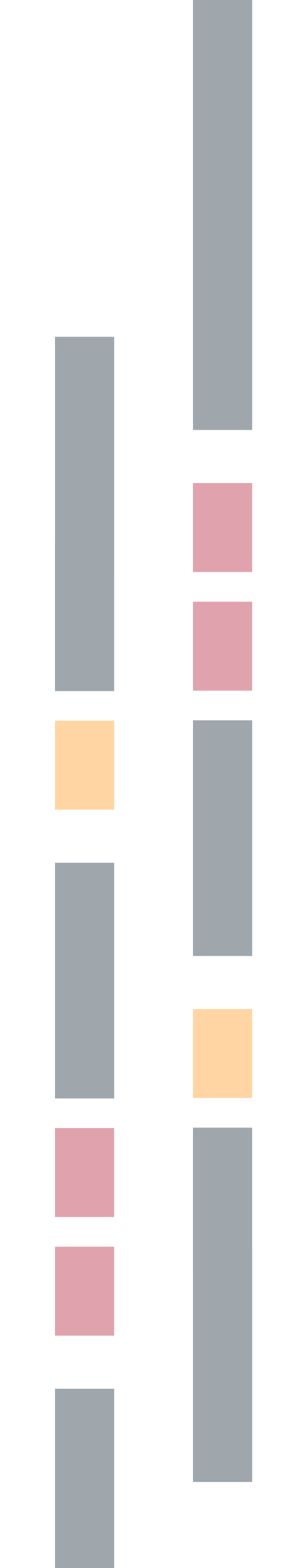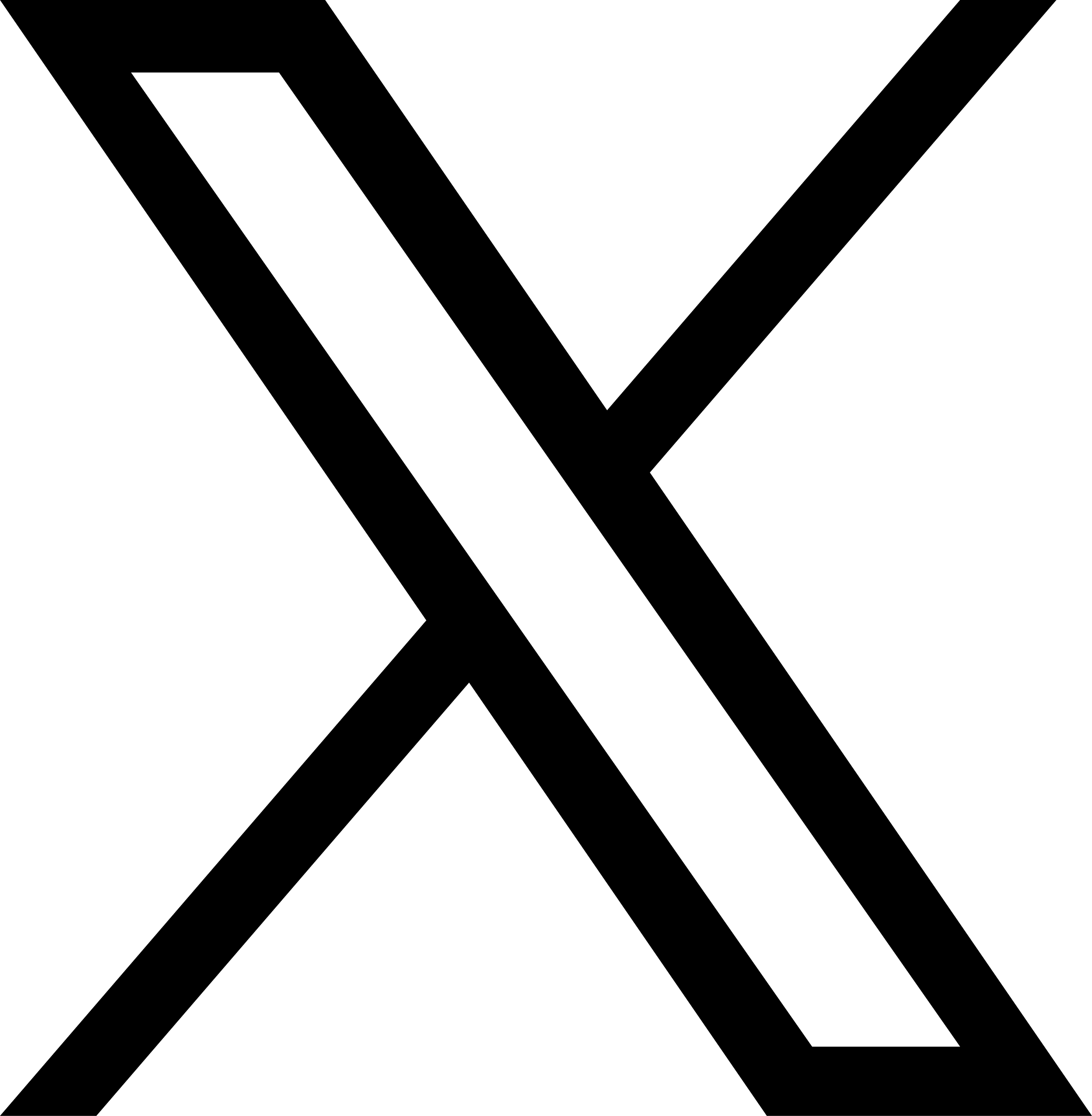شارك
في كتابه «السينما والفكر النقدي»، الصادر عن منشورات سليكي إخوان بطنجة 2024، يأخذُ الناقد السينمائي المغربي، خليل الدّمون، القارئَ إلى قارة ثقافية تكاد تكون بكرًا في النقد السينمائي العربي، بمساءلته المتخيّل السينمائي، وإبراز سماته الفنية والتعبيرية والرمزية ذات الصلة ببناء الفكر النقدي وترسيخه، مع إقراره، في الوقت ذاته، بقدرة هذا المتخيّل على تحرير العاطفة والحلم والرغبة والوجدان، ومصالحتها، تاليًا، مع مقتضيات هذا الفكر.
يعي الدّمون، جيدًا، قدرةَ السينما على الاشتباك بالواقع، أولًا باستيعاب أسئلته وإشكالاته وتوتراته وفهمها، وثانيًا بدفعها نحو مختبر التخييل السينمائي. ويتقاطع في ذلك مع ما ذهب إليه الفيلسوف الفرنسي إدكار موران، في كتابه «السينما أو الإنسان المتخيل»، حين وضع السينما «بين المنظومة السوسيو- ثقافية والمتخيّل»، بما يعنيه ذلك من تحرير المتخيّل السينمائي في مواجهة الواقع.
وعلى الرغم من أن «السينما والفكر النقدي» قد يبدو، لأول وهلة، كتابًا في النقد السينمائي، إلّا أنّ قراءة فصوله بتمعّن، تكشف عن انشغالٍ بادٍ بما يجمع بين السينما والفكر النقدي من جسور التواشج؛ وفي هذا الصدد، خصَّ الكاتبُ الناقدَ السينمائيَّ المغربيَّ الراحلَ، نور الدين الصايل، بفصلٍ في الكتاب، باعتباره أحد المثقّفين المغاربة القلائل الذين نجحوا في ابتداع توليفة فكرية وفنيّة وسينمائية متكاملة، لا شك أنّها اغْتنت من السياق الثقافي العام الذي عاشه المغرب بعد الاستقلال، ومن الانفتاح على الثقافات الغربية، وبالأخص الفرنسية. وتدينُ السينما المغربية للصايل بالكثير، لا سيّما فيما يتعلق بإرساء هياكلها التنظيمية والثقافية، ومن ذلك دوره في تأسيس «الجامعة الوطنية للأندية السينمائية» (1973)، التي كانت فرصة لنشر ثقافة سينمائية جديدة، تضع الفكرَ النقدي في صلب انشغالاتها، بجعل الأندية السينمائية وجهةً لجمهور عريض، أصبح بوسعه التفاعل مع السينما بشكلٍ مغايرٍ «بعيدًا عن منطق الاستهلاك والاستلاب» (ص 24).
هذا الانشغال بالفكر النقدي سيأخذ أبعادًا أخرى، من خلال «سينما سنوات الرصاص»، التي شكّلت محطّ اهتمام السينمائيين المغاربة مع بداية الألفيّة الجديدة. وقد تزامن ذلك، بشكل لا يخلو من دلالة، مع صدور تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة. فلم يكن اجتذابُ قضايا الذاكرة والعدالة والمصالحة إلى دائرة اهتمام السينما المغربية مجردَ أفق ثقافي جديد نجحت السينما المغربية في فتحه، بل كان أيضًا مؤشرًا على بداية تشكُّل وعيٍ جديدٍ بأهمية السينما في بلورة الفكر النقديّ وتطويره، خاصة أن تقرير الهيئة المذكورة نصّ على أهمية الفضاء العمومي الذي يشمل كافة فضاءات الفعل الاجتماعي والثقافي والسياسي.
يرى الكاتب أنه ورغم وجود عدد من الأفلام (الطويلة) التي تصدّت لسنوات الرصاص في المغرب، إلّا أن عددًا محدودًا منها نجح في ذلك بكيفية صريحة (ص 62)، وإن كان ذلك لا يمنع من القول، إن تلك الأفلام «تبقى، على كل حال، معبرةً عن وجهة نظر مُخرجيها، وعن رؤيتهم الخاصة للمرحلة، وعن قراءاتهم الشخصية لكثير من الحالات» (ص 63). ولذلك، فإنّ قراءة هذه الأفلام بتأنٍّ، حسب الكاتب، تكشف تقاطُعَ تطلّعات مخرجيها مع تطلّعات هيئة الإنصاف والمصالحة لفهم ما جرى، بما يضمن من جهة تضميدَ جراح الوجدان الجماعي للمغاربة، ومن جهة أخرى بناءَ ذاكرة متوافقٍ عليها.
لا يبدو الكاتب منشغلًا بقراءة الأفلام ذات الصلة بسنوات الرصاص في حدّ ذاتها، بقدر ما يتوخى تعميق الوعي بأهميّة السينما، والفنون البصرية بوجه عام، في تنمية الفكر النقدي، بما يوسّع دائرة التفكير في تلك السنوات باعتبارها في النهاية جزءًا من الذاكرة الجماعية للمغاربة. ولإبراز هذه الأهميّة يستدعي مبحثَ «السينما والرواية» أفقًا للتفكير في السينما وتجريب ممكّناتها في إرساء هذا الفكر، على اعتبار أنها، كما نقرأ في ص 74، «أتت بالتركيبة النهائية لمختلف أشكال التعبير الإنسانية (..)». فهي تختلف عن الأدب، فإذا كان اكتشاف المحكي الفيلمي يتم من خلال الصور المتحركة والمركّبة والحوار والصوت والموسيقى والألوان التي ترتسم على الشاشة، فإن اكتشافَ المحكي المكتوب (الروائي) يكون عبر «آثار مرسومة على الورق». ولتأكيد العلاقة الوثيقة للسينما بالأدب في تنمية الفكر النقدي، يسوق الكاتب نماذج من أفلام عربية، قراءة وتحليلًا؛ فيلم «الكرنك» لمخرجه المصري علي بدر خان (1975) المقتبس عن رواية بنفس العنوان للكاتب المصري الراحل نجيب محفوظ، وبعض أفلام المخرج التونسي ناصر خمير من قبيل «الهائمون» (1986)، و «بابا عزيز الأمير الذي يتأمل روحه» (2005).
لا ينشغل الكاتب، في قراءته وتحليله لهذه الأعمال، بما تقدمه على صعيد المتخيل السينمائي وحسب، بل يسعى إلى تفكيكها، في أفق إعادة تركيب جمالياتها البصرية، بما يجعلها أكثر قدرة على استنفار الفكر النقدي. فاستدعاء إشكالات الموروث الثقافي، والمرأة، والهجرة، وحقوق الإنسان والتخلّف الاجتماعي على أهميتها، ينبغي ألّا يُغفل هواجس الأسلوب والحكي وجمالية الصورة، وهي هواجس تبدو على صلة بالجرأة: الجرأة في الكتابة والإنتاج وتوظيفِ الكاميرا والألوان والصوت (ص 95). من هنا، يمكن فهم اهتمام الدّمون بما تقدمه الموجة الجديدة في السينما المغربية من أفلام، يبدو أصحابُها أكثر حرصًا على الأخذ بالجوانب الفنية والشكلية. فهناك حاجة ماسّة، في أحيان كثيرة، إلى «'وضع قصة الفيلم جانبًا، من أجل البحث عن لغة سينمائية (لغة السينما البصرية)، ذلك أنّ السينما ليست مجرد سرد للقصص، وإنّما هي كيفية التعبير عن هذه القصص» (ص 97). في هذا السياق، يسوق الكاتب نماذج سينمائية مغربية أفلحت، عند حدود معينة، في توظيف الأسطورة والرمز وجمالية الصورة في معالجتها قضايا اجتماعية، أبرزها فيلم «البراق» الذي سعى مخرجُهُ محمد مفتكر إلى «'خلخلة الدراماتورجيا الخطية، سواء منها تلك التي تسير بكيفية كلاسيكية في خط تصاعدي من العرض، إلى الذروة، إلى النزول، أو تلك التي تقوم على الصدمات الناتجة عن صراعات بين الشخصيات، أو بتتابع الأحداث المتناقضة» (ص 99). وهو ما يُفترض، بشكل أو بآخر، أنه يصب في المجرى العام للفكر النقدي، فالغايةُ جعلُ المتفرج يطرح أسئلة السينما، ويتَّبِع عناصرَ التعبير السينمائي بشكل «يكاد ينسينا في الحكاية الأصلية، أو في أحسن الحالات يجعلنا ننتبه إلى التداخل بين الحكي والبنية الشكلية للفيلم، فضلًا عن الانتباه إلى الجزئيات الصغيرة التي تمرُّ بسرعة فائقة أمام عينه (المتفرج)، كجزئية العين الحاضرة بقوة في «البراق»، التي تؤطر السرد بالانتقال من عين الفرس إلى عين ريحانة إلى عين الكاميرا (..)، بما يدفع المتفرج إلى الابتعاد قدر الإمكان عن الحكاية الأصلية: حكاية ريحانة، أو على الأصح تمر حكاية ريحانة عبر عين الفرس (إشارة إلى الأسطورة)، وعبر عين الكاميرا (إشارة إلى الفعل السينمائي)»(ص 99).
في السياق ذاته، يستدعي الكاتب السينما الأفريقية في اشتباكها مع قضايا المقدّس وتبدِّياته المجتمعية والثقافية؛ هذا الاشتباك، الذي عكسته أعمال مخرجين أفارقة، مثل الغابوني بيير ماري دونغ والإيفواري هنري دوبارك، يندرج ضمن أفق يستهدف «فضح المعتقدات التقليدية وإدانتها» (ص 110)، على الرغم من أنّ بعض الأفلام الأفريقية آثر أصحابُها عدمَ القطع نهائيًا مع الموروث الثقافي والروحي التقليدي لمجتمعاتهم، كما هو الشأن بالنسبة للمخرجيْن البِنيني باسكال أبيكانْلو في فيلمه «تحت علامة الشعوذة» (1974)، والسينغالي أباباكار سامب مكارام في فيلمه «كودو» (1971). تبدو السينما الأفريقية، في المجمل، وكأنّها تكشف التوترات القيمية والفكرية والثقافية التي تحُول دون إشاعة الفكر النقدي في المجتمعات المحلّية بدل أن تُنتج خطابًا فيلميًا قادرًا على استفزاز هذا الفكر.
كذلك، لم يَفُت الكاتبَ أن يخصّص فصلًا من كتابه لقضايا المرأة في بلدان المغرب العربي، وهو ما يُفترض أنّه يعكس وعيًا بأهميّة الحضور النسويّ، في الثقافة والفنون بوجهٍ عام. ومن أبرز السمات التي تطبع هذه السينما، الخلفيّة السينمائية الواضحة، وتحويل السينما إلى منصّة فنيّة وثقافية تعرض قضايا المرأة، كما هو الشأن، على سبيل المثال، بالنسبة للمخرجتين التونسيتيْن سلمى بكّار في فيلم «فاطمة 75» (1976)، ورجاء عماري في فيلم «الحرير الأحمر» (2002)، والمغربية نرجس النجار في فيلم «العيون الجافة» (2003). على أنّ أهميّة السينما التي تناقش قضايا المرأة تتبدّى أكثر، في طرحها قضايا لم تُطرق من قبل في المجتمعات المغاربية، في تَخَطٍّ لما قدمته «سينما الرجال» بتعبير الكاتب. إنّ الرهان الأكبر لهذه السينما يتمثّل في إنتاج الوعي بـأهمية قضايا المرأة، ضمن أفق نقدي، يجعل من قضية المرأة، بكل تعقيداتها المعلومة في مجتمعاتنا، أداةً لتعميق الوعي بقضايا المجتمع ومشكلاته.
من ناحية أخرى، خصَّ الكاتب المخرج الياباني الراحل أكيرا كوروساوا بفصلٍ تناول فيه فيلمه «'أحلام»' (1990)؛ فيلم، وإنْ كان يعكس رؤية مخرجه المرتبط بتاريخ بلاده وثقافتها وتراثها، إلا أنّه بالوسع اعتباره كذلك صرخةً سينمائية في وجه الحضارة الحديثة بكلّ تجلِّياتها العلمية والتقنية. إنّه دعوة للمجتمعات الحديثة للتفكير في المخاطر المحدقة بها على المدى البعيد (الحرب، السلاح النووي، استنزاف الموارد الطبيعية...)، وبمعنى آخر، إنّه دعوة للنقد المفتوح الذي يسائل يقينيات هذه الحضارة ويعيد قراءتها على ضوء التحديات التي تُواجِهها على غير صعيد. تستمدُّ الأحلام، في هذا الفيلم، سحرها البصري من القدرة على «ربط الحلم بالواقع واللاشعور بالشعور واللامرئي بالمرئي»' (ص 130)، وبالتالي إحداث ارتجاج في مخيلة المشاهد، بشكل يحفّزه على التفكير في هذه المخاطر الكونية وتعميقِ وعيه بها.
على الرغم من أنّ «السينما والفكر النقدي» قد يبدو كتابًا في النقد السينمائي الذي يُزاوله خليل الدمون منذ عقود، إلّا أنّ قراءته بتمعُّن تكشف عن دعوة مفتوحة للتفكير بالسينما، بتوظيف الصورة في طرح الأسئلة، والتحليل، والنقد، واجتراح المفاهيم السينمائية التي تتوافق مع ما تطرحه الأفلام من قضايا ومشكلاتٍ (وأحلامٍ أيضا)، الأمر الذي يكرِّس الوظيفة النقدية للسينما بتعبير الفيلسوف الفرنسي الراحل جيل دولوز. ولا شكّ أنّ ذلك يساعد، بقدرٍ أو بآخر، في إحداث تحوُّلٍ في آليات التفكير التقليدية، ويمنحُ السينما مكانتها المستحقّة فنّـاً مُحفّزًا على التفكير النقدي.