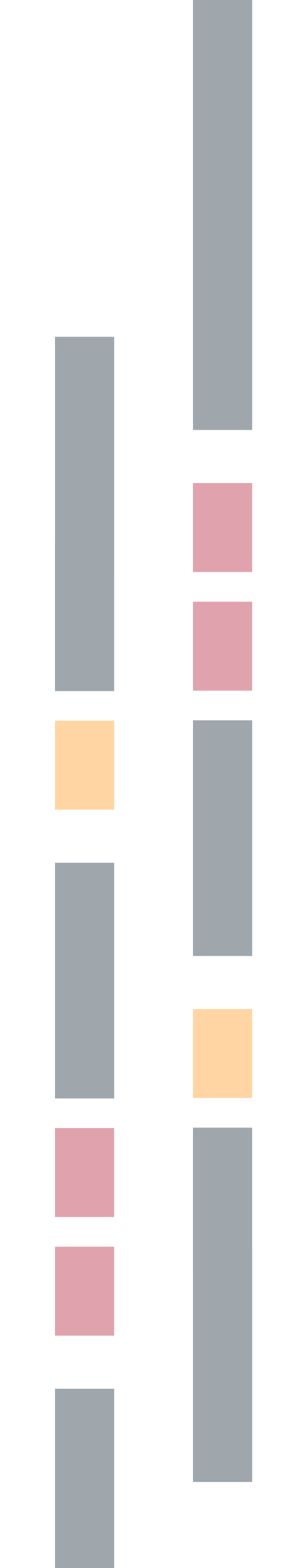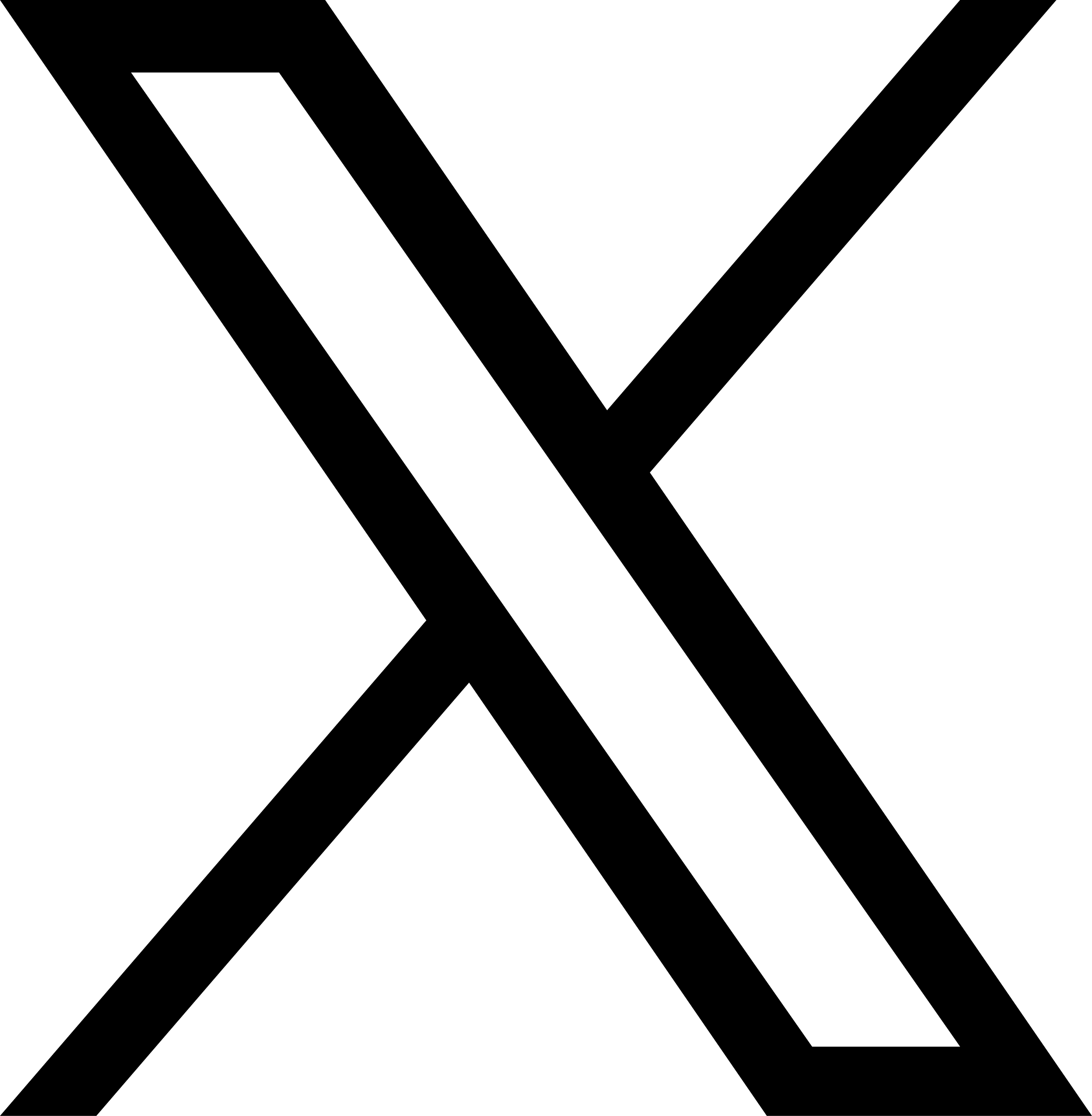شارك
الملخص
تسعى المقالة إلى استكشاف العلاقة بين السينما والذاكرة الجمعيّة في المجتمع السعودي، ليس من منظور توثيقيّ تقليديّ، بل بوصف السينما وسيلةً لأرشفة رمزيّة للتجارب التي لم توثَّق رسميًا. تنطلق المقالة من التمييز بين «ذاكرة الحقائق» و«ذاكرة التجارب» كما ألهم بهما الفيلسوف الفرنسي بول ريكور، وتستعرض كيف يمكن للصورة السينمائية، وفقًا لـعالم الاجتماع الفرنسي جان بودريار، أن تُنتج واقعًا رمزيًا يفوق الواقع الأصلي. من خلال تحليل فيلميّ: «خمسون ألف صورة» لعبدالجليل الناصر و«هوبال» لعبد العزيز الشلاحي. تتتبع المقالة كيف تُمثِّل السينما السعودية الحديثة صوتًا موازيًا للذاكرة الرسمية، وتعيد تأويل الماضي الذي تعرّض للنسيان أو الكبت، بفعل ثقافي أو اجتماعي. وتخلُص المقالة إلى أنّ السينما قد لا تُنقذ الذاكرة الجمعيّة من الفقد، لكنّها تمنحها فرصة للعودة بوصفها سردًا حيًّا، لا وثيقة جامدة.
مدخل
عادة ما تُحفظ أحداث التاريخ وتفاصيل الماضي في السجلات الرسمية والارشيف الموضوعي المؤسسي. وهو جانب له أهميته في استدامة الهوية وبناء ذاكرة جمعيّة تعزّز الاندماج والتماسك الاجتماعي في المجتمعات الإنسانية. إنّما هناك شكل أعمق من الذاكرة، لا يكتب عادة: تلك التي تختزنها التجارب اليومية، والأحاديث الهامشيّة. في هذه المقالة، نحاول تتبّع تلك الذاكرة الجمعية، لا عبر الوثائق، بل عبر وسيط الصورة والسينماء. ولكي نفهم كيف تتحوّل الصورة السينمائية إلى حامل للذاكرة «ذاكرة تجارب» نتناول بالتحليل نموذجين مختلفين من السينما السعودية المعاصرة: فيلم «خمسون ألف صورة» لعبدالجليل الناصر، وفيلم «هوبال» لعبد العزيز الشلاحي. في تحليل هذين النموذجين، تستند المقالة إلى جملة من المفاهيم النظرية التي تضيء العلاقة بين السينما والذاكرة الجمعية، خصوصًا في التوتر بين التوثيق كفعل إداري، موضوعي، محايد، والتذكّر كأرشفة اجتماعية.
يُلهمنا هنا الفيلسوف الفرنسي بول ريكور في تمييزه بين التذكّر، كفعل تاريخي، والتذكّر كفعل سردي؛ أو بعبارة أخرى الفرق بين ذاكرة الحقائق وذاكرة التجارب. كما نستعين أيضًا بجهود عالم الاجتماع الفرنسي جان بودريار في قراءته للصورة بوصفها أداة لصناعة ذاكرة رمزية. وبمعنى آخر الصورة هنا لا تحاكي الحدث، بل تحلّ محله. هذه المفاهيم تُستخدم هنا لا كأدوات تحليل جامدة، بل كعدسة نعيد من خلالها قراءة كيفية اشتغال السينما السعودية على أرشفة ما لم تُسجّله الوثائق، وما ظلّ حبيسًا في التجارب والصمت والذاكرة الفردية. لقد مرّت في تاريخ المجتمعات البشرية تجارب كبرى، فُقدت أو نُسيت أو أُفرغت من شعورها، وربما ظلّت حبيسة الأرشيف التقليدي أو غابت عنه تمامًا. وهنا يتضح الفرق بين «ذاكرة الحقائق»، كما تصوغها المؤسسات وتحفظها الملفات، و«ذاكرة التجارب» كما يحملها الناس في الفنون، والتراث الشعبي، والمرويّات غير الرسمية. هذا التفريق، وإن لم يُصَغ بهذه التسمية حرفيًّا، إلا أنه مُستلهم من أطروحة بول ريكور حول التمييز بين التذكر بوصفه سجلًا تاريخيًا، والتذكّر بوصفه سردًا اجتماعيًا يعيد بناء الماضي وفق الحاضر (ريكور، ٢٠٠٩م). ومن هذا التباين تولد الذاكرة الجمعية، وتُعاد الحكايات، وتُخترع الصور، لا لتقول لنا ما حدث، بل لتُفصح عن كيف مرّت التجربة في وجدان من عاشوها، وماذا تركت فيهم من أثر.
لقد مرّ المجتمع السعودي بتحوّلات اجتماعية كبرى، بقيت بعض أحداثها - مثل التي شهدها زمن «الصحوة»- مسجّلة بدرجات متفاوتة في الأرشيفات الإعلامية منها والرسمية، ولكنّها بدأت تُنسى في الوعي الشعبي، أو لنقل تراجعت ضمن الصمت الجمعي عن حقبة حساسة من تاريخنا الاجتماعي. وبالتالي فإنّ هذا النسيان أو «التناسي» ليس فعلًا سلطويًا مباشرًا، بل نتيجة تفاعل ثقافي وديني واجتماعي. هذه المساحة الخام من الماضي حاولت السينما السعودية استدعاءها في أكثر من موقف لا لتوثّق الماضي بشكله البسيط والسطحي، بل لإعطاء تلك الفترة صوتًا جديدًا، بما يشبه فعل أرشفة رمزية لأحداثه.
الاختيار لفيلميّ: «خمسون ألف صورة» و «هوبال» ليس عشوائيًا، ولا محكومًا فقط بقيمة العمل الفني، بل هو قائم على تباين الأسلوبين في مقاربة قضية الذاكرة الجمعية. «خمسون ألف صورة » يتعامل مع ذاكرة موجودة، ولكن مُمزقة قابلة للاستعادة من خلال الصور الفوتوغرافية التي نجت من الحذف. بينما «هوبال»، يتعامل مع ذاكرة لم تُوثَّق أصلًا، ذاكرة مختبئة في تضاريس الصحراء، في الصمت، في المرويات التي لم تُدوّن. ضمن هذه السياق، لا تعود الصورة السينمائية مجرّد حدث بصري، بل تتحول إلى أداة رمزية لإعادة بناء وعيِنا بالماضي. وهنا، تبرز أهمية وطرافة ما ذهب إليه المفكّر الفرنسي جان بودريار، كما يشير في كتابه المصطنع والاصطناعي الذي يرى أنّ الصورة لا تمثل الواقع، بل هي الأصل ذاته، والحدث إنّما هو مجرد انعكاس لها وليس العكس تعبيرًا عن الذات والواقع (بودريار، ٢٠١٢م). ويمكن اعتبار فيلم «هوبال» تجسيدًا لمثل هذا المفهوم؛ فالفيلم لا يخفي واقعًا قائمًا، بل يعرض محاكاة لحكاية لم تكن موجودة في الأرشيف الشعبي، الجد ليام ليس شخصية تاريخية بقدر ما هو بنية رمزية، يستحضر من خلالها المخرج ماضيًا متخيلاً نابعًا من فراغ وثائقي، فتبدو الصورة السينمائية في «هوبال» وكأنّها اختراع لذاكرة محتملة لمجتمع لم يُسمَح له بالتعبير عن ذاته في زمن العزلة. وهذا ما يجعل من السينما وسيطًا ثقافيًا قادرًا على إنتاج أرشيف رمزي يتجاوز الوثائق، ويعيد بناء التجارب. فما العلاقة بين فعل التذكّر الإنساني «الأنثروبولوجي» وبين السينما كفن له وظيفة جمالية في المقام الأول؟
السؤال هنا، هل الماضي في السينما مجرد حدث محفوظ على شكل شريط من الصور المتحركة فقط كما هو أرشيف الحقائق؟ بالطبع لا، إنّنا هنا نتحدث عن توليد ذاكرة رمزية بديلة تُظهر بعض الأحداث عبر قدرة الصورة على خلق الحقائق وترسيخها. إننا أمام عملية (إخفاء/إظهار) عمدية تتقصّد إعادة تشكيل الماضي وليس روايته كما ترويه كتب التاريخ. الدراما بشكل عام والسينما خصوصًا، تعيد لنا بناء زمن مفقود ضمن سياق اجتماعي يتيح للمتلقّي أن يستعيد شعوره بذلك الزمن. وهذا الإخفاء والإظهار لا يُضمر بالضرورة نوايا إيديولوجيا لصُنّاعه؛ فالفنان بالنهاية ابن بنيته الاجتماعية. منذ اختراع التصوير الفوتوغرافي، أصبحت الصورة وسيطًا مركزيًا في حفظ الذاكرة، سواء على المستوى الفردي أو الجمعي. فالصورة لا توثّق الحدث فحسب، بل تحفظ الشعور المرتبط به، وتربط الحاضر بالماضي عبر وسيط مرئي يمكن العودة إليه. ومع اختراع السينما، بدأ هذا الدور يتوسّع ليشمل ليس فقط التوثيق، بل إعادة التخيّل، وتحويل الواقع إلى سردية، والماضي إلى مشهد قابل للتأويل.

وفي فيلمنا الآخر «خمسون ألف صورة»، لا تمثّل شخصية تركي الباحث عن صورة أبيه ذاتًا فرديّة فقط، بل تعبيرًا عن صوت جمعي سعودي لذاكرة محروقة داخل مجتمع عاش ذروة الصراع مع المعتقدات الدينية في تسعينيات القرن العشرين. لقد فقد الشاب صورة والده لا بسبب خطأ تقني، بل نتيجة قطيعة رمزية فرضها خطاب الصحوة، حين أُعيد تعريف الصورة بوصفها محرمًا دينيًا. صحيح أن تحريم الصور استند إلى اجتهادات فقهية صريحة، لكنّه – في أبعاده الثقافية – أسهم في خلق فجوة بين الناس وذاكرتهم البصرية. ويمكن قراءة هذا التحول في ضوء تاريخ بشري طويل من القلق من سلطة الصورة، كما حصل في «حرب الأيقونات» في التاريخ المسيح (Iconoclasm)، التي اندلعت في الإمبراطورية البيزنطية في القرن الثامن الميلادي (٧٢٦م/٨٤٣م). لسنا هنا بصدد المساواة بين السياقين فهما برأيي غير متساويين ثقافيًا وتاريخيًا، ولكن لا يمكن إغفال أنّ الخوف من الصورة كثيرًا ما يرتبط بالخوف من الحرية في التذكّر والتمثيل «الصنميّة واتخاذ الأسطورة». لأن الصورة، بخلاف النص، تُفتح على تعدد المعاني، ولا تخضع لسلطة مركزية في تفسيره،ا لذلك تبدو السينما – في السياق السعودي – محاولة ليس فقط لرواية الماضي، بل لاستعادة شرعية النظر، وحق الذاكرة في أن تكون مرئية. وكأن الفيلم يقول: إنّنا لا نبحث عن صورة فقط، بل عن إمكانية الرؤية ذاتها وما يرتبط بها من مكانات وتعريف للهوية الاجتماعية. وهنا يتقاطع الفني بالديني، والثقافي بالرمزي، في محاولة لفهم كيف تشكّلت علاقتنا بالذاكرة – ومن حرمنا منها، وكيف يمكن استعادتها؟ ما يقوم به بطل «خمسون ألف صورة» ليس فقط بحثًا عن صورة لوالده، بل محاولة يائسة لاستعادة ذاته المُمزّقة، إعادة ترميم لأرشيف معطوب.
ليست كل ذاكرة مفقودة نتيجة الإهمال أو المصادفة. في كثير من الأحيان، يكون النسيان فعلاً اجتماعيًا ممنهجًا، تشارك فيه الجماعات، وتدعمه المؤسسات، وتؤطره المعتقدات. وهذا ما يميز «النسيان الجمعي» عن النسيان الفردي. فبينما يرتبط الثاني بالوظائف البيولوجية أو النفسية، يرتبط الأول بالبُنى الثقافية والاجتماعية التي تحدّد ما ينبغي أن يُتذكّر، وما يجب أن يُنسى. وفي المجتمع السعودي، عاشت الأجيال في العقود الأخيرة لحظات كثيفة بالتغيّرات: من طفرة النفط، إلى الصحوة، إلى الانفتاح السريع. كثير من هذه اللحظات لم تجد من يوثّقها أو يفسّرها، فظلّت إمّا مُهمَلة، أو محاطة بالتأويلات المتناقضة. وهنا تلعب السينما دورًا بالغ الأهمية، لأنّها – دون أن تدّعي الموضوعية – قادرة على استعادة هذه اللحظات بشكل رمزي، وفني، وشعوري.
حين تصنع السينما السعودية أفلامًا عن فترات بلا أرشيف بصري - كما في تجربة الصحوة - فهي لا توثق ما غاب، بل تُنتج ما سيبقى: ذاكرة رمزية جديدة، تحلّ محلّ ما سُكت عنه، أو ما لم يُمنح لغة للظهور. نحن لا نذهب إلى السينما بحثًا عن التاريخ، بل بحثًا عن أنفسنا فيه. عن تلك اللحظات التي مرّت علينا دون أن نمتلك لغة لها. والسينما حين تكون صادقة تمنحنا هذه اللغة وتجعل من الصورة ذاكرة، ومن الحكاية خيطًا نلملم به ما تفرّق منّا. ولهذا، فإن السؤال في هذه المقالة ليس فقط : ماذا تقول السينما عن الماضي؟ بل كيف تُعيد السينما صوت التجربة إلى الذين عاشوها بصمت؟ في هذا السياق، يغدو العم علي في فيلم «خمسون ألف صورة» صورة بشخصيته الهادئة وأرشيفه مكانة معارضة للنسيان. فهو يبدو كمؤسسة اجتماعية بديلة تقوم بمهمة التوثيق وحماية الذاكرة مما لم يرسمه الأرشيف الرسمي. تتحول غرفة تحميض الصور في الفيلم إلى مكان زمني عاكس، يرفض المشي في خط الوقت ويستدعي ما كان قد فات. ولذلك لا يكون فعل فتح الألبوم هنا روتينًا بصريًا، بل استدعاء وجداني لذاكرة اجتماعية تعرضت للطمس في سنوات ماضية. وهنا تحديدًا يكتسب الفيلم قيمة أكبر من قصته التقليدية عن شاب يبحث عن صورة والده. فالحقيقة أنّنا أمام سينما تقوم بأول خطوة في طريق معاكسة: ليس التوثيق، بل الاستفسار. تطرح الصورة هنا اسئلتها الكبيرة: من يحفظ هويتنا عندما يفقد المجتمع الشجاعة على سرد قصصه؟ من يتولى مهمة أرشفة ما لم يكتبه الرسميون؟ ومن يُأوِّل الصمت الذي خلّفه نفس المجتمع الذي منع تداول تلك الذاكرة لعقود؟.
الفرنسي «بول ريكور » يحمّل هذا التصور الذي بين أيدينا خطوة أبعد، حين يرى أن كلّ تذكّر هو بالضرورة تأويل سردي لا يؤرشف فيه الماضي كما هو، بل كما ترويه المجتمعات ضمن حاجات الحاضر وأدواتهم التعبيرية. وهذا يُمكن تَلمُّسه من خلال فيلمنا الآخر «هوبال» للمخرج عبدالعزيز الشلاحي وكتابة مرفج المجفل. هذا العمل هو محاولة إعادة لزمن فيزيائي «ماضي» انتهى كل ما يتعلق فيه من متعلقات ثقافية ورمزية حتى صار أشبه بالأسطورة! لكنّ الشلاحي يعيده لنا من جديد ليروي لنا قصة عائلة الجد ليام عبر صورة لذاكرة جمعيّة سعودية يبدو أنها خارج الأرشيف الرسمي وسردياته! لحظة يرى فيها الجمهور الماضي لا كما يبدو حقيقة وبشكل موضوعي «أرشفه فعليّة» بل «أرشفة تجارب» من خلال الصورة السينمائية.
ما يلفت في هوبال ليس فقط شخصية الجدّ، بل المكان الذي تدور فيه القصة: الصحراء، وتحديدًا مناطق مثل «الدحول » التي لم تكن مجرد لوكيشن تصوير تقليديًا، بل جزءًا من المعنى. ومن الغريب والمدهش أن هذه المناطق نفسها كشفت فيها هيئة التراث السعودية مؤخرًا ما يُعدّ أطول سجل مناخي في الجزيرة العربية نحو ٨ ملايين سنة. وهذا ربما يعزّز المعنى الرمزي للمكان: الصحراء في هوبال ليست مجرد جغرافيا، بل أرشيف طبيعي صامت، يحتفظ بذاكرة أعمق بكثير من عمر شخصيات العمل. الصحراء في هوبال تخلو من المدن، من الطرق، من الضوضاء، ولكنها مملوءة بما لا يُقال! كأن الشخصيات تمشي فوق ذاكرة قديمة مطموسة، لا يعرفون أنهم يكرّرون ما جرى فيها من صراعات، عزلات، وتمزقات.
«ليَّام»، الجدّ، لا يمنع العائلة من مغادرة المكان فقط، بل يمنعهم من مغادرة هذه الذاكرة الموروثة بصمت، كان صراع الأبطال مع جدل التمدن والقيامة! لهذا تحديدًا تُصبح السينما هنا أكثر من مجرّد قصة، بل وسيلة لاستدعاء ذاكرة لم تُكتب أبدًا. ذاكرة لم تُسجّلها دفاتر العائلة، ولا تحكيها الجدّات، لكنّها مرسومة في التربة، وفي الكثبان، وفي تجاويف مثل «الدحل»، الذي اختفى فيه ليَّام وكأن الأرض نفسها ابتلعته. وهنا إشارة اخراجية لطيفة رماها الشلاحي. دائما هنالك فرجة نحو السماء تساعد ابطال العمل على تحمل تراجيديا الحياة. ولكن ويا لهذه التراجيديا الحياتية القاسية، هذه الفرجة تخبرنا بموت الأب، وأيضا موت الحفيد في استمرار مفجع لمعاناة الإنسان على هذه الأرض، فرجة الدحول وفرجة خزان صهريج المياه كلها كانت نافذة لشخصيات فقدت الحياة! وهي حالة ارشفة اجتماعية لذاكرة مطموسة على كل حال. كان الطفل عسّاف لا يتحرّك من منطلق حبه الفطري لريفة، بل كأنه يُنفّذ فعلًا تمرديًا لكسر دائرة الذاكرة حول اسطورة تاريخية ارتبطت بصراع الحضارة مع الموت. لقد قام عّساف بفعل انساني شجاع لكسر سلطة الأسطورة (التاريخ) في محاولة لاختراق المجهول، والاقتراب من الآخر، الحضارة، المستشفى، المدينة، ولكنّ هذه المغامرة لا تُكلّل بالنجاة. فما الذي حدث؟ ريفة المريضة تُشفى، وعسّاف الشجاع يموت! والرسالة هنا ليست مأساوية وحسب، بل تُفصح عن سخرية مؤلمة في منطق الخروج: إنّ إنقاذ الحياة قد لا يُجدي نفعًا لمن خاطر لأجله، وقد يدفع الثمن من كسر الصمت، لا من سبّبه.
في هذه المفارقة القاسية - أن ريفة تُشفى ويُدفَن عسّاف - لا يقدّم الشلاحي خاتمة مأساوية فحسب، بل ينصبّ في قلب فعل التذكّر نفسه. ماذا تعني الذاكرة عندما لا تبقي من البطولة سوى الغياب؟ وما قيمة التضحيات إن لم تجد من يرويها أو يتذكّرها؟ يبدو أنّ الفيلم لا يعرض موت عسّاف كفشل، بل كأقصى درجات التحقّق الأخلاقي للذاكرة الجمعية. في المجتمعات التي تُقيّد الفرد باسم الجماعة، يُصبح الخروج من السرد الرسمي فعلاً مكلّفًا، لأن الذاكرة هناك لا تَمنح الحياة، بل تُنقّحها. عسّاف لا يُخلّد لأنه نجا، بل لأنه واجه! وتمرده لم يكن فقط على الجدّ؛ بل على نمط من الحياة اختار النسيان وسيلة للبقاء. وهذه هي الذروة التراجيدية في «هوبال» والتي تعيد تعريف التذكّر بوصفه فعلًا لا يتعلّق فقط بمن يبقى، بل بمن غاب وبقي أثره. والسينما، حين توثّق هذا المشهد، فإنّها لا تُنصف عسّاف فقط، بل تعيد توزيع العدالة الرمزية على من ماتوا بصمت. بهذا المعنى، يصبح موت عسّاف صورة معكوسة لذاكرة لم تُعطَ فرصة أن تُكتَب. وهنا بالضبط تكتمل وظيفة الفيلم: ليس أن يُنقذ الشخصيات، بل أن يُنقذ قصصهم من الاختفاء. تبدأ عائلة الجدّ ليام بالتشقّق، ليس لأن ليام «اختفى» بل لأن سلطته لم تعد صالحة لإدارة الأزمة. وفي هذا التمزّق الداخلي، تظهر المرأة - ممثلة في ميلا الزهراني - كصوت جديد أكثر عقلانية، أكثر ارتباطًا بالواقع. تقود السيارة، تبادر بالحل، وتحاول أن تعيد الجماعة إلى الحياة، لكنّ تعنت الرجل الآخر (زوجها) أدى إلى خسارتها. بهذا الشكل، تُعيد السينما تذكّر صورة العائلة السعودية التقليدية دون إدانة تقليدية، ودون تبسيط مخلّ. الانقسام هنا لا يُقرأ فقط على أنه درامي، بل هو تشخيص دقيق لمجتمعٍ عاش تحت سلطة دينية رمزية طويلة، ثم ها هو بدأ يتغير ثقافيًا بهدوء.
ويا للأسف، هذه المحاولات العقلانية لا تُكلّل بنجاح دائمًا. فالعائلة، رغم نواياها، تجد نفسها في نهاية المطاف أمام تراجيديا الحياة نفسها، تلك التي لا تفسير لها سوى أنّها الحياة. في لحظة خاطفة من أحد مشاهد الفيلم التي بقيت عالقة في مخيلتي، حيث تلدغ العقرب جسد ريفة، وكأن الصحراء - التي احتمت بها العائلة دهورًا - قرّرت معاقبتهم على ولائهم، أو على إخلاصهم الأعمى لذاكرة ظنّوها تحميهم. إنها لحظة تفجّر فيها الطبيعة عنفها، وتكشف عن لامبالاتها المطلقة بحكمة الجدّ، ونيات الشاب، وخوف الأم. هنا لا يعود الخطأ بشريًا فقط، بل كأنّ العالم نفسه يتآمر على من يثق به. وهذه هي تراجيديا الوجود كما فهمها نيتشه: ليس هناك خلاص، ولا وعد بالحماية، بل مجرد اختبار دائم لمعنى أن تكون حيًّا، وسط كون لا يُفسّر، ولا يُكافئ. ولهذا أمرنا نيتشه أن نُقبل على الحياة بعينين مفتوحتين، أن نتحمّل ضرباتها لا لأننا نستحقها، بل لأنّنا اخترنا أن نعيش. أمّا ما عدا ذلك، فهو - كما يقول - مجرد أضغاث أحلام. الذاكرة الجمعية في «خمسون ألف صورة» وفيلم «هوبال» تنوّعت بين نموذجين: أحدهما يستدعي الماضي من صورة، والآخر يخلقه من فراغ. وهذا ما يمنحنا فرصة نادرة لفهم كيف تتحوّل السينما إلى أداة لأرشفة التجارب الاجتماعية، لا الحقائق المؤرشفة. لذاكرة الألم والتراجيديا وجوه كثيرة. ولكنّها في فيلم «خمسون ألف صورة» تكتسي وجهًا يتعلق بالفقد الرمزي. فالشاب لم يفقد صور والده فقط، بل فقد القدرة على التعريف والانتماء والتواصل. الصورة لم تعد أداة للنظر، بل سبيلًا لإنشاء وعي بالذات. ومن هنا تعود السينما لتجسّد أهم أدوارها الرمزية: إنقاذ ما تركه المجتمع خلفه من تجارب بلا لغة.
الماضي هنا لا يُستدعى، بل يُعاد تخيّله. أفلامنا في هذه المقالة لا تعرض وثيقة محذوفة، بل تخلق سرديّة كاملة لزمن مفقود لم يوثّق أصلًا. السينما لا تُرينا ما حدث، بل ما كان يمكن أن يحدث. وهذا بالضبط هو معنى «الأرشفة الرمزية» في «خمسون ألف صورة»، التهديد يأتي من الفقد – من الصور التي مُزّقت أو أُحرقت أو فُقدت بسبب فتاوى متشددة، أو ضغوط اجتماعية. أما في «هوبال»، فالتهديد يأتي من الصمت – من سلطة الجدّ، ومن الخوف من الآخر، ومن هشاشة الفرد داخل الجماعة. الفيلم لا يُخبرنا فقط بما غاب، بل يُظهِر كيف يمكن أن تُمحى التجارب داخل المجتمعات المغلقة، حتى وإن لم يعترضها خطاب رسمي مباشر. هكذا نجد أننا في مواجهة عملين ينطلقان من لحظة افتقاد: في الأول، افتقاد للصور؛ وفي الثاني، افتقاد للغة. لكن كليهما يحاول – بطريقته – ترميم هذا الافتقاد عبر السينما نفسها. وفي حالة السعودية، حيث الذاكرة الجمعية تعرّضت لمراحل من الكبت الذاتي، وإعادة التشكيل بفعل الخطاب الديني أو السلطة الاجتماعية، يصبح للفيلم السينمائي دورٌ مزدوج: كشف المسكوت عنه، ومنح الشكل لما لم يتشكّل بعد. فيلم «خمسون ألف صورة» لا يُرينا الصور من أجل الحنين فقط، بل يعرضها بوصفها أداة مقاومة ضد سلطة النسيان. وفيلم «هوبال» لا يسرد قصة عائلة، بل يعرض سيناريو محتملًا لذاكرة صامتة، قد تكون عاشت بيننا دون أن ننتبه.
إنّ السينما هنا لا تقدّم أجوبة، بل تطرح أسئلة على الذاكرة: ما الذي حدث فعلًا؟ لماذا نسيناه؟ وكيف نمنحه الآن صورته الجديدة؟ ومن هنا، تُطرح وظيفة السينما كمختبر جمعي لإعادة بناء الهوية: حين تتكلّم الصورة، لا تكون فقط توثيقًا، بل إعادة توزيع للمعنى داخل الجماعة. وهذا – بحد ذاته – هو أهمّ أدوار الفنّ حين يغدو شكلًا من أشكال الوعي. في المجتمعات التي افتقدت يومًا ما إلى تقاليد الحفظ - كالذاكرة الفوتوغرافية للعائلة، أو التسجيلات الصوتية لقصص الجدّات - تصبح السينما أداة تعويضية. إنها لا تُنافس الذاكرة المرويّة بل تُكملها، وتمنحها بُعدًا حسيًّا جديدًا. فمشهد واحد في فيلم، يمكن أن يختصر مئات الكلمات، ويعيد تشكيل تجربة معاشة، حتى وإن لم تُحكَ من قبل. ولهذا فإنّ ما تفعله السينما ليس فقط إنقاذ ما كاد يُنسى، بل اختراع طريقة جديدة للتذكّر، تتجاوز أدواتنا التقليدية، وتحرّر الذاكرة من قيد الحكاية اللغويّة وحدها. بل إنّها، في كثير من الأحيان، تمكّن المجتمعات من إعادة التفاوض مع ماضيها، من دون الحاجة إلى إعادة كتابته رسميًا أو إعادة فتح جراحه. وهذا ما يجعل السينما وسيطًا مرنًا، قادرًا على أن يحمل الحنين دون أن يتحول إلى بكائيات، وأن يطرح الأسئلة دون أن يتورّط في خطاب اتهامي مباشر. إنّها تفتح المجال لتذكّر يتجاوز السياسة والتاريخ الرسمي، ليصل إلى مناطق الشعور، والهواجس الجمعية، وما لم يُقل صراحة في الذاكرة الثقافية. في النهاية، لا يمكن للسينما أن تكتب كل شيء، لكنّها تستطيع أن تقول الكثير عمّا لم يُقَل. وما دامت الذاكرة لا تُبنى بالوثائق فقط، فإن الأفلام الجيدة، الصادقة، العميقة، المجازفة، تظل وسيلتنا الأهم لاستعادة ما خسرناه، والتصالح مع ما لم نجرؤ على سرده بعد. وبين الحكاية والرؤية، بين الصوت والصمت، وبين الصورة والفراغ، ستظل السينما – كما نأمل –الأداة التي تعيد فتح دفاتر الذاكرة، لا لتكتب فيها، بل لتجعلنا نقرأ أنفسنا من جديد.
خاتمة: إنّ السينما ليست مجرد مرآة تعكس ما مضى، بل حالة نُعيد من خلالها اختراع ما لم يُعَش بالكامل، وما لم يُكتب يومًا بوصفه حدثًا ذا قيمة. لقد حاولت هذه المقالة ابراز أنّ الذاكرة الجمعية ليست وعاءً محفوظًا وحسب، بل بناء رمزي متجدّد، تشكّله الحكايات والصور والانفعالات الجمعيّة. وما قامت به أفلام مثل «خمسون ألف صورة» و«هوبال»، هو إعادة منح الصوت للخبرات الصامتة، والتجارب المنسيّة، دون أن تدّعي امتلاك الحقيقة، بل بجرأة تأويلها عبر الصورة. وإذا أدركنا أن المجتمع السعودي يعيش اليوم تحولات متسارعة في أنماط تمثيله لذاته وتاريخه، فإنّ للسينما دورًا في تعزيز الوعي الجمعي، لا بوصفها ترفًا بصريًا فقط بل إدارة للتذكّر أو بما يمكن أن ندعوه (ذاكرة التجارب).
المراجع
1- بول ريكور، الذاكرة، التاريخ، النسيان، ترجمة: جورج زيناتي، دار الكتاب الجديد، ٢٠٠٩م.
2- جان بودريار، المصطنع والاصطناعي، ترجمة: جوزيف عبد الله، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ٢٠٠٨م.
3- فريدريك نيتشه، هكذا تكلم زرادشت، ترجمة: فليكس فارس، دار الاهلية، الأردن عمان،٢٠١٦م.
4-Encyclopedia Britannica – Iconoclastic Controversy,
https://www.britannica.com/event/Iconoclastic-Controversy