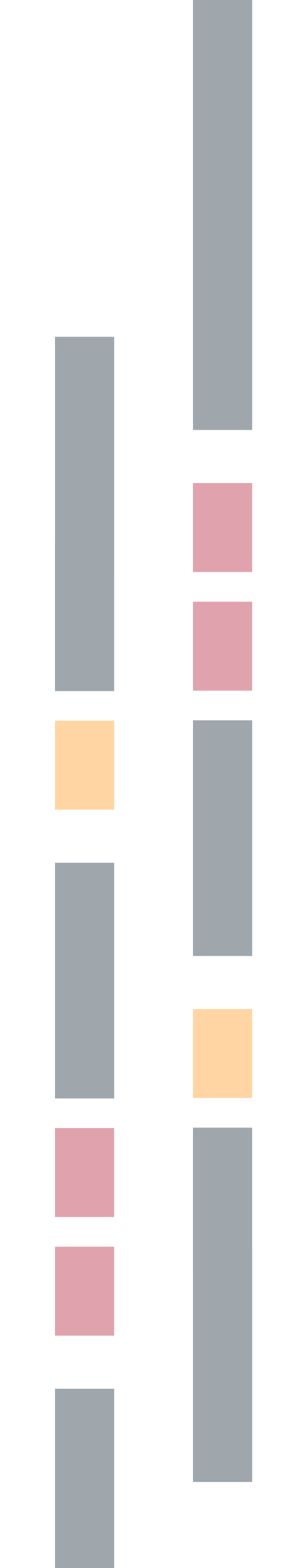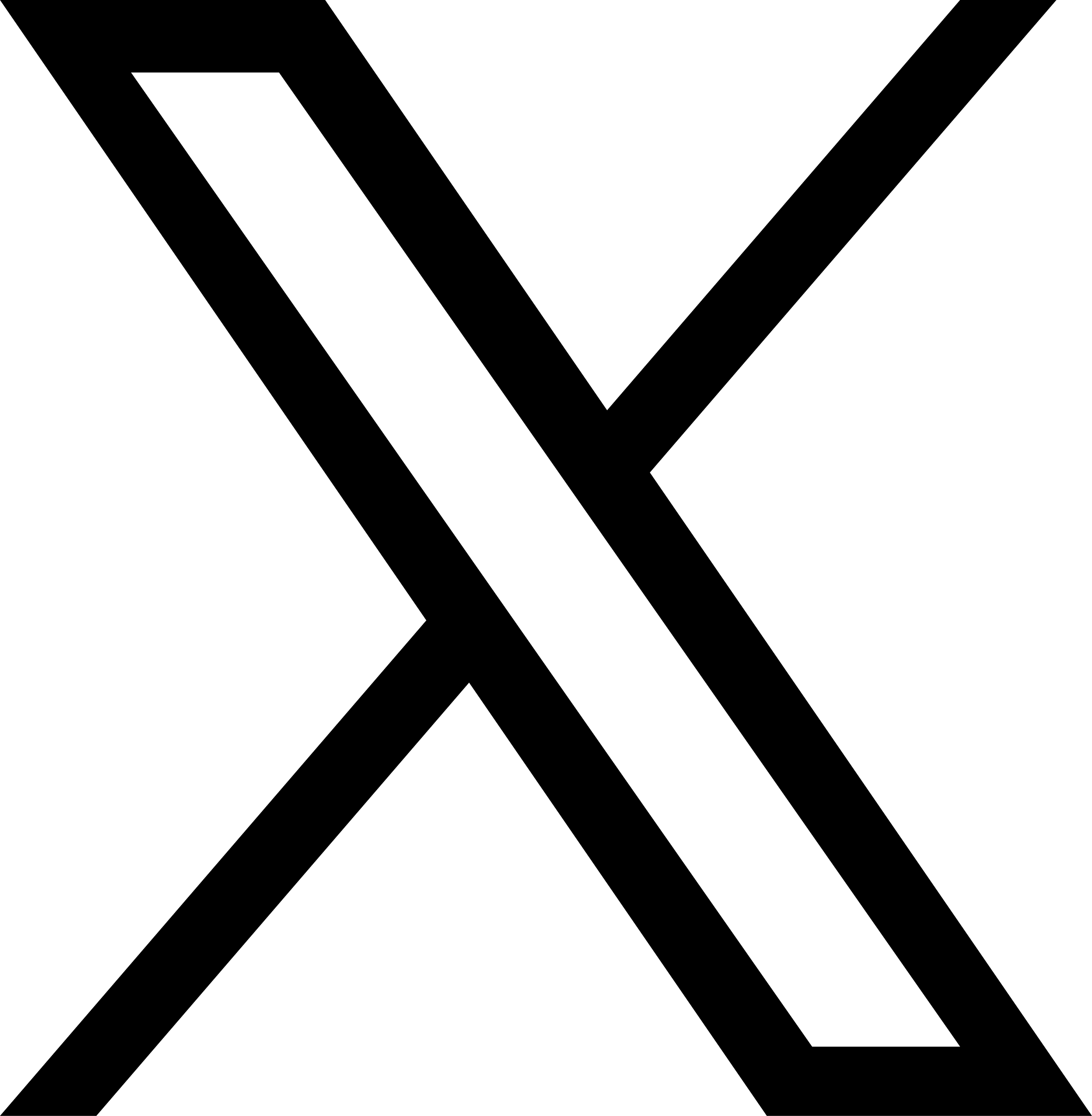شارك
العلاقة بين الفلسفة والسينما والشعر راسخة وجدلية في الوقت نفسه، هذا ما يشدد عليه روبرت سينربرنك، في كتابه «فلسفات السينما الجديدة»، كل مفكري السينما الأوائل -يضيف سينربرنك- «مارسوا التأمل الفلسفي، الذي تمحور حول السينما بوصفها فناً ووسيطاً».[1] من هنا يذهب ستانلي كافيل إلى أن الفيلم يلتقي بالفلسفة في النزعة الشكوكية، وإذا كانت المساءلة والقلق من عمق اهتمامات الفلسفة فإن بإمكان الفيلم أن يقدم رؤى فلسفية خاصة به، ولذلك ينبه توماس واتنبيرغ: «يجب على أولئك الذين ينكرون أن الأفلام يمكن أن تتقمص دور الفلسفة أن يعوا أن الأفلام توفر للجمهور مدخلاً إلى الأسئلة الفلسفية وقضاياها».[2]
يفتتح الشاعر السعودي حمزة شحاتة إحدى قصائده بالتساؤل:
أخير سبيليك التي تتجنبُ..؟!
يأخذنا هذا التساؤل الشعري الفلسفي إلى التفكير في تلك الطريق التي لم نسلكها وسلكنا غيرها، وفي ذلك الخيار الذي تركناه لنتخذ غيره. هل كانت الطريق المهجورة والخيار المتروك أفضل مما سلكنا، ومما اتخذنا. لا يبدو هذا التساؤل واقعيًا، لكنه يأخذنا إلى آفاق من إعادة التفكير والقلق الوجودي حول حالة الرضا التي يعيشها أو لا يعيشها الإنسان في حياته. فيلم «السيد لا أحد Mr. Nobody» الصادر عام 2009 يلتقط هذه القضية، ويضعها تحت المجهر، ليناقش أبعادها بشيء من التفلسف الجميل. يحكي الفيلم عن رجل طاعن في السن يتذكر تفاصيل حياته بطريقة مختلفة قليلاً؛ حيث يفكر في تلك الاحتمالات المتروكة، منذ كان طفلاً في التاسعة من عمره، يقف بجوار قطار مغادر. كان الطفل حائرًا بين أن يغادر مع والدته الغاضبة من أبيه، أو أن يبقى مع أبيه. الجميل في الفيلم أنه يعيد بناء الحيوات انطلاقًا من تلك الخيارات المهملة، ليجيب -بطريقة أو بأخرى- عن ماذا كان سيحدث لو اتخذ البطل هذا القرار أو ذاك. يثير الفيلم قضايا مهمة تتناول دور القرارات في توجيه أقدارنا، كما تشكك في قدرة الإنسان على السيطرة على حياته وعلى مستقبله.
وفي فيلم درامي بريطاني ظهر في العام 2019 تحت عنوان « Hope Gap - هوّة أمل»، تُلقي الممثلة الأمريكية آنيت بنينق Annette Bening، قصيدة «Sudden Light - ضوء مفاجئ» لشاعرها دانتي روزيتتي Dante Rossetti بإتقان وإحساس عالٍ:
كنت هنا من قبل!! متى وكيف.. لا أستطيع أن أقول! أعرف العشب.. حول باب الدار الرائحةَ الحلوة الطاغية صوتَ التأوه.. والأضواء حول الشاطئ..!!
I have been here before, But when or how I cannot tell I know the grass beyond the door, The sweet keen smell, The sighing sound, the lights around the shore
يتناول الفيلم قصة زوجين يفترقان بعد زواج دام تسعة وعشرين عامًا، ويركز على الفترة القاسية التي عاشتها الزوجة «بنينق»، بعد أن قرر زوجها الانفصال، يقوم بدور الزوج البريطاني بيل ناي- Bill Nighy. وبعيداً عن مستوى الأداء المذهل للبطلين، تأتي قصيدة روزيتتي لتكون علامة فارقة في تحوّل الحكاية. فالزوجة، رغم نزقها الشديد واختلاف طباعها الواضح عن الزوج الهادئ المسالم جداً -وربما السلبي-، ترفض أن تستسلم لقراره بتركها، والعيش مع امرأة أخرى.
كان منطلق الزوجة في الجدال ومقاومة الانفصال، أن هذا القرار يخصها أيضًا، ولا يمكن للزوج أن يتخذه منفردًا، في محاولة للتشبث بالأمل والنجاة. وهنا ستأخذنا القصيدة إلى أفق آخر، حيث يستمر السارد فيها يحاور نفسه حول المكان والتجربة التي يشعر أنه يعيشها مرة أخرى، ليأتي المقطع الأخير في النص، يوضح أن الحب أكبر من أن يُنسى، أو يغيب، وأن الموت -وهو الموت- لن ولا يستطيع أن يهزم الحب. لا تنجح الزوجة في إنقاذ الزواج، وتغيير قرار الزوج، ورغم ذلك سيظل الحبُّ الصيغةَ السحرية للإنسان في مواجهة الفناء، وإكسيرَ الخلود الذي تقترحه القصيدة في نهايتها، حيث تستمر وتتوالد قصص الحب، التي تربط الإنسان بالإنسان، وتجذره في الوجود، فيصبح قيمةً أكبر من أن ينتزعها الموت.
هكذا تكون القصيدة أداةً مهمة في الفيلم، من أجل تحقيق غايته، وإيصال رسالته، وهكذا تتفاعل السينما مع الشعر وتوظفه مستفيدة من طبيعته التي تمكنه من لمس جوهر الأشياء، والتعامل مع الوجود ومكوناته باعتبارها عناصر مرنة يستطيع صهرها وترويضها لتعبّر عن قيمه العليا وصراعاته «الصغير منها والكبير»، وتساءل قضاياه مساءلة فلسفية الطابع، تتسرب نحو عمق القضايا، ولا تكتفي بظواهر الأشياء.
تشترك السينما مع الأدب في القصة التي ترويها، وفي طريقة سردها بأدوات مختلفة، وفي مساءلتها ونقدها للواقع، عبر صنع واقعٍ موازٍ. وإذا كان الشعر يعتمد على لغة تخييلية مخاتلة، تتخذ من التورية منطلقًا، ومن الاستعارة جوهرًا «لا يعني الشعر ما يقول فعلاً ولا يتلقاه المتلقي بناء على ظاهر القول»، فإن السينما تعتمد على تورية ثقافية/سردية، حينما تصنع عالمًا موازيًا، وتحكي قصة تشبه قصص الواقع، لكنها مبنية على مساءلة هذا الواقع، ونقده.
من المهم التذكير دومًا بأن السينما تخلق جوًا خاصًا، يمكّنها من إيصال رسالتها -أو رسائلها- عبر قالب جذاب وممتع. إن واحدة من أهم المزايا التي تذكر للسينما هي أن مرتاديها يتركون كل شيء، ليقضوا ساعتين أو أكثر في غرفة مظلمة تماماً، يثبتون فيها أعينهم نحو شاشة تستمر في بث الرسائل والصور. وكثيرًا ما تأتي هذه الرسائل والصور على صيغة عبارات مكثفة ومشحونة بالحكمة والشاعرية التي تأخذ متلقيها نحو آفاق من التأمل والتفكير العميق. يقول كارل ماركس الصغير The Young Karl Marx, 2017: «كل شيء عرضةٌ للتغيير، لا شيء يدوم». فتسوق العبارة خيال المشاهد نحو هذا الوجود الذي يخلو من أي حقيقة ثابتة فيه سوى التغير. ونشاهدُ شون كونري Sean Connery وهو يؤدي دور الشاعر المتخيّل ويليام فورستر في فيلم «البحث عن فورستر- Finding Forrester، 2000»، ويقول: «نحن نهرب من أحلامنا لأننا نخشى أن نفشل، أو الأسوأ من ذلك، لأننا نخشى أن ننجح». فلا نستطيع أن نسيطر على عقولنا وهي تسبح في عمق هذه العبارة وأبعادها.
إن واحدة من نقاط قوة السينما -في رأيي- تكمن في انفتاحها على الحياة، باعتبارها مفهومًا واسعًا للتفكير، والاختلاف، والمضي قدمًا. تقدم السينما في كثير من جوانبها محتوى مغايرًا، مخالفًا للسائد، ولا تنقصه الحكمة مع ذلك. الفيلم السينمائي في رأيي شيخ خبير فهم الحياة كما يجب، وعرف قدره فيها، وحظه منها. شيخٌ يتلبّس مرةً مارتن لوثر كينغ - Martin Luther King، الذي يؤدي دوره البريطاني ديفيد أويلوو - David Oyelowo في فيلم «سِلما – Selma، 2014»، يتلبّسه في آخر أيامه وهو يعلن «نحن لا نعيش حياتنا بشكل كامل إذا لم نكن مستعدين للموت من أجل من نحبهم، ومن أجل ما نؤمن به»، وأخرى يختار لينطق بلسان عالم الفيزياء العجيب -بتجربته الصعبة وكشوفاته العظيمة- ستيفن هوكينغ، وهو يذكرنا بإصرار: «يجب ألا تكون هناك حدود للمساعي البشرية. نحن جميعًا مختلفون، ومهما بدت الحياة سيئة، فهناك دائمًا شيء يمكنك القيام به، والنجاح فيه. طالما هناك حياة، فهناك دومًا أمل». وتارة يختار شيخ السينما شيخاً غريب الأطوار والتجربة، كان عمره يتناقص فيما تزداد أعمار الناس. إنه بِنجامين بوتِن «براد بيت- Brad Pitt»، بطل فيلم «الحالة الغريبة لبنجامين بوتن- The Curious Case of Benjamin Button، 2008»، ذلك الذي ولد عجوزًا ومات طفلًا رضيعًا بعد أن شاهد كل من حوله يشيخون ويقضون هرمًا، ليذكرّنا دومًا: «إنها الفُرَص هي ما يصوغ حيواتنا، بما في ذلك تلك الفرص التي نُــفوّتها».
ولعل هذا كله ما دفع الفيلسوف الفرنسي المهم جيل دولوز ليعدّ ظهورَ السينما حدثًا علميًا مهمًا، ومرحلة من مراحل تطور مفهوم الحركة العلمي: العلاقة بين المدار والزمن اللازم لقطعه عند كيبلر، مسافة سقوط الأجسام وعلاقتها بزمن السقوط عن غاليلي، نقطة ديكارت على الخط المستقيم المتحرك، الحساب المتنامي الصغر عند نيوتن ولايبنز، «في كل مكان، كان التعاقب الآلي للحظات يحل محل النظام الجدلي للوضعيات»، و«يبدو أن السينما هي فعلاً المولود الأخير لهذه السلالة».[3]
من هنا يرى دولوز أن السينمائيين يؤدون دورًا لا يقل أهمية عن دور العباقرة. يقول: «لقد بدا لنا أن كبار كتّاب السينما يمكن مقارنتهم لا بالرسامين والمعماريين والموسيقيين فحسب، بل بالمفكرين أيضًا. ذلك أنهم يفكرون من خلال الصورة/ الحركة والصورة/ الزمن بدل أن يسوّقوا المفاهيم».[4] يركز دولوز على هذا الدور التنويري النقدي للسينما، إذ يراها «ومن دون أن تكتفي بوعي سلبي نقدي أو ساخر، انخرطت في أعلى درجات التفكير، ولم تكفّ عن تعميقه وتطويره».[5] وبذلك تكون «السينما بحد ذاتها ممارسة جديدة للصور والعلامات التي يترتب على الفلسفة أن تصوغ لها النظرية كممارسة تصورية».[6]
في مقدمة كتابهما المهم «السينما والفلسفة» يتساءل داميان وكوكس ومايكل ليفين، إن كان في وسع الأفلام أن تصبح أدوات للاستقصاء الفلسفي؟ ويأتي هذا السؤال تتويجًا لأسئلة سابقة مطروحة في الكتاب، منها: ما الذي يميّز السينما أو التصوير السينمائي بوصفه شكلًا فنيًا؟ ما المغزى الفلسفي وراء الأساليب الفنية والتكنولوجيا التي توظفها السينما؟ ويطرق المؤلفان سؤالًا إضافيًا مهمًا: ما المغزى الفلسفي لاستجابة الجمهور للسينما؟
يتطرق المؤلفان إلى العوامل التي تجعل من السينما ظاهرةً ثقافية مؤثرة على نطاق عالمي واسع جدًا؛ فهناك في البدء القبول الجماهيري العظيم لهذا الفن غير النخبوي إن صح التعبير. تنتمي السينما للناس، للشعوب، ومن هنا تكون أعداد المتابعين للأفلام، والمهتمين بها، وبمناقشة قضاياها أكبر من أعداد قراء الكتب، كما أن لدى السينما دومًا القدرة على تجاوز الحدود والحواجز بين أطياف المجتمع وطبقاته الاجتماعية والاقتصادية؛ فجمهور السينما يأتي من كل مكان دون اعتبار للخلفية الاجتماعية، بينما تجذب بعض الفنون -مثل الأوبرا- اهتمام شرائح معينة دون أخرى.
هذا يعود لأسباب عدة، لعل أهمها أن عروض الأفلام أقلّ كلفة من غيرها، بحيث يمكن لمحدودي الدخل، والفقراء كذلك، متابعتها. غير أن هذه الشهرة تعود بطبيعة الحال إلى مادتها، التي تعتمد على الحكايات في تحليل القضايا الأخلاقية وإثارة التساؤلات العامة والفلسفية، بطريقة جذابة ومشوقة. «فهي متاحة بسهولة، وغالبًا ما تتمتع بجاذبية جمالية، فضلاً عن كونها مسلية من نواح تجعلها مؤثرة من الناحية العاطفية والفكرية والذهنية».[7]
وينقل الكاتبان عن والتر بينجامين رأيه في «قدرة السينما على دعم الحرية السياسية والاجتماعية والفكر الإبداعي».[8] ». في المقابل هناك مخاوف أخلاقية من السينما في أن تتلاعب بالناس، وتحدد توجهاتهم عن طريق الهيمنة والدعاية المكثفة، وأن تكون ضمن البروباغندا المؤدلجة، وتبث الاضطراب في الناس كذلك.[9] في الفصل الثاني من كتابه الشهير «ثقافة الوسائل - Media Culture» يوضح الناقد الثقافي دوغلاس كلنر عبر التحليل النقدي كيف أن أفلام هوليود الأمريكية في عصر الرئيس ريغان أسهمت في إعادة هيمنة الخطاب المحافظ على العصر.[10] هذا يعني أن الأعمال الفنية -والأفلام من أهمها- أدوات مهمة في صياغة الوعي الجماهيري الحديث، أدوات مهمة وخطيرة في الوقت ذاته. وسط هذه المفارقة بين دعم السينما للحرية وتقييدها بالهيمنة على عقول المشاهدين، تقدم السينما مزيجًا هائلًا من القصص والتجارب ووجهات النظر والفرضيات الفلسفية. «إن جزءًا مهمًا من منهج السينما في ممارسة الفلسفة هو قدرتها على تجسيد الحُجة بطرق وجدانية؛ أي بطرق تحقق تجاوبًا عاطفيًا لدينا إلى جانب التجاوب الفكري.
والمشاعر التي يولِّدها الفيلم قد تُركز انتباهنا، وتمكِّننا من ’رؤية‘ أو تقدير جوانب من حُجةٍ ما كانت لتُطرح جانبًا في أحوال أخرى».[11] يشدد مؤلفا الكتاب على أهمية الرغبات والمشاعر -أحيانًا أكثر من المنطق والدليل- في توجيه مسألة التصديق، خصوصًا في المظاهر التي لا تقوم على التجريب والرؤية بالعين، يفرض هذا المكون الوجداني نفسه في الحديث عن تشكيل الفكر وتوجيهه: «تستطيع بعض الأفلام مع بعض الأشخاص في بعض الأحيان توليد نوع من التيقُّظ والتبصُّر الوجداني الذي قد يزعزع ولاءات وافتراضات سابقة حتى في وقت ظن فيه أصحابها أنها قائمة على أسس فكرية وعقلانية».[12]
وأخيراً يذكّرنا الكتاب بأن ’الأسئلة الأخلاقية‘، والقضايا التي تتناولها الفلسفة، وتمثّل مباحثَها المختلفة، توجد بدايةً في الحياة العادية، التي تقتنص السينما قصصها منها. إن هذه القصص هي قصصنا وتجاربنا الخاصة، تطرحها السينما، وتحاكيها، وتحاورها بطريقتها الخاصة، وهو ما يعني أن الحياة هي الصلة بين الفعل السينمائي والفلسفي. وكما هو الأدب فإن «السينما وسيط يوظف أساليب متعددة، ليست جميعها من صنعها، كي تُجسِّد القضايا الفلسفية كما تُثار، أو كما قد تُثار، في الحياة وفي الخيال. بل إن قدرة السينما على تصوير الحياة كما تبدو في الحقيقية وفي الخيال — والحياة دائمًا ما تكون خيالية بدرجة ما — هي ما تشكل الصلة الجذرية بين الفلسفة والسينما».[13]
المراجع:
[1] روبرت سنيربرنك، فلسفات السينما الجديدة: صور تُفكر، ت. نيفين حلمي، (الرياض: دار معنى، 2021)، ص20. ويوفر الكتاب وجبة دسمة للمهتمين بالعلاقة بين السينما والفلسفة، وهو يهدف كما يعبر مؤلفه إلى "عرض أهم التطورات في فلسفات السينما المعاصرة، والدعوة إلى طرق جديدة للتفكير في العلاقة، ومحاولة استكشاف علاقة قادرة على إحداث تغييرات أكبر في كلا المجالين". (ص24).
[2] توماس واتنبيرغ، فلسفة الفيلم، موسوعة ستانفورد للفلسفة، ت. محمد الحربي، مجلة حكمة، 2017، ص16.
[3] جيل دولوز، سينما: الصورة-الحركة، ت. جمال شحيد، ج1، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2014)، ص20-21.
[4] السابق، ص14.
[5] السابق، ص391.
[6] السابق، ص448.
[7] داميان وكوكس ومايكل ليفين، السينما والفلسفة: ماذا تقدم إحداهما للأخرى، ت. نيفين عبدالرؤوف، (لندن: هنداوي، 2018)، ص16.
[8] السابق، ص17.
[9] ا السابق، ص18.
[10] Douglas Kellner, Media Culture, (London-New York: Routledge, 1995), p. 62-75.
[11] داميان وكوكس ومايكل ليفين، السينما والفلسفة: ماذا تقدم إحداهما للأخرى، ص30.
[12] السابق، ص31.
[13] السابق، ص32.