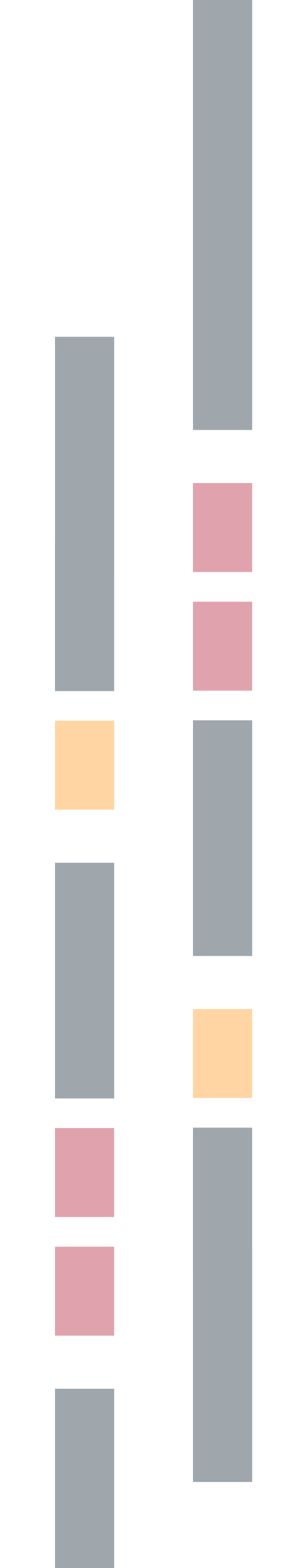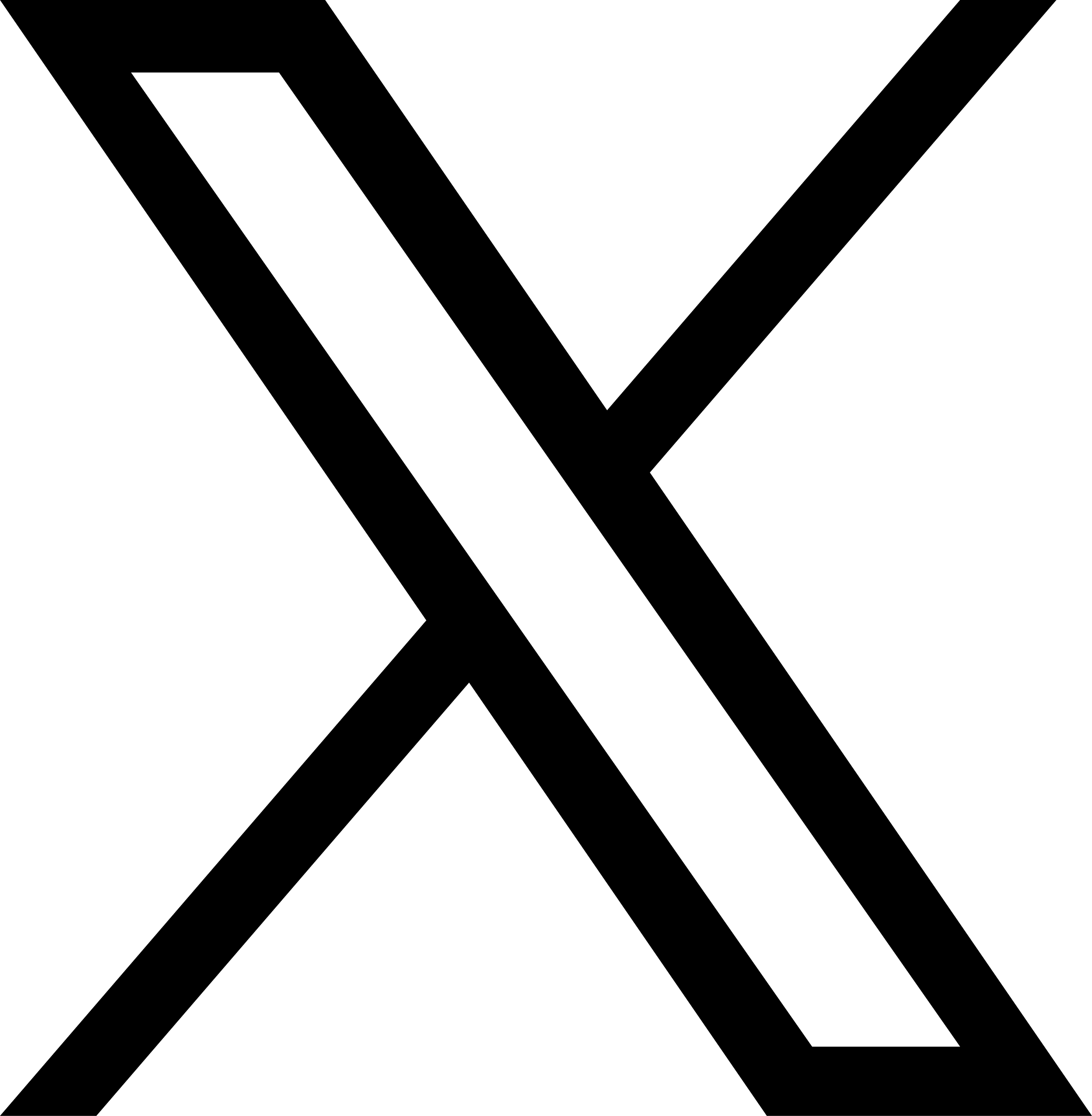شارك
لا تقوم الأسطورة على الخيال وحده، بل على إرادة الإيمان به، تلك الرغبة العميقة في أن يكون للعالم نظامٌ يدرك، وللحياة معنى يتجاوز زوالها، وللحدث الفردي قيمة تتجاوز سياقه العابر. فقد كانت الأسطورة منذ قديم العصور الوسيلة التي منحت الإنسان القدرة على تجاوز محدوديته الزمنية، لا بوصفه حكايةً تروى، بل بنيةً رمزية تؤسس للمجتمع، وتبلور مفاهيم القوة، وترسم حدود الممكن والمستحيل.
وعندما وُلدت السينما، فإنها لم تكن سوى امتداد لهذه النزعة الإنسانية في إعادة تشكيل الواقع من خلال السرد، لكنها لم تكتفِ بأن تكون مجرد وسيط جديد لنقل الأساطير، بل أصبحت الأسطورة ذاتها؛ اللغة البصرية الجديدة التي فرضت سطوتها على الوعي الجمعي. فقد امتلكت السينما ولأول مرة في تاريخ السرد القدرة على خلق وهم محسوس، على تقديم صورة متحركة تجعل المشاهد أسيرًا لها لا مجرد متلقٍّ. فكان هذا التحوّل إعادة صياغة جذريّة لكيفية إدراك الإنسان للواقع، إذ جعلت الأسطورة أكثر قوة، ليس لأنها زادت من سحرها، بل لأنها أزالت المسافة بينها وبين الحقيقة. فلم يعد المشاهد يروي الحكاية أو يتخيلها؛ بل أصبح يراها، كأنها تحدث أمامه، كأنها جزء من تجربته الشخصية. ومن هنا أصبح الوهم هو الحقيقة الجديدة.
ولطالما كانت الأسطورة نظامًا يستبدل العشوائية بالنظام، والفوضى بالمعنى، حيث كانت الوسيلة التي يواجه بها الإنسان ذاك المجهول، تعيد ترتيب الزمن، وتحوّل الماضي إلى سرد متماسك يبرّر الحاضر، ويحدد معالم المستقبل. لكن مع السينما، لم يعد الماضي محكومًا بالكلمات وحدها، بل صار مرئيًا ومحسوسًا ومتجسدًا. ولعل أوضح مثال على هذه القوة السينمائية هو «تأثير القطار» الذي أحدثه عرض فيلم وصول القطار إلى محطة لا سيوتا للأخوين لوميير. لم يكن المشاهدون خائفين لأنهم لا يفهمون ماهيّة السينما، بل لأنهم، وللحظة، لم يعودوا يميزون بين الوهم والحقيقة. لم يكن القطار يقترب، لكنه في وعيهم كان يفعل، ليس لأن الصورة خدعتهم، بل لأن السينما منذ لحظاتها الأولى شكّلت نظامًا إدراكيًا جديدًا، يعيد تعريف العلاقة بين الإنسان والواقع. ومنذ تلك اللحظة لم يعد السؤال المركزي في السينما هو: كيف نروي القصة؟ بل أصبح: من يمتلك الحق في روايتها؟ ومن يملك القدرة على فرضها كحقيقة نهائية؟
الصورة بوصفها نصًا أسطوريًا في فيلم «ليلة الصائد» لتشارلز لوتون في فيلم «ليلة الصائد» استحضر تشارلز لوتون في فيلمه الأول والوحيد أبجدية الأسطورة باعتبارها جوهرًا حيًا في نسيج السينما نفسها. وذلك من خلال سرد تجريدي عن الخير والشر، الذي يرتقي ليصبح استعارة بصرية مكثفة للصراع الأبدي بين الضوء والظل، والطفولة والوحشية، والبراءة والخطيئة. وفي وسط الصراع؛ وقف الطفلان بيرل وجون، اللذان وجدا نفسيهما في مواجهة قوة مخيفة تتجاوز قدرتهما على الفهم، في عالم ينهار فيه الأمان، وتتحول الأبوة إلى تهديد مطلق.
اعتمد لوتون في هذا الفيلم على جعل الصورة هي النص الحقيقي لصناعة أسطورته، فكل إطار هو إعادة تأويل لأبجديات الحكاية الخرافية: ظلال عملاقة تمتد كأنها مخلوقات متربصة، نهر يبدو وكأنه شريان منسي يفصل بين عالمين، وبيت يحتضن العتمة أكثر مما يبعث الطمأنينة. الصورة هنا هي بناء لعالم مشحون بالرمزية، فحين يهرب كل من بيرل وجون في القارب ليلاً، يغدو النهر بوابة عبور، مساحة بين الخطر والأمان، تمامًا كما في الأساطير القديمة التي يكون الماء فيها هو الحد الفاصل بين العوالم. فالنهر بظلاله الباردة، وحركته الصامتة، هو شاهد على الرحلة ومشارك فيها. وفي صلب الأساطير، يظهر الوحش دائمًا قوةً فوضوية تهدد النظام، كيانًا يختبئ تحت القناع؛ يقتات على الخوف، ويعيد إنتاج السلطة بطريقة قسرية. فالوحش هنا ليس قوة من خارج العالم، بل هو رجل يرتدي قناع القداسة، وواعظ يمثل الدين الفاسد الذي يطالب بالخضوع بدلًا من الخلاص.
هاري باول (روبرت ميتشم) الذي يشم على قبضته اليمنى كلمة LOVE - الحب، وعلى اليسرى كلمة HATE - الكراهية، هو تجسيد لثنائية بين الخير والشر التي لا تعترف بالمنطقة الرمادية. عن الاستغلال الذي يختبئ تحت عباءة الإيمان، وهو في حقيقته ليس سوى امتداد للعنف الذي يمارسه المجتمع ذاته، ففي المشهد الذي يظهر فيه ظله العملاق عبر نافذة الأطفال، لا يكون مجرد رجل يقف خارج الغرفة، بل ظلًا يخترق المساحة، إعلانًا مسبقًا عن انهيار الأمان، عن اقتراب الطوفان الذي لا نجاة منه إلا بالهرب. فالصورة هنا تعيد إنتاج أقدم المخاوف البشرية، للوحش الذي يقتحم الحيّز الحميمي، والذي لا يرى في البراءة سوى فرصة للسيطرة. وفي معظم الحكايات الخرافية، يكون الطفل في موقع المتلقي، أي المستمع إلى القصة، لكنّهم هنا هم أبطالها وصُنّاعها، مضطرون إلى إعادة تعريف أنفسهم في عالم يدفعهم غريزيًا إلى النجاة.
ولا يكتمل السرد الأسطوري دون حضور الملاك الحامي، المرأة التي تحتضن الأبطال المهدَّدين، التي تملك حكمة العالم القديم، والتي تقف جدارًا أخيرًا أمام الفوضى. راشيل هي أشبه بالملاك الحارس حين تعيد للأطفال عالمهم المختل. وعندما تواجه باول فإنها تواجهه كقوة معادلة، كصوت يفضح زيفه، كضوء يحرق ظله المتضخم. في المشهد الذي تغنيّ فيه الترتيلة ذاتها التي يغنيها باول «متكئًا على الأذرع الأبدية» فهي تفعل ذلك بصوت مختلف، لتكون المواجهة بين حقيقتين، بين الإيمان المزيّف والإيمان الأصيل، بين الشر الذي يقتات على الضعف، والخير الذي ينمو في الثبات. في الحكايات الخرافية التقليدية، ينتهي كل شيء باستعادة النظام، لكن في هذا الفيلم، لا يبدو أن هناك نظامًا يمكن استعادته. فالشر لم يُهزم تمامًا، والماضي لا يمكن نسيانه، والطفولة التي فُقدت لا تعود.
أسطورة العشق العائم في «الأطلنطي» لجان فيغو، أو الأسطورة باعتبارها فعلًا سينمائيًا
عند الحديث عن الأسطورة السينمائية، غالبًا ما نستدعي الأفلام التي تعيد إنتاج السرديات التي تعيد تجسيد الأحداث ضمن منظومة رمزية تتجاوز الواقع كما في «ليلة الصائد». ولكن جان فيغو، في فيلمه «الأطلنطي» يقدم نوعًا آخر من الأسطرة السينمائية؛ يصوغ فيه أسطورة الحميمية، حيث يتحوّل العشق الزوجي فيها إلى رحلة تيهٍ وجودي، والنهر إلى فضاء مقدس يعيد تشكيل علاقات الشخصيات لا وفق قوانين المنطق التقليدي، بل تبعًا لديناميات الرغبة والذاكرة والغياب. لفيلم «الأطلنطي» بناء سينمائي ينسج بين الواقعي والميثولوجي، فالسفينة التي تحمل اسم الفيلم تصبح رمزًا للزواج بوصفه كيانًا مغلقًا، منفصلًا عن العالم، لكنه في الوقت نفسه متحرك، غير ثابت، عائم بين الممكن والمستحيل، نرى فيه جولييت وهي تحاول استكشاف الحياة خارج حدود هذا العالم العائم، بينما يتشبث جان بسلطة البقاء داخله، رافضًا الاعتراف بأن الحبّ لا ينتمي إلى الثبات، بل إلى الحركة.
حيث إن البنية السردية للفيلم، التي تقوم على التوتر بين الرغبة في الاكتشاف والخوف من الفقدان، تستند إلى مفارقة جوهرية؛ الحب بحد ذاته فعل تيه، رحلة لا تكتمل إلا حين تُختبر المسافة، وحين يعاد اكتشاف الآخر من خلال الغياب، وهذا ما يحدث فعليًا حين تفارق جولييت القارب وتذهب إلى المدينة، تاركةً جان ليغرق في دوامة الحزن والضياع. فلا يصبح النهر في هذا السياق مجرد خلفية، بل كيانًا متحوّلًا يتفاعل مع التحولات النفسية للشخصيات. فجان، الذي يبدو في البداية القائد الممسك بدفة السفينة، يصبح لاحقًا غريبًا حتى عن نفسه، غارقًا في عزلته، مهووسًا بصورة جولييت التي لم يعد يراها سوى في الأحلام.
الوسيط باعتباره امتدادًا للهيام الأسطوري
لحظة الذروة البصرية في الفيلم تأتي عندما يغوص جان في النهر، وهناك، وسط العتمة المائية، يرى وجه جولييت يطفو أمامه. هذه الصورة ليست مجرد استعارة شاعرية، بل تعبير عن كيف تصبح السينما نفسها وسيطًا بين الحاضر والذكرى، والواقع والرغبة. وعند هذه اللحظة، يتحول الماء إلى شاشة داخل الشاشة، سطح يعكس ما لا يمكن إدراكه بالمنطق، لكنه يتراءى لنا بوصفه حقيقة بصرية خالصة. ما يقدمه فيغو هنا هو جوهر الأسطورة السينمائية؛ أي القدرة على تحويل ما هو حميمي إلى تجربة كونية، وعلى منح العواطف بعدًا ماديًا يتجسد في حركة الصورة وتلاعب الضوء والظل. الماء، الذي كان منذ البدء فضاءً للتيه، يتحوّل هنا إلى وسيط استعادي، يسمح لفيغو بخلق مشهدية تستدعي البعد الطقوسي للأسطورة. فإذا كان النهر في «ليلة الصائد» بوابة عبور، تنقل السائرين عليه من ضفة الخطر إلى ضفة الأمان، فإن النهر في «الأطلنطي» ليس مجالًا حركيًا بقدر ما هو بنية دلالية تحكم مصائر الشخصيات. فالماء هنا يصبح معبرًا نحو الإدراك ومجالًا رمزيًا لاختبار الوجود. فتجربة جان مع الغوص ليست فقط بحثًا عن جولييت، بل إعادة تشكّل لهويته عبر الغياب، وكأن الحب لا يدرك في حضوره، بل في افتقاده.
ولم يكن فيغو معنيًا فقط بالمشهدية البصرية، لكنه وظّف الصوت في «الأطلنطي» بطريقة تتجاوز دوره التقليدي في نقل الحوار أو تأكيد الانفعالات، فالموسيقى لا تعمل كعنصر درامي يعيد صياغة الزمن داخل الفيلم، وهي ليست تعبيرًا عن الحالة العاطفية فحسب، وإنما جزءًا من المعمار السردي الذي يجعل من الحب تجربة أقرب إلى الطقس، تتفاعل المشاعر مع المساحات الصوتية والبصرية لتخلق انطباعًا بأن الشخصيات محاصرة داخل إيقاع لا يمكنها الإفلات منه. وفي المشهد الذي يبدأ فيه جان بالهذيان بسبب غياب جولييت، نلاحظ كيف تصبح الأصوات مشوّشة، متداخلة، كأنها محاكاة للاضطراب الداخلي الذي يعيشه. وعندما تعود جولييت أخيرًا، تتلاشى الأصوات تدريجيًا، ليصبح كل شيء خاضعًا للهدوء، كأن العالم قد عاد إلى توازنه الطبيعي. هذه الدقة في توظيف الصوت تكشف عن مدى وعي فيغو بفكرة الأسطورة كإيقاع داخلي، كتجربة حسية متكاملة، وليس مجرد سرد حكائي فحسب.
تفكيك الأسطورة في «الرجل الذي أطلق النار على ليبرتي فالانس» لجون فورد
إذا كانت السينما وسيلة لإنتاج الأسطورة، فإن فيلم «الرجل الذي أطلق النار على ليبرتي فالانس» هو لحظة مواجهتها لذاتها، لحظة إدراكها أنها ليست فقط صانعةً للوهم، بل أيضًا ضحيته. فعلى السطح، يبدو فيلم جون فورد حكايةً عن الغرب الأمريكي، ساحةً للصراع بين الخير والشر، وبين القانون والفوضى، إلا أن لجوهره تأملًا عميقًا في كيفية صناعة الأسطورة، وفي متى ولماذا يجب أن تموت. كما لو أنها مسرح لتغيير تاريخي جذري، تُستبدل فيه أسطورة بأخرى، وتعاد كتابة الحقيقة وفقًا لحاجات النظام الجديد. في قلب الفيلم، هناك شخصيتان متناقضتان تمامًا: توم دونيفان (جون واين) ورانسون ستودارد (جيمس ستيوارت)، كلٌ منهما يُمثل نموذجًا مختلفًا للحكاية الأمريكية، الأول هو ابن العالم الفوضوي الذي يفرض النظام بالسلاح قبل أن يُكتب على الورق، والثاني هو ابن المؤسسات القادم من عالمٍ يؤمن بأن الكلمات تغني عن العنف، وأن النظام لا يُمكن أن يقوم على الأفراد، بل على القوانين المكتوبة.
لكن الحقيقة التي يكشفها فورد هي أن الأسطورة لا تُدفن هكذا بسهولة. عندما يقتل دونيفان ليبرتي فالانس، لكنه يسمح لستودارد بالحصول على الفضل، فإنه لا يقوم فقط بعمل بطولي، بل يعيد كتابة التاريخ نفسه، يقدم الرواية التي يحتاجها المجتمع الجديد لكي يبرر وجوده. وهكذا، يصبح ستودارد الوجه الجديد للسلطة، لكنه لا يستطيع الوجود إلا لأن الأسطورة القديمة، أسطورة دونيفان، اختارت أن تُمحى لصالحه. وهنا تكمن المفارقة الكبرى للفيلم: هل انتصرت الحضارة فعلًا؟ أم أن العالم الجديد لا يزال بحاجة إلى الأكاذيب المؤسسة، أو إلى الأساطير التي تضفي الشرعية على وجوده؟
السينما بين الموت والبعث الأسطوري
دائمًا ما كانت السينما وسيطًا لإعادة إحياء الماضي، لكنها لم تكن حيادية في ذلك، لأنها لم تُسجل فقط ما كان، بل أعادت تشكيله وفقًا لمنطقها الداخلي، ففي «الرجل الذي أطلق النار على ليبرتي فالانس» نرى كيف أن الأسطورة لا تموت فعليًا، بل تتحول إلى سرد جديد، إلى ذاكرة جماعية تعيد إنتاج نفسها وفقًا لمتطلبات الحاضر، فحين يقرر دونيفان إحراق منزله، فإنه لا يرتكب فعلًا شخصيًا، بل يؤدي طقسًا أسطوريًا، كأنه يدرك أن زمنه انتهى، وأنه لكي يولد النظام الجديد، يجب أن يُمحى الماضي، أي أن يصبح جزءًا من ذاكرة غير مكتوبة، مُضمَنة فقط في الحكايات التي سيرويها الآخرون لاحقًا. إنه لا يموت، بل يتحوّل إلى طيف، إلى رمز، إلى ظل سيظل يطارد المدينة الجديدة حتى وإن أنكرته.
وهنا يظهر جوهر الفكرة الميثولوجية التي يقدمها الفيلم؛ لا شيء يُمكن أن يولد إلا على أنقاض شيء آخر؛ فالأسطورة القديمة يجب أن تمحى لكي يعاد بناء التاريخ، لكنها لا تزول بالكامل، بل تصبح الأساس الذي يقوم عليه العالم الجديد، حتى وإن حاول هذا العالم الجديد أن ينكرها. إن السينما، في جوهرها، ليست وسيلة لرواية القصص، لكنها أداة لإعادة تشكيل الواقع، لإعادة كتابة التاريخ، لإعادة إنتاج الذاكرة الجمعية. إلا أنها وكما يكشف «الرجل الذي أطلق النار على ليبرتي فالانس» ليست دائمًا صانعة للأساطير، بل قد تكون أيضًا قاتلتها، تعيد النظر فيما صنعته، تسائل السرديات التي تبنتها، تكشف أن الحقيقة ليست سوى رواية انتصرت على غيرها.
وهكذا، تظل السينما أعظم أسطورة حديثة، لكنها على عكس الأساطير القديمة، تعرف أنها أسطورة، تعرف أن الوهم لا يمكن أن يكون حقيقيًّا، لكنها أيضًا تدرك أن الحقيقة - مهما كانت قاسية - لا تملك القوة ذاتها التي يملكها السرد. وكأنها تقول لنا، كما قال الصحفي في نهاية فيلم «الرجل الذي أطلق النار على ليبرتي فالانس»: «إذا كان هناك تعارض بين الحقيقة والأسطورة، فلتُطبع الأسطورة».