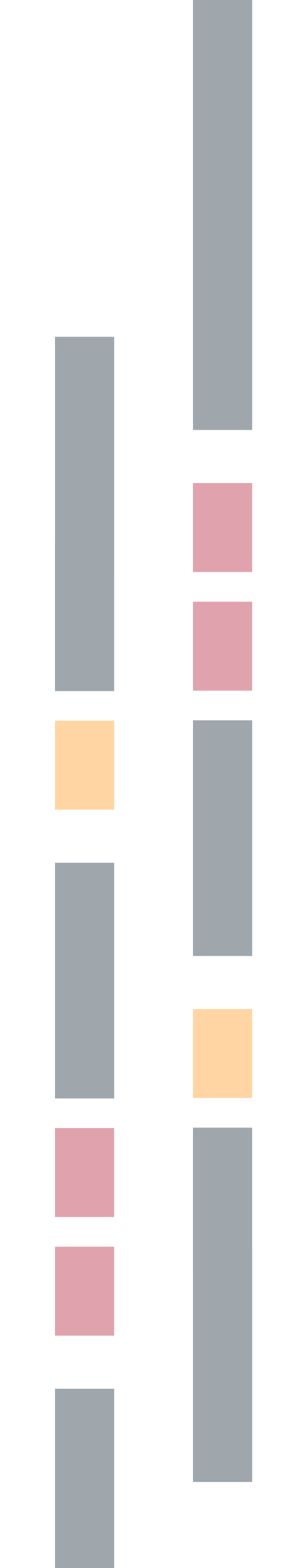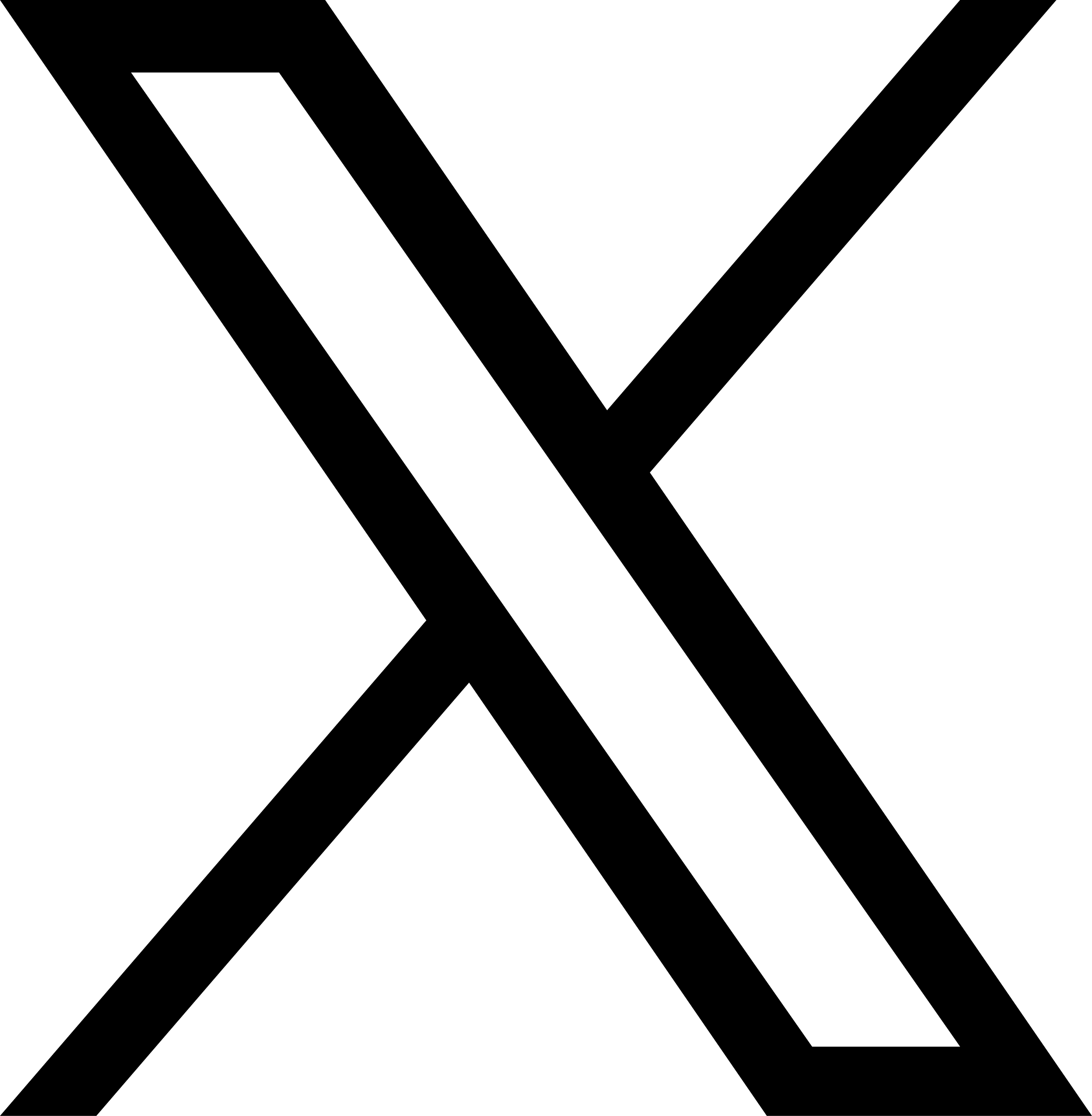شارك
لا يبدو على المخرج الفلسطيني ميشيل خليفي أنه مشغول بألقاب تُسبغ عليه في الصحافة النقدية، مِن مثل «الأب الشرعي للسينما الروائية الفلسطينية»، فهو في معظم أفلامه اشتغل على تهشيم المؤسسة البطريركية الأبوية التي أعاقت مفهومه للتحرر الذي سيسبق التحرير، ولهذا تبدو هنا أبوته مجرد تسطيح عابر لما سيأتي. إنه بمعنى أدق، مشغول بالتأسيس لذاكرة مستقبلية تستدعي الحداد على فلسطين الماضي. وانطلاقًا من هذا التوصيف دأب يتساءل في أفلامه عن الأسباب التي دفعت أهله وناسه للبقاء والتشبث بالأرض بدل الارتحال عنها في مختلف البقاع كما حصل لكثيرين.
إعادة تفكيك المأساة الفلسطينية من هذه البوابة تشكل هاجسًا وجوديًّا كبيرًا لدى خليفي، وهنا قد لا يختلف اثنان حول ذلك، بقدر اختلافهما حقيقة على نسب السينما الفلسطينية الجديدة إلى أبٍ، هي ليست بحاجة إليه على كل حال، وهو قد لا يريد بأي شكل من الأشكال تأكيد ذلك، ولكن أفلامه في معظمها تحمل دلالات على نأيه بنفسه عن أُبوَّةٍ لا يريدها في الواقع. وميشيل خليفي الذي هاجر مبكرًا إلى بلجيكا، وعاش ودرس ودرَّس في جامعاتها، عُرف عنه أنه كان شديد الحرص على أن تُعرَض أفلامه في العالم العربي، وهو لا يخفي ذلك، بالرغم من أنه في اللحظة التي أخرج فيها فيلمه الأول «الذاكرة الخصبة» 1980 كان يؤسس لقطيعة بمعنى من المعاني مع هذا العالم، ليس بمعنى الانقطاع عنه، بل بأخذ مبادرة صنع الأفلام الفلسطينية من صناعها الأوائل، وهي السينما التي كان يصنعها الآخرون. وهنا تكمن مفارقة في الوصف نفسه، إذ شكلت هذه القطيعة الفيلمية الناجزة استمرارية ثقافية من نوعٍ ما أيضًا، فأخذ المبادرة مسألة فهمها فيما بعد حين عرض الفيلم في مهرجان قرطاج، ونال فيه جائزة النقاد العرب، فيما اتصلت به إدارة مهرجان كان لتبلغه بحصول الفيلم نفسه على جائزة الكاميرا الذهبية، ومن ثم مُنحت لفيلم ألماني من وراء ظهره. بدا الأمر كما لو أن إحساسه السينمائي الرفيع يقوده إلى توكيد ما هو مؤكَّد، من كونه ابنًا لقضية عادلة، لم يكن يستطيع الدفاع عنها سينمائيًّا بخطاب مقنع أمام من يريدون الإيقاع به، باعتبار أن السينما تحمل خطابًا في نهاية المطاف، وهو قد سعى من هذه البوابة لأن يقدم التجربة الفلسطينية بكامل أبعادها الإنسانية.
ليس لدى ميشيل خليفي قدرة على الحكم على هذه التجربة، فلا أحد يمكنه أن يكون حَكَمًا على تجربته وعلى نفسه، أكثر من المتلقي الذي يقبع دائمًا في العتمة، ولكن التجارب الإنسانية منذ أفلامه «الذاكرة الخصبة» حتى «نشيد الحجر» مرورًا بـ «معلول تحتفل بدمارها» و«عرس الجليل» كانت محاولة للتأسيس لسينما فلسطينية بكل معنى الكلمة، انطلاقًا من المحلية نحو العالمية، والانفتاح الواسع على الإنسانية جمعاء.
ففيلم مثل «الذاكرة الخصبة» شكَّل بداية مُوفَّقة لبناء جسر فكري بين الماضي والحاضر والمستقبل مع الإيمان بأنه من دون التفريق بين الأزمنة، فإنه سيكون من المستحيل بناء زمن فلسطيني خالص؛ ذلك أن الخلط بين الأزمنة سوف يضع الجميع خارج الزمن، فالإنسان المعاصر هو الذي يعرف موقعه في الزمن الحاضر، ويمكنه أن يحدد علاقته مع مستويات الأزمنة التي تحيط به وتسكنه: الذكرى، والتأريخ، والذاكرة الذاتية، والذاكرة المقصوصة، وذاكرة العائلة، والذاكرة الجماعية... إلخ، ولكن يوجد هناك أيضًا الزمن الذهني الذي هو أساس حضور هذا الإنسان في الواجهات الثقافية والفكرية. وقد يغدو ميشيل خليفي هنا مُفكِّرًا سينمائيًّا من طراز خاص، دفعته أحلامه السينمائية لأن يرفض عرضَيْنِ أمريكيَّيْنِ له، حتى أنه لم يزُرْ لوس أنجلس للحديث عنهما مع الجهات التي دعته، لأن أحلامه تقيم في مكان آخر. تنويع الذاكرة في أفلام ميشيل خليفي مسألة في غاية الأهمية، فهو وعي منذ سنين طفولته الأولى في حواري مدينة الناصرة (مولود سنة 1950) بأن فلسطين التاريخية ليست واقعًا فحسب، بل ذاكرة، وفلسطين الأرض هي ليست فلسطين الذاكرة، وإنما فلسطين اليوم، ولو لم يكن الأمر كذلك لكان من المستحيل إنجاز فيلم «الذاكرة الخصبة»، الذاكرة التي تعمل على التحديق المستمر بالحاضر المقيم. هو يوضح رؤيته لفلسطين المستقبل من خلال ما يسميه القيام المشرّف بحداد على فلسطين الماضي.
في فيلمه الروائي الطويل «عرس الجليل» يقودنا ميشيل خليفي إلى محاولات بنيوية جريئة تعمل على تفكيك المجتمع الفلسطيني من الداخل على عدة مستويات، ولو دققنا النظر –مثلًا- في مشهد الحصان في حقل الألغام، فإننا نكاد نقع على ملخص لهذه العملية التفكيكية المحفوفة بالمخاطر، وهذا قد يدفع إلى التساؤل مجددًا، ما إذا كانت قضايا الصراع تتطور بالطريقة نفسها في تعبيرها عن الواقع المحيط بأبطال الفيلم قبل كل شيء. على أنه يجب ألا يُنتزَع المشهد من داخل صيرورة الفيلم، فثمة علاقة محددة بين نظامين ممثلين لشخصين غير متكافئين في قوتهما، هما الحاكم العسكري الإسرائيلي، ومختار العائلة الذي يمثل هنا السلطة البطريركية بامتياز. وهما سيشهدان من موقعيهما كل تفاصيل الحياة اليومية الصغيرة، ومنها بطبيعة الحال تعدد الشخصيات: الجدَّة، والجدُّ، وأخت العريس، وأخي العريس الصغير. رمز الحصان في حقل الألغام يحمل عدة مستويات: الأول: مستوى تاريخي نرى من خلاله كيف كان الإسرائيليون يضعون الألغام لكي يمنعوا الفلسطينيين من العمل في أراضيهم. والثاني: هو الاستعارة بحد ذاتها؛ فالواقع يقول إننا موجودون جميعًا، وبغض النظر عن هوياتنا في حقل ألغام جماعي. والسؤال هو من المسؤول عن وضع الحصان في هذا الحقل الخطر؟ ومن جهة أخرى فإن علاقة العسكري الإسرائيلي مع الطبيعة، بما في ذلك طبيعة الحصان، وطبيعة وجغرافية وتضاريس الأرض المحيطة به، وعلاقة المختار، العجوز الفلسطيني الذي يقيم علاقة (انسجامية) مع الحصان، رغمًا عن تشكك المحيط الفلسطيني به، وبنواياه، وعلاقته نفسها مع الأرض تتيح التدخلات الخارجية في الحياة الفلسطينية بتمظهراتها أو بتجلياتها البسيطة (الاستعداد لحفل الزفاف مثلًا، وما يدور فيه من خفايا).
يبدو ميشيل خليفي اليوم لمن يتابعه عن كثب أنه قد اختصر مسيرته السينمائية بفيلمه الأخير «زنديق» (2009)، فهو يحمل أشياء كثيرة من سيرته الذاتية كسينمائي مفكر، وهذا ما قد يميزه –سينمائيًّا- عن أقرانه الفلسطينيين. إنه المخرج ميم (لعب دوره في الفيلم محمد البكري)، الذي يعود بأحلامه السينمائية إلى المهد الأول، فيجد أن الناس الطيبين قد ناموا جميعهم في مدينة الناصرة، مدينة الأشباح في الليل، واستيقظ الأشرار منهم فقط. حقًّا لماذا يستيقظ الشر في الليل، تعاونه على ذلك كل الأشباح التي تنتمي إلى عوالم شيطانية، ويمكنها أن تدفع بالإنسان إلى التعب؟ هل تعب ميشيل خليفي من السينما فأراد أن يلخصها بفيلم أخير، ويقف عند هذا الحد؟ لا توجد إجابة في الواقع، لكن السؤال عنه من بعد عقد ونصف العقد على عودة «ميم» إلى مدينة الناصرة يبدو مشروعًا، أو هو علامة استفهام كبرى في حقل ألغام سينمائي قد ينفجر بالجميع في وقت ما.
الصحيح أن ميشيل خليفي يبدو لمن يراقبه من بعيد بالرغم من ابتسامته وضحكه يائسًا، وبحاجة إلى أن يعتزل عالمه الذي صنعه على مدى أكثر من أربعة عقود. لقد شغل نفسه بتدريس السينما في معاهد بلجيكية. السؤال أيضًا متى يتحوَّل المخرج السينمائي إلى معلم في أكاديمية قد يبدو مشروعًا من وجهة نظر خطرة، فالذي يدفع به إلى ذلك، هو التفاوت في المصائر الذي يحدث بين جميع الناس. لهذا قد يجد البعض في اليأس محاولة للإفلات من الأحكام المسبقة التي تواجه فيه أعماله حين تُعرض على الناس، أو أمام الناس. فلا أحد يهتم بالبحث عن تشابكات وتعقيدات العمل الذي يشاهده، وهنا قد يحدث اليأس، فليس هناك تواصل حقيقي وجدي، بل مجرد عزلة تامة، وهذا ما قد يحصل للمخرج «ميم» في الفيلم، وفي الواقع الذي يقع أمامنا في كل ثانية منه!