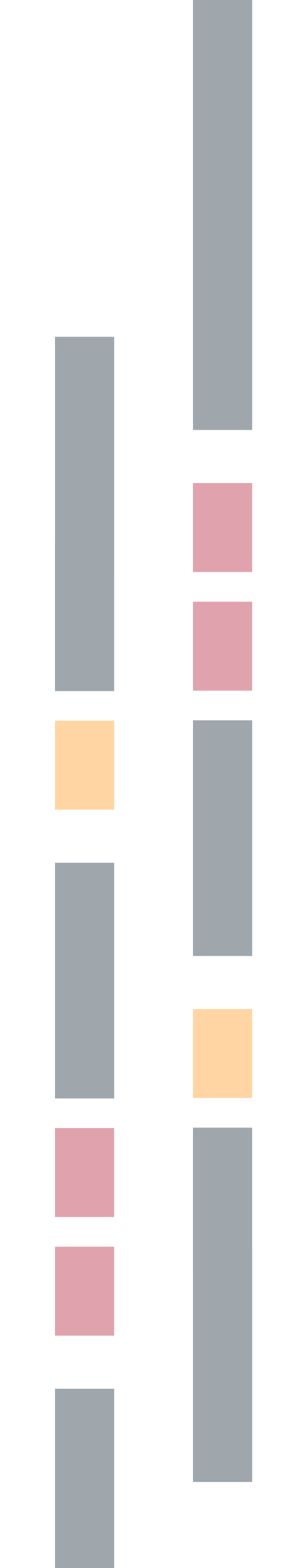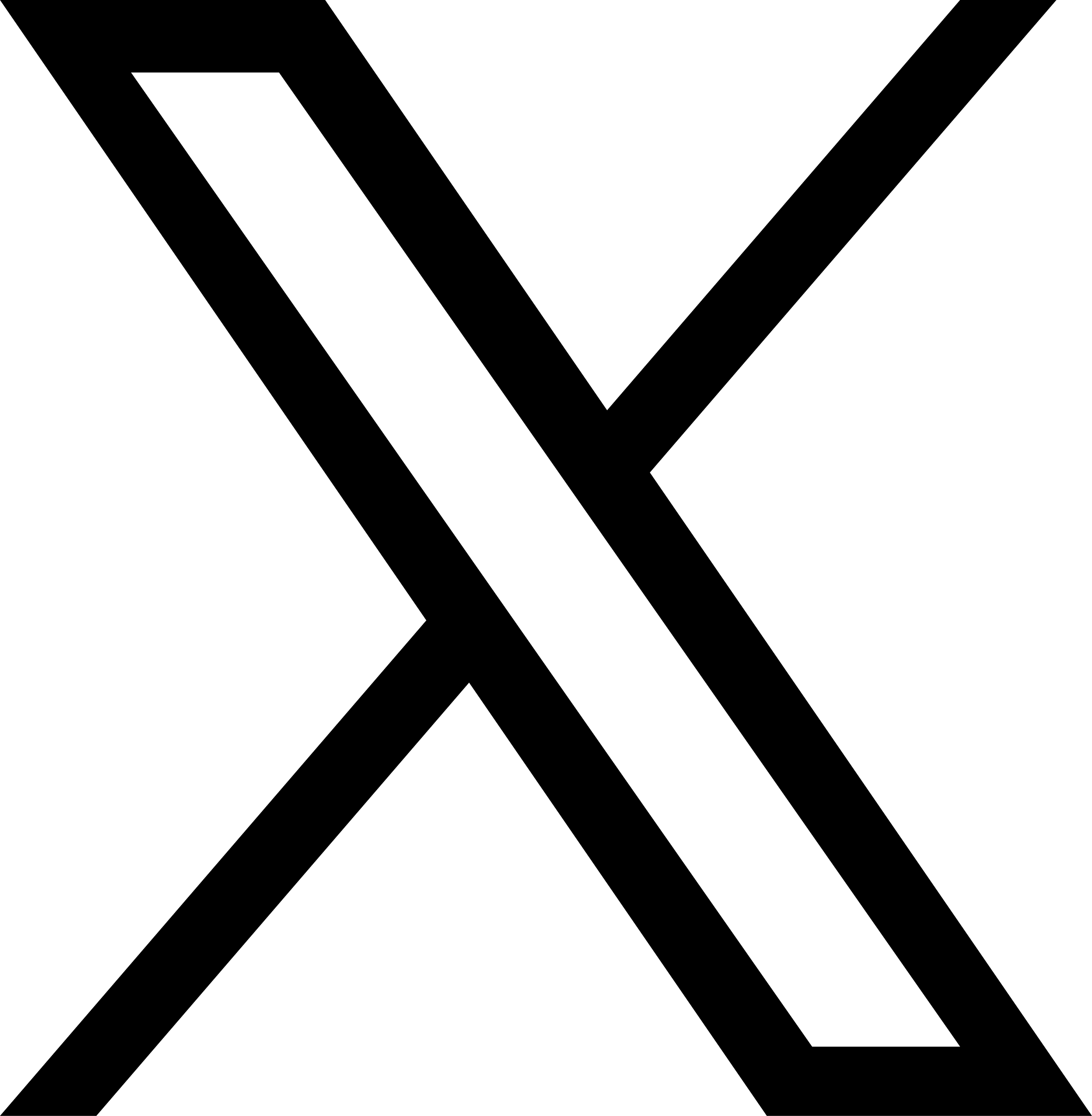شارك
إنِ استثْنيْنا فيلميه الهوليوديَّيْن: «الساعي» 2012 و«الجبل بيننا» 2017، فإنَّ المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد لن يخسر شيئًا من سباق المسافات الفيلمي الطويل جدًّا، فلسطينيًّا، وهو سيشكل مع مجموعة من المخرجين الفلسطينيين الآخرين أمثال إيليا سليمان، ميشيل خليفي، ميّ المصري، وآن ماري جاسر، وشيرين دعيبس، وآخرين سواهم، طلائع الموجة الجديدة في هذه السينما الطموحة التي اهتدت –أخيرًا- إلى صوتها وصورتها، بعد أن ظلَّت لعقود في متناول سينمائيين آخرين، وهذه ليست مثلبة بالطبع، ولكن كان سيظل المشهد ناقصًا، وغير مكتمل أبدًا من دون أن يملأه أهله بأفلامهم (الجسورة).
إذن، يواصل أبو أسعد طريقه السينمائي المحفوف بالمخاطر أيضًا بعد أن اهتدى إلى هوليوود منتجًا ومخرجًا، وهو إنْ سبق له وقدَّم فيلمه «عمر» بميزانية متواضعة من 1.5 مليون دولار قام هو نفسه بجمعها من أثرياء فلسطينيين -كما سبق له وصرح بذلك- فإنَّ هوليوود الآن تُفسح له المجال لأن يقدم أفلامًا بميزانيات فضفاضة، مع ممثلين محترفين، مثل كايت وينسلت، وإدريس ألبا، وجيفري دين مورغان، وميكي رورك وسواهم أيضًا، يمكنه من خلالها أن يفكر كمخرج فقط، ليقدم من ثم رؤية صافية.
ربما تصلح السيناريوهات التي صار يفكر فيها من الآن فصاعدًا لسينما «مبسترة» لم يعد الشغل الشاغل فيها البحث وضرورة التأويل، وتوكيد حوافز النقد، على غرار ما فعله بأفلامه (الفلسطينية)، وإن لم يتوقف عنها، فهو قد قدَّم فيلمه المثير للجدل «صالون هدى» قبل عامين، ولكن شلالات هوليوود –بالقرب منه - كانت قوية، وكثيفة، ومغرية، يمكنها أن تخطف الأضواء والمواهب بسهولة لا توصف.
الأجدى من هذا التقديم بالطبع البحث عن مسببات كل هذا النقاش الذي أثاره من حول هذه الأفلام، فيما لن تثير أفلامه «الأمريكية» أيًّا من هذا الجدل، على الأقل بيننا نحن، وإن استطاع أن يُعبّر فيها بحرية أكبر عن مشاغله (الإنسانية) الجديدة، لكنه سيفتقد من خلالها، إلى عسف النقد والتجني، ومحاولات تبديد خياراته بالاختيار، وهي تنتمي حقًّا إلى مكونات المخرج الجديد حين تلوح في الأفق كل أعاصير التحدي، فمنها يولد الفيلم المثالي، وليست الميزانيات المريحة بالتأكيد هي سبب بلوغ الفيلم منتهاه. ربما تظل أفلام الواقعية الايطالية الجديدة التي صنعت بميزانيات منخفضة ماثلة على الدوام في الذاكرة الإنسانية، وهي التي أنجزها مخرجوها بعين محدقة ومفتوحة على مشكلات عصرهم، مع الاحتفاظ بمسافة أمان من الرؤية الصافية التي تدفع بالفيلم وصاحبه إلى الخلود.
ما فعله هاني أبو أسعد في أفلامه «الفلسطينية» بالرغم من أن بعضها كان مفتوحًا على رسائل ملتبسة، يمكن تفسيرها في أكثر من اتجاه، ولكنها على الأقل تحمل القدرة على أن تثير المتلقي من حولها، سلبًا أو إيجابًا، ليس هذا المهم، بقدر ما أنها كانت تحرّك شيئًا في مستنقعات راكدة، بعضها آسن، وبعضها مطيّن، وبعضها لا يبشر بالخير، ولكنها أفلام طالعة من قلب المجتمع الفلسطيني بكامل مكوناته، وطبائعه، ومشكلاته التي لا تُعَّد ولا تُحصى، وهذا ما سيُسجَّل له لاحقًا، فيما ستظل العين الهوليودية مرتاحة في محجر غريب، قد يفضله البعض باردًا أو ساخنًا في أثناء طقس المشاهدة الذي ليس بالضرورة أن يكون مريعًا، أو حتى بين بين.
حتى بعض أفلامه «الفلسطينية» التي صُوِّرت على عجل في غفلة عن الزمن السينمائي مثل «ياطير الطاير» 2015 الذي يحكي سيرة حياة مغني أراب آيدول محمد عساف، ونشأته في حواري مخيمات غزة، وبحثه عن موهبته في أمكنة أخرى، مع انفجار الوفرة الفضائية الكبرى، سوف تظل في ملامساتها الملتبسة تشير إلى خلل ما في أمكنة عدة، وربما يمكن من خلالها إصلاح بعض ما تقدَّم منها في أمثلة أخرى.
ليس فيلمه «الجنَّة الآن» 2005 إلا مثالٌ ناصع وحيّ على قدرة هاني أبو أسعد في توريط المُشاهِد معه في مشاهدة فيلم حيوي وملّح وضروري إلى هذه الدرجة، حين يقترب من حدّ السكين القاطع، فيناقش مع أبطاله قضية خطيرة ومؤرقة مثل العمليات الانتحارية التي يقوم بها فلسطينيون بين الفينة والأخرى. أخطر ما في هذا النقاش أنه يمتد ويتغلغل في النفوس، وليس في الشوارع والأحياء التي استهدفها الانتحاريون، وهنا تكمن قوة أبو أسعد في الواقع. هذا يقود أيضًا إلى حوار مقابل مع فيلمه «عمر» 2013 الأكثر نضجًا وقدرةً على تصوير واقع فلسطيني معجون بالأسى والألم، وليس أمامه سوى الدوران في مكانه. ولكن الفيلم لا يستسلم لهذه الحقيقة الدرامية المؤلمة بدورها، وإنما يفتح آفاقًا غير منتهية أمام بطله (لعب دوره بجدارة آدم البكري)؛ إذ كيف يمكن لكل هذا الظلم حين يقع على رأس فرد واحد، فيُتَهم بالعمالة، وهو أصلًا كان يخطط ليكون عاشقًا من الطراز الأول. أليست عملية تسلقه الجدار العنصري العازل يوميًّا من أجل أن يذهب للقاء محبوبته ناديا (لعبت دورها ليم لوباني)، والتعرض للضرب والإهانة بأيدي وأسلحة عناصر الدوريات الإسرائيلية، ثم انتكاسته، وعدم قدرته على تسلقه في الخواتيم إلا بمساعدة عجوز أعزل إلا من عكازه، صورة فائقة القوة في التعبير، ورسم تلك الصورة التي لا يمكن إلا أن تكون مصممة خصيصًا من أجل أن تكون مثيرة للجدل في كل مكان وزمان، حين تنهض فيهما أسوار وجدران داخل النفوس، وقبل أن تكون مهيأة للشوارع التي ستفصل بين شعبين، وتمهد لكارثتين، أو قل كارثة واحدة غير منتهية، أو لا يراد لها أن تنتهي؟!
حتى فيلم «صالون هدى» 2021 الذي حمل بذكاء فكرة استغلال العدو للناس الضعفاء، حين ينتهك خصوصياتهم بأقل قدر من الخسائر حين لا تكلفه شيئًا. ليس أمامه سوى تشييد صالون مخترق وفتحه على عنف مستور وكامن في النفوس الضعيفة، ولكنها قابلة لأن تكون في مرمى كل ذلك النقد والتشهير الأعمى، وليس أمامها سوى الانشطار والتفتت حين لا يكون هناك إمكانية لكشف كل هذا التعري حين يصيب الإنسان في مقتل.
في كلمات أخيرة، يمكن التفلّت منها نقديًّا حتى لو لم نرد كل ذلك، فلن يمكن لهاني أبو أسعد أن يراوغ ممثلة مجربة في هوليوود من مثل كايت وينسلت. بالتأكيد لن يمكنه ذلك، فعدا عن تجربتها وخبرتها، فثمة قوانين صارمة تمنع من ذلك، لكن في الواقع الذي نكون فيه أحياء، يمكننا أن نراوغ من نشاء، صديقًا أو عدوًّا أو حتى شخصًا محايدًا، ما دمنا نملك بشيء من الدهاء والبصيرة القدرةَ على تقليب المواجع ذاتها أكثر من مرة. ربما تتعدَّى مائة مرة، ودائمًا في المكان نفسه!